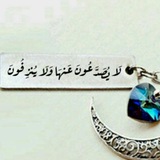Forwarded from 📚 المدرسة العلمية 📚
اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ،
اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا، ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮا،
ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ ،
اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ،
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺻﺪﻕ ﻭﻋﺪﻩ، ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ، ﻭﻫﺰﻡ اﻷﺣﺰاﺏ ﻭﺣﺪﻩ،
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ.
تقبل الله منا ومنكم صالح الٲعمال
وجعلنا وٳياكم من الفائزين الرابحين الغانمين المغفورين المعتقين 🌹
اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا، ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮا،
ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ ،
اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ،
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺻﺪﻕ ﻭﻋﺪﻩ، ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ، ﻭﻫﺰﻡ اﻷﺣﺰاﺏ ﻭﺣﺪﻩ،
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ.
تقبل الله منا ومنكم صالح الٲعمال
وجعلنا وٳياكم من الفائزين الرابحين الغانمين المغفورين المعتقين 🌹
*ما حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم جمعة؟*
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.
وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.
وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 539]: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".
وجاء في [البناية شرح الهداية 3/ 97]:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".
وقد ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.
جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".
ولكن المسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.
فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم.
✍ *دائرة الإفتاء العام الأردنية*
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.
وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.
وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 539]: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".
وجاء في [البناية شرح الهداية 3/ 97]:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".
وقد ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.
جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".
ولكن المسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.
فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم.
✍ *دائرة الإفتاء العام الأردنية*
كيف أجعل يوم العيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
- نعم..
* ليلة العيد: اشتغل بتهنئة أحبابك والناس.
* ولا تنس نصيبك من إحياء ليلة العيد بالعبادة..
وفي ليلة العيد عبادة؟
- في كل ليلة عبادة..
وتخصيص ليلة العيد بها مستحب.
والناس فيها درجات:
فمن صلى العشاء والفجر في جماعة حصل أقل المطلوب
ومن تعبد معظمها ظفر بالمرغوب.
وذلك بقيام وذكر وقرآن ودعاء
وسعي في توزيع الصدقات
وسائر أعمال الصالحات
.
* واحرص على غسل العيد ويبدأ وقته من منتصف الليل.
وتطيَّب وتزيَّن.
* وبكِّر في الحضور إلى الصلاة
التبكير - لغير الإمام - سنة.
* واذهب ماشيًا وعد ماشيًا ما استطعت
وخالف في طريقك
اذهب من طريق طويل..
وارجع من طريق قصير..
* تناول شيئًا قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر..
والأفضل: التمر.
وما الحكمة في هذا؟
- أن يتميز يوم العيد عما قبله بالمبادرة إلى الأكل.
.
* واحرص على صدقة، وتبسم، وتهنئة، وسلام،
* اجهر بالتكبير..
في ليلتك ويومك
وفي طريقك
وفي مشيك
وقعودك
كل وقت
ومتي يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟
- يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بالدخول في صلاة العيد
والجهر إنما هو للرجال في كل موضع
وللنساء منفردات أو مع النساء أو مع محارمهن من الرجال..
.
وما صيغة التكبير؟
- لا تلزم صيغة معينة للتكبير
فجميع صيغ التكبير حسنة كافية
وما ورد عن السلف الصالح في هذا يدل على أن الأمر في هذا واسع.
.
واختار الشافعية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
.
والله أعلم.
.
#كبسولات_فقهية
#الصلاة
#العيد
.
- نعم..
* ليلة العيد: اشتغل بتهنئة أحبابك والناس.
* ولا تنس نصيبك من إحياء ليلة العيد بالعبادة..
وفي ليلة العيد عبادة؟
- في كل ليلة عبادة..
وتخصيص ليلة العيد بها مستحب.
والناس فيها درجات:
فمن صلى العشاء والفجر في جماعة حصل أقل المطلوب
ومن تعبد معظمها ظفر بالمرغوب.
وذلك بقيام وذكر وقرآن ودعاء
وسعي في توزيع الصدقات
وسائر أعمال الصالحات
.
* واحرص على غسل العيد ويبدأ وقته من منتصف الليل.
وتطيَّب وتزيَّن.
* وبكِّر في الحضور إلى الصلاة
التبكير - لغير الإمام - سنة.
* واذهب ماشيًا وعد ماشيًا ما استطعت
وخالف في طريقك
اذهب من طريق طويل..
وارجع من طريق قصير..
* تناول شيئًا قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر..
والأفضل: التمر.
وما الحكمة في هذا؟
- أن يتميز يوم العيد عما قبله بالمبادرة إلى الأكل.
.
* واحرص على صدقة، وتبسم، وتهنئة، وسلام،
* اجهر بالتكبير..
في ليلتك ويومك
وفي طريقك
وفي مشيك
وقعودك
كل وقت
ومتي يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟
- يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بالدخول في صلاة العيد
والجهر إنما هو للرجال في كل موضع
وللنساء منفردات أو مع النساء أو مع محارمهن من الرجال..
.
وما صيغة التكبير؟
- لا تلزم صيغة معينة للتكبير
فجميع صيغ التكبير حسنة كافية
وما ورد عن السلف الصالح في هذا يدل على أن الأمر في هذا واسع.
.
واختار الشافعية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
.
والله أعلم.
.
#كبسولات_فقهية
#الصلاة
#العيد
.
#ابن_مالك
رحمه الله ورضي عنه
صاحب الألفية في النحو..
اشتهر بإمامته في هذا الفن، وجُعِلَ له القبول فيه
لكن العجيب أنه كان إمامًا في القراءت عالمًا بها، حتى أنه ألف فيها منظومتين على غرار الشاطبية، إحداهما دالية قال فيها:
ولا بدّ من نظمي قوافي تحتوي ... لما قد حوى حرز الأماني وأَزْيَدَا
والأخرى لامية قال في أولها:
بذكر إلهي حامدًا ومبسملًا ... بدأت فأولى القول يبدأ أولا
وقال في آخرها:
وزادت على حرز الأماني إفادةً ... وقد نقصت في الجِرْمِ ثلثا مكمَّلا
قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله:
وقد أخذ عنه العربية غير واحد من الأئمة، غير أني لا أعلم أحدا قرأ عليه القراءات ولا أسندها عنه، بل حدثنا بكثير من مؤلفاته جماعة من أصحابه، وحدثني بعض شيوخنا أنه كان يجلس في وظيفته مشيخة الإقراء بشباك التربة العادلية وينتظر من يحضر يأخذ عنه، فإذا لم يجد أحدا يقوم إلى الشباك ويقول: القراءات القراءات.. العربية العربية، ثم يدعو ويذهب ويقول: أنا لا أرى أن ذمتي تبرأ إلا بهذا، فإنه قد لا يعلم أني جالس في هذا المكان لذلك!
غاية النهاية في طبقات القراء (2/18)
وقد أفادنا وصوب لنا الشيخ الحبيب الجليل سامي معوض بقوله:
قوله في الكافية:
وعمدتي قراءة ابن عامر .. إلخ
هو لا يقصد أنه كان يقرأ بقراءة ابن عامر، وإنما يعني أن هذه المسألة النحوية التي جنح فيها إلى مذهب الكوفيين من جواز الفصل بين المضافين بمفعول المضاف = يعضّدها ويقوّيها قراءة ابن عامر، يعني قوله تعالى: " وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم ".
وقوله " وكم لها من عاضد وناصر" يعني من شعر العرب وكلام الفصحاء
رحمه الله ورضي عنه
صاحب الألفية في النحو..
اشتهر بإمامته في هذا الفن، وجُعِلَ له القبول فيه
لكن العجيب أنه كان إمامًا في القراءت عالمًا بها، حتى أنه ألف فيها منظومتين على غرار الشاطبية، إحداهما دالية قال فيها:
ولا بدّ من نظمي قوافي تحتوي ... لما قد حوى حرز الأماني وأَزْيَدَا
والأخرى لامية قال في أولها:
بذكر إلهي حامدًا ومبسملًا ... بدأت فأولى القول يبدأ أولا
وقال في آخرها:
وزادت على حرز الأماني إفادةً ... وقد نقصت في الجِرْمِ ثلثا مكمَّلا
قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله:
وقد أخذ عنه العربية غير واحد من الأئمة، غير أني لا أعلم أحدا قرأ عليه القراءات ولا أسندها عنه، بل حدثنا بكثير من مؤلفاته جماعة من أصحابه، وحدثني بعض شيوخنا أنه كان يجلس في وظيفته مشيخة الإقراء بشباك التربة العادلية وينتظر من يحضر يأخذ عنه، فإذا لم يجد أحدا يقوم إلى الشباك ويقول: القراءات القراءات.. العربية العربية، ثم يدعو ويذهب ويقول: أنا لا أرى أن ذمتي تبرأ إلا بهذا، فإنه قد لا يعلم أني جالس في هذا المكان لذلك!
غاية النهاية في طبقات القراء (2/18)
وقد أفادنا وصوب لنا الشيخ الحبيب الجليل سامي معوض بقوله:
قوله في الكافية:
وعمدتي قراءة ابن عامر .. إلخ
هو لا يقصد أنه كان يقرأ بقراءة ابن عامر، وإنما يعني أن هذه المسألة النحوية التي جنح فيها إلى مذهب الكوفيين من جواز الفصل بين المضافين بمفعول المضاف = يعضّدها ويقوّيها قراءة ابن عامر، يعني قوله تعالى: " وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم ".
وقوله " وكم لها من عاضد وناصر" يعني من شعر العرب وكلام الفصحاء
Forwarded from وقف تفسير القرآن وعلومه
#الدرس_الخمسون_من_دروس_علوم_القرآن ⬇️⬇️⬇️
#ضوابط_الوقف_والابتداء ⤵️⤵️⤵️
بوت تواصل وردود 👇
@alwosapei_bot
https://www.tg-me.com/waqafllla
مجموعة القناة
https://www.tg-me.com/Monaqashat
#ضوابط_الوقف_والابتداء ⤵️⤵️⤵️
بوت تواصل وردود 👇
@alwosapei_bot
https://www.tg-me.com/waqafllla
مجموعة القناة
https://www.tg-me.com/Monaqashat
Telegram
مجمع الفوائد
قال رسول الله ﷺ: " اﻏﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺒﺎ، ﻭﻻ ﺗﻜﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﺘﻬﻠﻚ». والخامسة: ﺃﻥ ﺗﺒﻐﺾ اﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻠﻪ. رواه الطبراني والبزار ورجاله موثقون.
قناة المجموعة ⇓
مجمع الفوائد
https://www.tg-me.com/majemafawaeed
بوت للتواصل
@alwosapei_bot
قناة المجموعة ⇓
مجمع الفوائد
https://www.tg-me.com/majemafawaeed
بوت للتواصل
@alwosapei_bot
Forwarded from السلسلة الأربعونية
الأربعون الروضية
https://www.tg-me.com/alwosapy1443/2
الأربعون المباركة
https://www.tg-me.com/alwosapy1443/54
الأربعون الرحابية
https://www.tg-me.com/alwosapy1443/148
قناة السلسلة الأربعونية
https://www.tg-me.com/alwosapy1443
https://www.tg-me.com/alwosapy1443/2
الأربعون المباركة
https://www.tg-me.com/alwosapy1443/54
الأربعون الرحابية
https://www.tg-me.com/alwosapy1443/148
قناة السلسلة الأربعونية
https://www.tg-me.com/alwosapy1443
Telegram
السلسلة الأربعونية
روض النجم في بيان الأشهر الحرم
نبذة
الكاتب / حمدي بن محمد بن مقبل بن محمد العباسي الوصابي ـ من وصاب ذمار اليمن.
درست القرآن ثم حفظته وقد بلغت من العمر الخامسة عشر، وقد تخرجت من قسم القرآن وعلومه في كلية التربية زبيد الحديدة اليمن، ودرست ـ دراية ـ في زبيد…
نبذة
الكاتب / حمدي بن محمد بن مقبل بن محمد العباسي الوصابي ـ من وصاب ذمار اليمن.
درست القرآن ثم حفظته وقد بلغت من العمر الخامسة عشر، وقد تخرجت من قسم القرآن وعلومه في كلية التربية زبيد الحديدة اليمن، ودرست ـ دراية ـ في زبيد…
🌹إحْذر الدُّعَاءَ عَلى ولَدِكْ
۞ عنْ جَابِر بنِ عبدِاللهِ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لا تَدْعُوا على أنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا على أوْلادِكُمْ، ولا تَدْعُوا على أمْوَالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ ساعَةً يُسْئَلَُ فيها عَطاءٌ فَيسْجيبَ لكُمْ ».
📚 رواه مسلم (٧٦٢٣).
🌹دُعَاءُ الوَالِدِ على وَلَدِهِ مُسْتَجابٌ
عنْ أبي هُرَيرةَ رضَيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
ثلاث دعوات مستجابات لاشكَّ فيهن: دعْوَةُ المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده .
📚صحَّحه الالباني في الصحيحة (٥٩).
🌹دُعَاءُ الوالدِينِ يَسْتَأْصِلُ المَالَ والوَلَدَ
✍️ قاَلَ الإمام الحَسَنُ البِصريُّ رحمه الله تعالى :
دعاء الوالدين يستأصل المال والولد .
وقيل له: مادعاء الوالدين للولد؟
قاَلَ: نَجاةٌ، قيل: فعليه؟ قاَلَ: إستئصالٌ .
📚رواه ابنُ الجوزي في"البروالصلة "(١٦١)
🌹 دُعَاءُ أُمٍّ
✍️ عنْ محمد بن الفضل البلخي، قاَلَ :
ذَهَبتْ عَيْنَا مُحمد بن إسماعيل البخاري في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل - عليه السلام - فقال لها:
ياهذه !! قدْ ردَّ اللهُ على ابنكِ بصره، لِكثْرةِ دعائك ،
فأصبحنا وقد ردَّ اللهُ بصره .
📚رواه اللالكائي في"كرامات الاولياء (٢٢٩).
🌹 مَـهْمَا أَخْطَأَ الوَلدُ فالدعاء لهُ سَببٌ في صلاحِهِ
✍️ قاَلَ الإمام أحمد بنُ حنبل رحمه الله تعالى :
فأمَّا ابنُ عون فكان إذا غضب على أحد منْ أهْله قاَلَ: بارك الله فيك، فقال لإبنٍ لهُ يوماً: بارك الله فيك،
فقال: أنا بارك الله فيَّ؟ قال: نعم،
فقال بعض من حضر: ما قال لك إلاَّ خيرا، قال: ما قال لي هذا حتى اجهد- يعني اشتدَّ غضبه .
📚رواه ابنُ عساكر في تاريخه (٣٥٢/٣١).
۞ عنْ جَابِر بنِ عبدِاللهِ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لا تَدْعُوا على أنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا على أوْلادِكُمْ، ولا تَدْعُوا على أمْوَالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ ساعَةً يُسْئَلَُ فيها عَطاءٌ فَيسْجيبَ لكُمْ ».
📚 رواه مسلم (٧٦٢٣).
🌹دُعَاءُ الوَالِدِ على وَلَدِهِ مُسْتَجابٌ
عنْ أبي هُرَيرةَ رضَيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
ثلاث دعوات مستجابات لاشكَّ فيهن: دعْوَةُ المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده .
📚صحَّحه الالباني في الصحيحة (٥٩).
🌹دُعَاءُ الوالدِينِ يَسْتَأْصِلُ المَالَ والوَلَدَ
✍️ قاَلَ الإمام الحَسَنُ البِصريُّ رحمه الله تعالى :
دعاء الوالدين يستأصل المال والولد .
وقيل له: مادعاء الوالدين للولد؟
قاَلَ: نَجاةٌ، قيل: فعليه؟ قاَلَ: إستئصالٌ .
📚رواه ابنُ الجوزي في"البروالصلة "(١٦١)
🌹 دُعَاءُ أُمٍّ
✍️ عنْ محمد بن الفضل البلخي، قاَلَ :
ذَهَبتْ عَيْنَا مُحمد بن إسماعيل البخاري في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل - عليه السلام - فقال لها:
ياهذه !! قدْ ردَّ اللهُ على ابنكِ بصره، لِكثْرةِ دعائك ،
فأصبحنا وقد ردَّ اللهُ بصره .
📚رواه اللالكائي في"كرامات الاولياء (٢٢٩).
🌹 مَـهْمَا أَخْطَأَ الوَلدُ فالدعاء لهُ سَببٌ في صلاحِهِ
✍️ قاَلَ الإمام أحمد بنُ حنبل رحمه الله تعالى :
فأمَّا ابنُ عون فكان إذا غضب على أحد منْ أهْله قاَلَ: بارك الله فيك، فقال لإبنٍ لهُ يوماً: بارك الله فيك،
فقال: أنا بارك الله فيَّ؟ قال: نعم،
فقال بعض من حضر: ما قال لك إلاَّ خيرا، قال: ما قال لي هذا حتى اجهد- يعني اشتدَّ غضبه .
📚رواه ابنُ عساكر في تاريخه (٣٥٢/٣١).
" ليعلم أنّ إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كلِّ سائلٍ عليه.
بل يسأله عبدُه الحاجةَ فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه.
ويكون منعُه منها لكرامته عليه ومحبّته له، فيمنعه حمايةً وصيانةً وحفظًا لا بخلًا. وهذا إنّما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبّته، ويعامله بلطفه، فيظنُّ بجهله أنّ ربَّه لا يجيبه ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنَّه بربِّه. وهذا حَشْوُ قلبه ولا يشعر به، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرةٌ. وعلامةُ هذا حملُه على الأقدار وعتابُه الباطن لها، كما قيل:
وعاجزُ الرّأي مِضياعٌ لفرصتـه
حتّى إذا فات أمرٌ عاتبَ القدَرا
فوالله لو كُشِف عن حاصله وسرِّه لرأى هناك معاتبة القدر واتِّهامه، وأنّه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي، والأمر ليس إليّ؟ والعاقلُ خصمُ نفسه، والجاهلُ خصمُ أقدار ربِّه.
فاحذر كلَّ الحذر أن تسأل شيئًا معيّنًا خيرتُه وعاقبتُه مغيّبةٌ عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدًّا، فعلِّقه على شرط علمِه تعالى فيه الخيرةَ، وقدِّم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارةً باللِّسان بلا معرفةٍ، بل استخارةَ من لا علمَ له بمصالحه، ولا قدرةَ له عليها، ولا اهتداءَ له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا؛ بل إن وُكِل إلى نفسه هلَك كلَّ الهلاك، وانفرط عليه أمرُه.
وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤالٍ فسَلْه أن يجعله عونًا على طاعته، وبلاغًا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعًا لك عنه، ولا مبعدًا عن مرضاته.
ولا تظنُّ أنّ عطاءه كلَّ ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعَه كلَّ ما يمنعه لهوان عبده عليه. ولكن عطاؤه ومنعُه ابتلاءٌ وامتحانٌ يمتحن بهما عباده. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا ﴾ [الفجر: ١٥ - ١٧] ".
ابن القيم | مدارج السالكين (١/ ١٢٢-١٢٤)
بل يسأله عبدُه الحاجةَ فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه.
ويكون منعُه منها لكرامته عليه ومحبّته له، فيمنعه حمايةً وصيانةً وحفظًا لا بخلًا. وهذا إنّما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبّته، ويعامله بلطفه، فيظنُّ بجهله أنّ ربَّه لا يجيبه ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنَّه بربِّه. وهذا حَشْوُ قلبه ولا يشعر به، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرةٌ. وعلامةُ هذا حملُه على الأقدار وعتابُه الباطن لها، كما قيل:
وعاجزُ الرّأي مِضياعٌ لفرصتـه
حتّى إذا فات أمرٌ عاتبَ القدَرا
فوالله لو كُشِف عن حاصله وسرِّه لرأى هناك معاتبة القدر واتِّهامه، وأنّه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي، والأمر ليس إليّ؟ والعاقلُ خصمُ نفسه، والجاهلُ خصمُ أقدار ربِّه.
فاحذر كلَّ الحذر أن تسأل شيئًا معيّنًا خيرتُه وعاقبتُه مغيّبةٌ عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدًّا، فعلِّقه على شرط علمِه تعالى فيه الخيرةَ، وقدِّم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارةً باللِّسان بلا معرفةٍ، بل استخارةَ من لا علمَ له بمصالحه، ولا قدرةَ له عليها، ولا اهتداءَ له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا؛ بل إن وُكِل إلى نفسه هلَك كلَّ الهلاك، وانفرط عليه أمرُه.
وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤالٍ فسَلْه أن يجعله عونًا على طاعته، وبلاغًا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعًا لك عنه، ولا مبعدًا عن مرضاته.
ولا تظنُّ أنّ عطاءه كلَّ ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعَه كلَّ ما يمنعه لهوان عبده عليه. ولكن عطاؤه ومنعُه ابتلاءٌ وامتحانٌ يمتحن بهما عباده. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا ﴾ [الفجر: ١٥ - ١٧] ".
ابن القيم | مدارج السالكين (١/ ١٢٢-١٢٤)
Forwarded from 📚 منهاج المسلم 📚
💎 #الدرر_البهية_في_المسائل_الفقهية ⤵️
📗 الدرس الـ 2⃣5⃣1⃣ القضاء
🌿 #المتن => يقول الإمام محمد علي الشوكاني رحمه الله في كتابه
📚 الدُّرَرُ البَهِيَّةُ فِي المَسَائِلِ الفِقهِيَّةِ 📚 :
{ الكتاب الخامس والثلاثون: ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺤﺪﻭﺩ
اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ : ﺑﺎﺏ ﺣﺪ اﻟﺰاﻧﻲ:
..... ﻭﻻ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺤﺒﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺿﻊ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺠﻠﺪ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﺮﺽ ﺑﻌﺜﻜﺎﻝ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻣﻦ ﻻﻁ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﺘﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﺮا، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭا، ﻭﻳﻌﺰﺭ ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﻭﻳﺠﻠﺪ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻧﺼﻒ ﺟﻠﺪ اﻟﺤﺮ، ﻭﻳﺤﺪﻩ ﺳﻴﺪﻩ ﺃﻭ اﻹﻣﺎﻡ.}
↩️ #الشرح => يقول الراجي من ربه الرحمة حمدي محمد العباسي :
=> وقوله: (الزنى) تقدم ذكره في الدرس السابق.
وصل الكلام بنا ٳلى رجم الحامل: فلا ترجم حتى تضع حملها وترضعه إذا لم ترضعه غيرها لما ثبت عند مسلم من حديث الغامدية وفيه قال لها ﷺ: "ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻌﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻚ"، ﻗﺎﻝ: ﻓﻜﻔﻠﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ. ﻓﻘﺎﻝ: "ﺇﺫا ﻻ ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻭﻧﺪﻉ وﻟﺪﻫﺎ ﺻﻐﻴﺮا ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ" ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻟﻲ ﺭﺿﺎﻋﻪ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ. ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﺟﻤﻬﺎ.
والمرض يخفف الحد ولا يسقطه، وكيفية التخفيف كما عند ابن ماجه ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻴﺎﺗﻨﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﺨﺪﺝ ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻉ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺎء اﻟﺪاﺭ ﻳﺨﺒﺚ ﺑﻬﺎ، ﻓﺮﻓﻊ ﺷﺄﻧﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: "اﺟﻠﺪﻭﻩ ﺿﺮﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮﻁ" ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ، ﻫﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻮ ﺿﺮﺑﻨﺎﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮﻁ ﻣﺎﺕ. ﻗﺎﻝ: "ﻓﺨﺬﻭا ﻟﻪ ﻋﺜﻜﺎﻻ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﻤﺮاﺥ، ﻓﺎﺿﺮﺑﻮﻩ ﺿﺮﺑﺔ ﻭاﺣﺪﺓ".
فائدة.tt
إذا كان المرض مرجو برؤه أُخر الحد حتى يصح لما ثبت عند مسلم من حديث علي أنه خطب فقال: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻗﻴﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﺋﻜﻢ اﻟﺤﺪ. ﻣﻦ ﺃﺣﺼﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻦ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺯﻧﺖ ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺟﻠﺪﻫﺎ ﻓﺈﺫا ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﻨﻔﺎﺱ، ﻓﺨﺸﻴﺖ ﺇﻥ ﺟﻠﺪﺗﻬﺎ، ﺃﻥ ﺃﻗﺘﻠﻬﺎ، ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: "ﺃﺣﺴﻨﺖ".
وأما اللواط: وهو جماع الرجل الرجل فجرمه أكبر من الزنا، وقوم لوط الذين فعلوا هذه الفاحشة عذبهم الله فقال في القرآن: {فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد} وثبت في السنن ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: "ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ". وثبت عنه قوله ﷺ:(لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط).
ويدخل تحت اللواط: إتيان الرجل لغير زوجته وجاريته في الدبر، وأما إتيان الرجل زوجته وجاريته في الدبر فهو حرام ولكن لا حد عليه، وقد جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال عنها: (هي اللويطة الصغرى) يعني جماع الزوجة أو الجارية في خلفها.
وأما جماع البهيمة: وهو جماع الرجل للبهيمة أو المرأة تجعل البهيمة تجامعها فهو من المحرمات كذلك، واختلف العلماء في حده: فمنهم من يرى حكمه كحكم اللواط وهو القتل لما صح عنه ﷺ قوله: " ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ". رواه أحمد عن ابن عباس. وهذا مذهب الشافعية. ومنهم من يرى أن حده التعزير لما ثبت عند الترمذي وغيره ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺣﺪ. وأما البهيمة فتقتل ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ. وهذا مذهب الشافعي.
وأما الجارية ـ ولا يوجد جواري في عصرنا هذا فقد انتهت وسيعود هذا الأمر في آخر الزمان ـ فحكمها كما قال الله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وفي الصحيحين ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺇﺫا ﺯﻧﺖ ﺃﻣﺔ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺯﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺠﻠﺪﻫﺎ اﻟﺤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺜﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺯﻧﺖ، ﻓﻠﻴﺠﻠﺪﻫﺎ اﻟﺤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺜﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺯﻧﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺯﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺒﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺒﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ".
وأما السحاق ـ ولم يذكره المصنف هنا ـ فهو ٳتيان المرٲة للمرٲة يعني: إلتقاء الفرج بالفرج وتحريكهما ملتصقين. وهذا محرم كذلك. قال العلماء وحده الحبس كما جاء في قوله تعالى: {واللاتي يٲتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ٲربعة منكم فٳن شهدوا فٲمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ٲو يجعل الله لهن سبيلا}. فهذا مختصر القول في هذه المسائل.
فائدة.tt
في اللواط وٳيتان البهيمة والسحاق يستوي الحكم في الذكر والٲنثى والمتزوج وغير المتزوج، واللواط بين الذكور، والسحاق بين الٳناث، والعبيد حدهم نصف الحر ذكورا كانوا ٲم إناثا.
هذا ما تيسر ذكره والله الموفق.
https://www.tg-me.com/menhaja
مجموعة القناة
https://www.tg-me.com/Monaqashat
📗 الدرس الـ 2⃣5⃣1⃣ القضاء
🌿 #المتن => يقول الإمام محمد علي الشوكاني رحمه الله في كتابه
📚 الدُّرَرُ البَهِيَّةُ فِي المَسَائِلِ الفِقهِيَّةِ 📚 :
{ الكتاب الخامس والثلاثون: ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺤﺪﻭﺩ
اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ : ﺑﺎﺏ ﺣﺪ اﻟﺰاﻧﻲ:
..... ﻭﻻ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺤﺒﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺿﻊ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺠﻠﺪ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﺮﺽ ﺑﻌﺜﻜﺎﻝ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻣﻦ ﻻﻁ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﺘﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﺮا، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭا، ﻭﻳﻌﺰﺭ ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﺑﻬﻴﻤﺔ، ﻭﻳﺠﻠﺪ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻧﺼﻒ ﺟﻠﺪ اﻟﺤﺮ، ﻭﻳﺤﺪﻩ ﺳﻴﺪﻩ ﺃﻭ اﻹﻣﺎﻡ.}
↩️ #الشرح => يقول الراجي من ربه الرحمة حمدي محمد العباسي :
=> وقوله: (الزنى) تقدم ذكره في الدرس السابق.
وصل الكلام بنا ٳلى رجم الحامل: فلا ترجم حتى تضع حملها وترضعه إذا لم ترضعه غيرها لما ثبت عند مسلم من حديث الغامدية وفيه قال لها ﷺ: "ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻌﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻚ"، ﻗﺎﻝ: ﻓﻜﻔﻠﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ. ﻓﻘﺎﻝ: "ﺇﺫا ﻻ ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻭﻧﺪﻉ وﻟﺪﻫﺎ ﺻﻐﻴﺮا ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ" ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻟﻲ ﺭﺿﺎﻋﻪ ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ. ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﺟﻤﻬﺎ.
والمرض يخفف الحد ولا يسقطه، وكيفية التخفيف كما عند ابن ماجه ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻴﺎﺗﻨﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﺨﺪﺝ ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻉ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺎء اﻟﺪاﺭ ﻳﺨﺒﺚ ﺑﻬﺎ، ﻓﺮﻓﻊ ﺷﺄﻧﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: "اﺟﻠﺪﻭﻩ ﺿﺮﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮﻁ" ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ، ﻫﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻮ ﺿﺮﺑﻨﺎﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮﻁ ﻣﺎﺕ. ﻗﺎﻝ: "ﻓﺨﺬﻭا ﻟﻪ ﻋﺜﻜﺎﻻ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﻤﺮاﺥ، ﻓﺎﺿﺮﺑﻮﻩ ﺿﺮﺑﺔ ﻭاﺣﺪﺓ".
فائدة.tt
إذا كان المرض مرجو برؤه أُخر الحد حتى يصح لما ثبت عند مسلم من حديث علي أنه خطب فقال: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻗﻴﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﺋﻜﻢ اﻟﺤﺪ. ﻣﻦ ﺃﺣﺼﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻦ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺯﻧﺖ ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺟﻠﺪﻫﺎ ﻓﺈﺫا ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﻨﻔﺎﺱ، ﻓﺨﺸﻴﺖ ﺇﻥ ﺟﻠﺪﺗﻬﺎ، ﺃﻥ ﺃﻗﺘﻠﻬﺎ، ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: "ﺃﺣﺴﻨﺖ".
وأما اللواط: وهو جماع الرجل الرجل فجرمه أكبر من الزنا، وقوم لوط الذين فعلوا هذه الفاحشة عذبهم الله فقال في القرآن: {فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد} وثبت في السنن ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: "ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ". وثبت عنه قوله ﷺ:(لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط).
ويدخل تحت اللواط: إتيان الرجل لغير زوجته وجاريته في الدبر، وأما إتيان الرجل زوجته وجاريته في الدبر فهو حرام ولكن لا حد عليه، وقد جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال عنها: (هي اللويطة الصغرى) يعني جماع الزوجة أو الجارية في خلفها.
وأما جماع البهيمة: وهو جماع الرجل للبهيمة أو المرأة تجعل البهيمة تجامعها فهو من المحرمات كذلك، واختلف العلماء في حده: فمنهم من يرى حكمه كحكم اللواط وهو القتل لما صح عنه ﷺ قوله: " ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭاﻗﺘﻠﻮا اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ". رواه أحمد عن ابن عباس. وهذا مذهب الشافعية. ومنهم من يرى أن حده التعزير لما ثبت عند الترمذي وغيره ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺣﺪ. وأما البهيمة فتقتل ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ. وهذا مذهب الشافعي.
وأما الجارية ـ ولا يوجد جواري في عصرنا هذا فقد انتهت وسيعود هذا الأمر في آخر الزمان ـ فحكمها كما قال الله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وفي الصحيحين ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺇﺫا ﺯﻧﺖ ﺃﻣﺔ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺯﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺠﻠﺪﻫﺎ اﻟﺤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺜﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺯﻧﺖ، ﻓﻠﻴﺠﻠﺪﻫﺎ اﻟﺤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺜﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺯﻧﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺯﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺒﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺒﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ".
وأما السحاق ـ ولم يذكره المصنف هنا ـ فهو ٳتيان المرٲة للمرٲة يعني: إلتقاء الفرج بالفرج وتحريكهما ملتصقين. وهذا محرم كذلك. قال العلماء وحده الحبس كما جاء في قوله تعالى: {واللاتي يٲتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ٲربعة منكم فٳن شهدوا فٲمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ٲو يجعل الله لهن سبيلا}. فهذا مختصر القول في هذه المسائل.
فائدة.tt
في اللواط وٳيتان البهيمة والسحاق يستوي الحكم في الذكر والٲنثى والمتزوج وغير المتزوج، واللواط بين الذكور، والسحاق بين الٳناث، والعبيد حدهم نصف الحر ذكورا كانوا ٲم إناثا.
هذا ما تيسر ذكره والله الموفق.
https://www.tg-me.com/menhaja
مجموعة القناة
https://www.tg-me.com/Monaqashat
Telegram
📚 منهاج المسلم 📚
هذه القناة تهتم بشأن المسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق.
مجموعة القناة
https://www.tg-me.com/Monaqashat
من لديه سؤال أو غيره يراسلنا من البوت
@alwosapei_bot
مجموعة القناة
https://www.tg-me.com/Monaqashat
من لديه سؤال أو غيره يراسلنا من البوت
@alwosapei_bot
Forwarded from قناة حمدي العباسي
#مناجاة
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻭﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭاﺭﺽ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ: ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻲ، ﻭﻋﻦ اﻵﻝ ﻭاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ.
اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎﺩﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎﺩﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎﺩﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺎﺗﻚ ﻳﺎ ﺫا اﻟﺠﻼﻝ ﻭاﻹﻛﺮاﻡ ﺗﻐﻨﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﺳﻮاﻙ، ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﻮاﻟﻬﻢ، ﻭﺗﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺷﻌﺜﻬﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻡ ﻭﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻡ ﻭﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪاﻥ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ اﺭﺣﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻬﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﻳﺎ ﻏﻔﻮﺭ ﻳﺎ ﺭﺣﻴﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻘﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ، اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻘﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻼﺡ ﻭاﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻮﺯ ﻭاﻟﻨﺠﺎﺡ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ ﻭﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ ﻭﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻮاﻧﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﻏﺎﻧﻤﻴﻦ ﺗﺎﺋﺒﻴﻦ ﺁﻳﺒﻴﻦ ﻳﺎ ﺫا اﻟﺠﻼﻝ ﻭاﻹﻛﺮاﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﻬﺪﻱ اﻟﻘﺮﺁﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﻬﺪﻱ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﺴﻨﺔ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺪﻧﺎﻥ - ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ -.
اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ اﻟﻐﻨﻲ ﻭﻧﺤﻦ اﻟﻔﻘﺮاء، ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻘﻨﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻘﻨﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻘﻨﺎ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ.
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻭﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭاﺭﺽ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ: ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻲ، ﻭﻋﻦ اﻵﻝ ﻭاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ.
اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎﺩﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎﺩﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻌﺒﺎﺩﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺎﺗﻚ ﻳﺎ ﺫا اﻟﺠﻼﻝ ﻭاﻹﻛﺮاﻡ ﺗﻐﻨﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﺳﻮاﻙ، ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﻮاﻟﻬﻢ، ﻭﺗﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺷﻌﺜﻬﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻡ ﻭﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻡ ﻭﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪاﻥ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ اﺭﺣﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻬﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﻳﺎ ﻏﻔﻮﺭ ﻳﺎ ﺭﺣﻴﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻘﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ، اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻘﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻼﺡ ﻭاﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻮﺯ ﻭاﻟﻨﺠﺎﺡ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ ﻭﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻒ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ ﻭﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻮاﻧﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﻏﺎﻧﻤﻴﻦ ﺗﺎﺋﺒﻴﻦ ﺁﻳﺒﻴﻦ ﻳﺎ ﺫا اﻟﺠﻼﻝ ﻭاﻹﻛﺮاﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﻬﺪﻱ اﻟﻘﺮﺁﻥ، اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﻬﺪﻱ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﺴﻨﺔ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺪﻧﺎﻥ - ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ -.
اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ اﻟﻐﻨﻲ ﻭﻧﺤﻦ اﻟﻔﻘﺮاء، ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ، اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻘﻨﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻘﻨﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﺳﻘﻨﺎ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ.
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
عمل يسير جدا أجره #دخول_الجنة
================
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ :
(1) يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُ عَشْرًا ، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ .
(2) وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ .
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ؟ قَالَ : يَأْتِي أَحَدَكُمْ - يَعْنِي : الشَّيْطَانَ - فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ) .
------------
صححه الحافظ ابن حجر فى " تخريج الأذكار " (2 / 267) ، وصححه الألباني في " الكلم الطيب " (113) .
================
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ :
(1) يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُ عَشْرًا ، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ .
(2) وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ .
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ؟ قَالَ : يَأْتِي أَحَدَكُمْ - يَعْنِي : الشَّيْطَانَ - فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ) .
------------
صححه الحافظ ابن حجر فى " تخريج الأذكار " (2 / 267) ، وصححه الألباني في " الكلم الطيب " (113) .
هذه الصورة بها حقائق طيبة
أول ما وقعت عيني عليها قلت: هذه الصورة تجمع بين:
● يوسف استس (الأمريكي)
● وذاكر نايك (الهندي)
● وأبي إسحاق الحويني (المصري).
تقول أشياء عندما يقرؤها شخص كما قرأتها أنا الآن.
وربما يقرؤها شخص هكذا:
● يوسف استس (الرجل الذي كان قسًّا فصار داعية)
● وأبو إسحاق وذاكر (اللذان ولدا مسلمين).
وربما يقرؤها ثالث على النحو التالي:
● رجل يدعو المسلمين
● ورجلان يدعوان غير المسلمين.
وربما يقرؤها رابع كما يلي:
● رجل أبيض
● ورجل أسود
● ورجل أحمر
جمع الإسلام بينهم.
وربما يقرؤها خامس على النحو التالي:
● رجل (إفريقي).
● وثان (آسيوي).
● وثالث (أمريكي)
وصلتهم صيحة محمد ﷺ التي نادى بها من أرض مكة.
ويقرؤها سادس:
● لسان عربي.
● ولسان إنجليزي.
● ولسان هندي
والكل يسبح الله ويحمده بلغته، ويبلغ رسالة الإسلام إلى العالم على منهج خاتم الأنبياء ﷺ.
وسابع يقرؤها:
ثلاثة غرباء عن المكان، من أماكن شتى، جمعهم القدر بأرض لم يولدوا بها:
● واحد اختيارًا.
● واثنان رغمًا من غير اختيار.
ولم يثنهم ذلك عن الاستمرار في تبليغ كلمة الله تعالى.
وثامن وتاسع وعاشر.
وهذا كله من جمال الإسلام وحقائقه العظيمة.
.
أول ما وقعت عيني عليها قلت: هذه الصورة تجمع بين:
● يوسف استس (الأمريكي)
● وذاكر نايك (الهندي)
● وأبي إسحاق الحويني (المصري).
تقول أشياء عندما يقرؤها شخص كما قرأتها أنا الآن.
وربما يقرؤها شخص هكذا:
● يوسف استس (الرجل الذي كان قسًّا فصار داعية)
● وأبو إسحاق وذاكر (اللذان ولدا مسلمين).
وربما يقرؤها ثالث على النحو التالي:
● رجل يدعو المسلمين
● ورجلان يدعوان غير المسلمين.
وربما يقرؤها رابع كما يلي:
● رجل أبيض
● ورجل أسود
● ورجل أحمر
جمع الإسلام بينهم.
وربما يقرؤها خامس على النحو التالي:
● رجل (إفريقي).
● وثان (آسيوي).
● وثالث (أمريكي)
وصلتهم صيحة محمد ﷺ التي نادى بها من أرض مكة.
ويقرؤها سادس:
● لسان عربي.
● ولسان إنجليزي.
● ولسان هندي
والكل يسبح الله ويحمده بلغته، ويبلغ رسالة الإسلام إلى العالم على منهج خاتم الأنبياء ﷺ.
وسابع يقرؤها:
ثلاثة غرباء عن المكان، من أماكن شتى، جمعهم القدر بأرض لم يولدوا بها:
● واحد اختيارًا.
● واثنان رغمًا من غير اختيار.
ولم يثنهم ذلك عن الاستمرار في تبليغ كلمة الله تعالى.
وثامن وتاسع وعاشر.
وهذا كله من جمال الإسلام وحقائقه العظيمة.
.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻘﻮ ﻓﻰ ﺭﺿﺎﻙ ﺿﻌﻔﻰ، ﻭﺧﺬ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻰ، ﻭاﺟﻌﻞ اﻹﺳﻼﻡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺭﺿﺎي، ﻭﺑﻠﻐﻨﻰ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ اﻟﺬﻯ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺘﻚ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻋﺎﻓﻴﺘﻚ، ﻭﺻﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻴﺘﻚ، ﻭﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺘﻚ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻭﺳﻴﺌﺎﺕ اﻷﺣﻼﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ اﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﺰﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭاﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺋﻚ، ﻭﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻚ، ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﺑﻘﻀﺎﺋﻚ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﻗﻠﺒﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻭﻟﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎﺩﻗﺎ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ، ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ، ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺭﺣﻤﺘﻚ، ﻭﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ، ﻭاﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺮ، ﻭاﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺇﺛﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺑﺮﺩ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻟﺬﺓ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﻚ، ﻭاﻟﺸﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻚ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮاء ﻣﻀﺮﺓ، ﻭﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻀﻠﺔ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ اﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻟﻌﻔﺔ ﻭاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﻉ ﻟﻰ ﺫﻧﺒﺎ ﺇﻻ ﻏﻔﺮﺗﻪ، ﻭﻻ ﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﻓﺮﺟﺘﻪ، ﻭﻻ ﺩﻳﻨﺎ ﺇﻻ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ ﺇﻻ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻋﺎﻓﻴﺘﻚ، ﻭﺻﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻴﺘﻚ، ﻭﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺘﻚ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻭﺳﻴﺌﺎﺕ اﻷﺣﻼﻡ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ اﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﺰﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭاﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺋﻚ، ﻭﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻚ، ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﺑﻘﻀﺎﺋﻚ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﻗﻠﺒﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻭﻟﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎﺩﻗﺎ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ، ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ، ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺭﺣﻤﺘﻚ، ﻭﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ، ﻭاﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺮ، ﻭاﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺇﺛﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺑﺮﺩ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻟﺬﺓ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﻚ، ﻭاﻟﺸﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻚ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮاء ﻣﻀﺮﺓ، ﻭﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻀﻠﺔ.
اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻰ ﺃﺳﺄﻟﻚ اﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻟﻌﻔﺔ ﻭاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ.
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﻉ ﻟﻰ ﺫﻧﺒﺎ ﺇﻻ ﻏﻔﺮﺗﻪ، ﻭﻻ ﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﻓﺮﺟﺘﻪ، ﻭﻻ ﺩﻳﻨﺎ ﺇﻻ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ ﺇﻻ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ.
Forwarded from قناة حمدي العباسي
ما ينفع الميت بعد موته؟
فمن ذلك ما ورد في الدعاء والاستغفار. قال الله:(ربنا اغفر لنا ولٳخواننا الذين سبقونا بالٳيمان) ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: " ﺇﻥ اﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻟﻴﺮﻓﻊ اﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻧﻰ ﻟﻲ ﻫﺬﻩ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻟﺪﻙ ﻟﻚ ". رواه ٲحمد وغيره. وﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺇﺫا ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ اﺳﺘﻐﻔﺮﻭا ﻷﺧﻴﻜﻢ ﻭاﺳﺄﻟﻮا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ اﻵﻥ ﻳﺴﺄﻝ. ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ وهو صحيح.
والصدقة بٲنواعها ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ: ﺇﻥ ﺃﺑﻲ ﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺹ، ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﺪﻕ ﻋﻨﻪ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻧﻌﻢ ". ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ رضي الله عنه ﺃﻥ ﺳﻌﺪا ﺃﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺹ ﺃﻓﻴﻨﻔﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻧﻌﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء». ﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
واﻟﺼﻮﻡ وخاصة النذر منه: ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﻡ ﺷﻬﺮ ﺃﻓﺄﻗﻀﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻚ ﺩﻳﻦ ﺃﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ "؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ. ﻗﺎﻝ: " ﻓﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻰ ".
واﻟﺤﺞ: ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﺃﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺟﺎءﺕ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﻧﺬﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺗﺖ ﺃﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﺣﺠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻚ ﺩﻳﻦ، ﺃﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﺘﻪ؟ اﻗﻀﻮا ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ".
واﻟﺼﻼﺓ: ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺃﺑﻮاﻥ ﺃﺑﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻲ ﺑﺒﺮﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﷺ: " ﺇﻥ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﻠﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﻼﺗﻚ، ﻭﺃﻥ ﺗﺼﻮﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻣﻚ ".
وكذا صلة رحمهم وبر صديقهم كما ثبت في حديث الساعدي : يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام : الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
وكذلك النذر ٲي نوع كان من الطاعة: ﻋﻦ ﻣﺮﻭاﻥ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ: «ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﺑﻲ ﺗﻮﻓﻲ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮ ﺑﺪﻧﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺸﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: " ﻧﻌﻢ، اﻗﺾ ﻋﻨﻪ، ﻭاﻧﺤﺮ ﻋﻨﻪ ﻭاﻣﺶ ﻋﻨﻪ. ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻚ ﺩﻳﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻀﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻟﻴﺲ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺭاﺿﻴﺎ؟ ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﺮﺿﻰ» ". ﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ.
وكذا ﻗﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻭﻫﺬا ﺭﺃﻱ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ.
وكذلك قضاء الدين: ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: «ﺗﻮﻓﻲ ﺭﺟﻞ، ﻓﻐﺴﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻛﻔﻨﺎﻩ، ﻭﺣﻨﻄﻨﺎﻩ، ﺛﻢ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﺨﻄﺎ ﺧﻄﻮﺓ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ؟ "، ﻗﻠﺖ: ﺩﻳﻨﺎﺭاﻥ، ﻓﺎﻧﺼﺮﻑ، ﻓﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻓﺄﺗﻴﻨﺎﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ: اﻟﺪﻳﻨﺎﺭاﻥ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: " ﻗﺪ ﺃﻭﻓﻰ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻳﻢ، ﻭﺑﺮﺉ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺖ "، ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻮﻡ: " ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭاﻥ؟ "، ﻗﻠﺖ: ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ اﻷﻣﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: " اﻵﻥ ﺑﺮﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺪﺗﻪ». ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺰاﺭ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ.
⌘ وكذا ما ورد في هذه الٲحاديث: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ الله ﷺ:( ﺳﺒﻊ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﺮﻯ ﻧﻬﺮا ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﺃﻭ ﻏﺮﺱ ﻧﺨﻼ ﺃﻭ ﺑﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪا ﺃﻭ ﻭﺭﺙ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻭﻟﺪا ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ). رواه البزار وٲبو نعيم وغيرهما بسند حسن.
وبسند حسن عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ:( ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﻭﻭﻟﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺑﻴﺘﺎ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﻧﻬﺮا ﺃﺟﺮاﻩ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ).
وﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ:" ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺣﻴﺎء ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻷﻣﻮاﺕ: ﺭﺟﻞ ﺗﺮﻙ ﻋﻘﺒﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ , ﻓﻴﺪﻋﻮ ﻓﻴﺒﻠﻐﻪ ﺩﻋﺎﺅﻫﻢ , ﻭﺭﺟﻞ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ , ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ , ﻭﺭﺟﻞ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ , ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﺊ، ﻭﺭﺟﻞ ﻣﺮاﺑﻂ ﻳﻨﻤﻰ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺤﺴﺎﺏ ". رواه الطبراني في الكبير. رحم الله موتى المسلمين. والله ٲعلم.
فمن ذلك ما ورد في الدعاء والاستغفار. قال الله:(ربنا اغفر لنا ولٳخواننا الذين سبقونا بالٳيمان) ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: " ﺇﻥ اﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻟﻴﺮﻓﻊ اﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻧﻰ ﻟﻲ ﻫﺬﻩ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻟﺪﻙ ﻟﻚ ". رواه ٲحمد وغيره. وﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺇﺫا ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ اﺳﺘﻐﻔﺮﻭا ﻷﺧﻴﻜﻢ ﻭاﺳﺄﻟﻮا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ اﻵﻥ ﻳﺴﺄﻝ. ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ وهو صحيح.
والصدقة بٲنواعها ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ: ﺇﻥ ﺃﺑﻲ ﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺹ، ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﺪﻕ ﻋﻨﻪ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻧﻌﻢ ". ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ رضي الله عنه ﺃﻥ ﺳﻌﺪا ﺃﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺹ ﺃﻓﻴﻨﻔﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻧﻌﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء». ﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
واﻟﺼﻮﻡ وخاصة النذر منه: ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﻡ ﺷﻬﺮ ﺃﻓﺄﻗﻀﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻚ ﺩﻳﻦ ﺃﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ "؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ. ﻗﺎﻝ: " ﻓﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻰ ".
واﻟﺤﺞ: ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﺃﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺟﺎءﺕ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﻧﺬﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺗﺖ ﺃﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: " ﺣﺠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻚ ﺩﻳﻦ، ﺃﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﺘﻪ؟ اﻗﻀﻮا ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ".
واﻟﺼﻼﺓ: ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺃﺑﻮاﻥ ﺃﺑﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻲ ﺑﺒﺮﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﷺ: " ﺇﻥ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﻠﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﻼﺗﻚ، ﻭﺃﻥ ﺗﺼﻮﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻣﻚ ".
وكذا صلة رحمهم وبر صديقهم كما ثبت في حديث الساعدي : يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام : الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
وكذلك النذر ٲي نوع كان من الطاعة: ﻋﻦ ﻣﺮﻭاﻥ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ: «ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﺑﻲ ﺗﻮﻓﻲ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮ ﺑﺪﻧﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺸﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: " ﻧﻌﻢ، اﻗﺾ ﻋﻨﻪ، ﻭاﻧﺤﺮ ﻋﻨﻪ ﻭاﻣﺶ ﻋﻨﻪ. ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻚ ﺩﻳﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻀﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻟﻴﺲ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺭاﺿﻴﺎ؟ ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﺮﺿﻰ» ". ﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ.
وكذا ﻗﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻭﻫﺬا ﺭﺃﻱ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ.
وكذلك قضاء الدين: ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: «ﺗﻮﻓﻲ ﺭﺟﻞ، ﻓﻐﺴﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻛﻔﻨﺎﻩ، ﻭﺣﻨﻄﻨﺎﻩ، ﺛﻢ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﺨﻄﺎ ﺧﻄﻮﺓ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ؟ "، ﻗﻠﺖ: ﺩﻳﻨﺎﺭاﻥ، ﻓﺎﻧﺼﺮﻑ، ﻓﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻓﺄﺗﻴﻨﺎﻩ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ: اﻟﺪﻳﻨﺎﺭاﻥ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: " ﻗﺪ ﺃﻭﻓﻰ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻳﻢ، ﻭﺑﺮﺉ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺖ "، ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻮﻡ: " ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭاﻥ؟ "، ﻗﻠﺖ: ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ اﻷﻣﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ: " اﻵﻥ ﺑﺮﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺪﺗﻪ». ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭاﻟﺒﺰاﺭ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ.
⌘ وكذا ما ورد في هذه الٲحاديث: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ الله ﷺ:( ﺳﺒﻊ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﺮﻯ ﻧﻬﺮا ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﺃﻭ ﻏﺮﺱ ﻧﺨﻼ ﺃﻭ ﺑﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪا ﺃﻭ ﻭﺭﺙ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻭﻟﺪا ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ). رواه البزار وٲبو نعيم وغيرهما بسند حسن.
وبسند حسن عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ:( ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﻭﻭﻟﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺑﻴﺘﺎ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﻧﻬﺮا ﺃﺟﺮاﻩ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ).
وﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ:" ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺣﻴﺎء ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻷﻣﻮاﺕ: ﺭﺟﻞ ﺗﺮﻙ ﻋﻘﺒﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ , ﻓﻴﺪﻋﻮ ﻓﻴﺒﻠﻐﻪ ﺩﻋﺎﺅﻫﻢ , ﻭﺭﺟﻞ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ , ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ , ﻭﺭﺟﻞ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ , ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﺊ، ﻭﺭﺟﻞ ﻣﺮاﺑﻂ ﻳﻨﻤﻰ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺤﺴﺎﺏ ". رواه الطبراني في الكبير. رحم الله موتى المسلمين. والله ٲعلم.
إنَّ أعظم ميزات هذا الدين: أنه احتفظ بصورته الأولى التي كان عليها زمن رسول الله ﷺ.
فتوارثته - كما هو - الأجيال اللاحقة عن السابقة:
- الأقوال.
- والأفعال.
- والأحوال.
وما انتقص منه من ذلك يستيقن المسلمون أنه منقوص بسبب جهل الأبناء وكيد الأعداء.
وتظل الأجيال تتناقل التنبيه على ذلك المنقوص - تقريرًا له وتعريفًا به - حتى إذا أتى جيل منها يستطيع إكماله وإتمامه يحول هذا التقرير والتعريف إلى تطبيق وتنفيذ.
تخيل لو استجابت الأمة إلى:
- زيادة: (حي على خير العمل)، و (أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله)، و (أشهد أن عليًّا ولي الله)، و (اختراعات المغرِّدين بعد انتهاء الأذان).. إلخ كلمات لم يأذن بها الله تعالى ورسوله ﷺ حسب هوى كل هاو ومزاج كل صادح.
هل كانت الأجيال ستميز الأذان المشروع؟ كلا.
- وقل مثل ذلك في بدع: الصلاة، والأذكار، والصلاة على النبي ﷺ، والصيام، والحج، والذكر بالصاجات مع الرقص في المساجد!!
والذين ينفرون من التنبيه على هذه البدع مَدينون بعظيم الشكر لمن يتحدثون فيها ويقومون على حراسة الدين بالتنبيه على ما صح وما لم يصح فيه وما هو منه عتيق وما هو مبتدع!
إن حفظ الدين - بكماله وتمامه، على صورته الأولى التي تركنا عليها المصطفى ﷺ - بعيدًا عن:
- تحريف الغالين.
- وانتحال المبطلين.
- وتأويل الجاهلين.
أولى مهامِّ علمائه وطلابه والمؤمنين به أجمعين.
وإن الله تعالى ليوفق في هذا الأمر توفيقًا عظيمًا تسهل معه تلك المهمة وما يدعمها.
وهذا كله من أمارات صدق الوعد الإلهي: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
.
فتوارثته - كما هو - الأجيال اللاحقة عن السابقة:
- الأقوال.
- والأفعال.
- والأحوال.
وما انتقص منه من ذلك يستيقن المسلمون أنه منقوص بسبب جهل الأبناء وكيد الأعداء.
وتظل الأجيال تتناقل التنبيه على ذلك المنقوص - تقريرًا له وتعريفًا به - حتى إذا أتى جيل منها يستطيع إكماله وإتمامه يحول هذا التقرير والتعريف إلى تطبيق وتنفيذ.
تخيل لو استجابت الأمة إلى:
- زيادة: (حي على خير العمل)، و (أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله)، و (أشهد أن عليًّا ولي الله)، و (اختراعات المغرِّدين بعد انتهاء الأذان).. إلخ كلمات لم يأذن بها الله تعالى ورسوله ﷺ حسب هوى كل هاو ومزاج كل صادح.
هل كانت الأجيال ستميز الأذان المشروع؟ كلا.
- وقل مثل ذلك في بدع: الصلاة، والأذكار، والصلاة على النبي ﷺ، والصيام، والحج، والذكر بالصاجات مع الرقص في المساجد!!
والذين ينفرون من التنبيه على هذه البدع مَدينون بعظيم الشكر لمن يتحدثون فيها ويقومون على حراسة الدين بالتنبيه على ما صح وما لم يصح فيه وما هو منه عتيق وما هو مبتدع!
إن حفظ الدين - بكماله وتمامه، على صورته الأولى التي تركنا عليها المصطفى ﷺ - بعيدًا عن:
- تحريف الغالين.
- وانتحال المبطلين.
- وتأويل الجاهلين.
أولى مهامِّ علمائه وطلابه والمؤمنين به أجمعين.
وإن الله تعالى ليوفق في هذا الأمر توفيقًا عظيمًا تسهل معه تلك المهمة وما يدعمها.
وهذا كله من أمارات صدق الوعد الإلهي: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
.
﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠)﴾ [العنكبوت: 60]
قال أبو البقاء العُكْبَري (ت: 616 هــ):
"قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ، وَ{مِنْ دَابَّةٍ}: تَبْيِينٌ [أي: تمييز]. وَ(لَا تَحْمِلُ): نَعْتٌ لِدَابَّةٍ. وَ(اللَّهُ يَرْزُقُهَا): جُمْلَةُ خَبَرِ (كَأَيِّنْ)، وَأُنِّثَ الضَّمِيرُ عَلَى الْمَعْنَى. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ {يَرْزُقُهَا}، وَيُقَدَّرُ بَعْدَ (كَأَيِّنْ)". التبيان في إعراب القرآن (2/ 1034).
وقال المنتجَب الهمَذاني (ت: 643 هــ):
"قوله عز وجل: {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ} يجوز [1] أن يكون في موضع رفع بالابتداء، ويكون قوله: {مِنْ دَابَّةٍ} في موضع التبيين له [أي: تمييز مجرور لِـ: {كأيِّن}]، ويكون قوله: {لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} في محل الجر على النعت للدابة، ويكون قوله: {اللَّهُ يَرْزُقُهَا} ابتداء وخبر، والجملة خبر المبتدأ الذي هو (كأَين)، وأنّث (كأَين) لقوله: {يَرْزُقُهَا} حملًا على المعنى. [2] وأن يكون في موضع نصب بفعل يفسِّره {يَرْزُقُهَا}، ويقدَّر بعد (كأَين)".
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 176).
وقد ضعَّف السمين الحلبي الوجه الإعرابي الثاني -رادًّا على العكبري- فقال:
"وفي الثاني نظرٌ؛ لأنَّ مِنْ شرط المفسِّرِ [{يَرْزُقُهَا}] العملَ، وهذا المفسِّر لا يعملُ؛ لأنه لو عَمِلَ لحلَّ مَحَلَّ الأولِ، لكنه لا يَحُلُّ مَحَلَّه؛ لأنَّ الخبرَ متى كان فعلاً رافعاً لضميرٍ مفردٍ امتنع تقديمُه على المبتدأ".
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ 26).
قلت (طاهر): ويكون تقدير الكلام على الإعراب الثاني: (وَكَثيرا مِنْ دَابَّةٍ لا ترفع رزقَها معها، ولا تدخره لِغَدٍ). وعلى الإعراب الأول لا يصح الوقف؛ لئلا تفصل بين المبتدأ والخبر، وهو ما عليه جمهور النحاة وعلماء الوقف والابتداء والمصاحف.
وعلى الإعراب الثاني يصح الوقف على ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾، والابتداء بـــ: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾،
وقد صح هذا الوقف عن نافع المدني.
ونقل النحَّاس (ت: 338 هـ) عن محمد بن عيسى {وكأين من دابة لا تحمل رزقها} تام، وقال غيره: التمام {وهو السميع العليم}"، القطع والائتناف (ص: 527)،
بل نعته الداني بأنه كافٍ، المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 160). وأشار إليه السجاوندي (ص: 331) وغيره بصيغة (قد قيل) التي توحي بالتضعيف.
ويمكن توجيه الإعراب الثاني بتقدير الفعل المفسِّر على: (واذكر كَثيرا مِنْ دَاوبَّ لا ترفع رزقَها معها، ولا تدخره لِغَدٍ)،
ويكون هناك سؤال محذوف تقديره: فما تفعل هذه الدواب الكثيرة التي لا تخزِّن قوتها؟ فيأتي الجواب: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠)﴾،
والله تعالى أعلى وأعلم.
كتبه حامدا ومصليا
طاهر بن سعيد الأسيوطي
قال أبو البقاء العُكْبَري (ت: 616 هــ):
"قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ، وَ{مِنْ دَابَّةٍ}: تَبْيِينٌ [أي: تمييز]. وَ(لَا تَحْمِلُ): نَعْتٌ لِدَابَّةٍ. وَ(اللَّهُ يَرْزُقُهَا): جُمْلَةُ خَبَرِ (كَأَيِّنْ)، وَأُنِّثَ الضَّمِيرُ عَلَى الْمَعْنَى. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ {يَرْزُقُهَا}، وَيُقَدَّرُ بَعْدَ (كَأَيِّنْ)". التبيان في إعراب القرآن (2/ 1034).
وقال المنتجَب الهمَذاني (ت: 643 هــ):
"قوله عز وجل: {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ} يجوز [1] أن يكون في موضع رفع بالابتداء، ويكون قوله: {مِنْ دَابَّةٍ} في موضع التبيين له [أي: تمييز مجرور لِـ: {كأيِّن}]، ويكون قوله: {لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} في محل الجر على النعت للدابة، ويكون قوله: {اللَّهُ يَرْزُقُهَا} ابتداء وخبر، والجملة خبر المبتدأ الذي هو (كأَين)، وأنّث (كأَين) لقوله: {يَرْزُقُهَا} حملًا على المعنى. [2] وأن يكون في موضع نصب بفعل يفسِّره {يَرْزُقُهَا}، ويقدَّر بعد (كأَين)".
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 176).
وقد ضعَّف السمين الحلبي الوجه الإعرابي الثاني -رادًّا على العكبري- فقال:
"وفي الثاني نظرٌ؛ لأنَّ مِنْ شرط المفسِّرِ [{يَرْزُقُهَا}] العملَ، وهذا المفسِّر لا يعملُ؛ لأنه لو عَمِلَ لحلَّ مَحَلَّ الأولِ، لكنه لا يَحُلُّ مَحَلَّه؛ لأنَّ الخبرَ متى كان فعلاً رافعاً لضميرٍ مفردٍ امتنع تقديمُه على المبتدأ".
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ 26).
قلت (طاهر): ويكون تقدير الكلام على الإعراب الثاني: (وَكَثيرا مِنْ دَابَّةٍ لا ترفع رزقَها معها، ولا تدخره لِغَدٍ). وعلى الإعراب الأول لا يصح الوقف؛ لئلا تفصل بين المبتدأ والخبر، وهو ما عليه جمهور النحاة وعلماء الوقف والابتداء والمصاحف.
وعلى الإعراب الثاني يصح الوقف على ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾، والابتداء بـــ: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾،
وقد صح هذا الوقف عن نافع المدني.
ونقل النحَّاس (ت: 338 هـ) عن محمد بن عيسى {وكأين من دابة لا تحمل رزقها} تام، وقال غيره: التمام {وهو السميع العليم}"، القطع والائتناف (ص: 527)،
بل نعته الداني بأنه كافٍ، المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 160). وأشار إليه السجاوندي (ص: 331) وغيره بصيغة (قد قيل) التي توحي بالتضعيف.
ويمكن توجيه الإعراب الثاني بتقدير الفعل المفسِّر على: (واذكر كَثيرا مِنْ دَاوبَّ لا ترفع رزقَها معها، ولا تدخره لِغَدٍ)،
ويكون هناك سؤال محذوف تقديره: فما تفعل هذه الدواب الكثيرة التي لا تخزِّن قوتها؟ فيأتي الجواب: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠)﴾،
والله تعالى أعلى وأعلم.
كتبه حامدا ومصليا
طاهر بن سعيد الأسيوطي