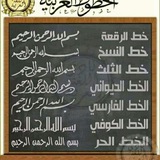و قَد يُعَالَجُ .
الصَّمَمُ : فَقدُ السَّمَعِ مُنذُ الوِلادَةِ .
27ـ الخَرَسُ : فَقدُ النُّطقِ لِعَارِضٍ ؛
و قَد يُعَالَجُ .
البَكَمُ : فَقدُ النُّطقِ مُنذُ الوِلادَةِ .
28ـ الشَّلَلُ : فَقدُ حَرَكَةِ الأطرَافِ لِعَارِضٍ ؛
و قَد يُعَالَجُ .
الكُسَاحُ : فَقدُ حَرَكَةِ الأطرَافِ مُنذُ الوِلادَةِ .
29ـ العُقْرُ : عَدَمُ الإنجَابِ لِعَارِضٍ ؛
و قَد يُعَالَجُ .
العُقْمُ : عَدَمُ الإنجَابِ خِلْقَةً .
30ـ الشَّقِيقُ : الّذي يَشتَرِكُ
بِنَفْسِ الأبِ و الأمِّ .
الأخُ : الّذي يَشتَرِكُ بِالأبِ أو بِالأمِّ .
31ـ الفِطرَةُ : الخِلْقَةُ ، و الطَّبيعَةُ ،
في الإنسانِ .
الغَرِيزَةُ : الخِلْقَةُ ، و الطَّبيعَةُ ،
في الحَيَوانِ .
32ـ مَاتَ : مَن تُوُفِّيَ و لَهُ وَرَثَةٌ .
هَلَكَ : مَن تُوُفِّيَ و لَيسَ لَهُ وَرَثَةٌ .
33ـ القُبُورُ : مَدَافِنُ أجسَادِ المَوتَى .
الأجدَاثُ : أمَاكِنُ إحيَاءِ أجسَادِ المَوتَى ؛ لأصوَاتِ خُرُوجِ أصحَابِهَا مُسرِعِينَ لأرضِ المَحشَرِ ( الجَدَثَةُ : صَوتُ الأخفَافِ و الحَوَافِرِ ، و مَضْغِ اللَّحمِ ) .
[ *و اللَّهُ ـ ﷻ ـ العَلِيمُ أعلَمُ* ] •
... إلى غَيرِ ذلكَ مِن التَّرَادُفِ الرَّائِع
في لُغَتِنَا العَرَبِيَّةِ الرّائِعَةِ السّاطِعَة
و الحَمْدُ لِلَّهِ أوَّلًا و آخِرًا .
الصَّمَمُ : فَقدُ السَّمَعِ مُنذُ الوِلادَةِ .
27ـ الخَرَسُ : فَقدُ النُّطقِ لِعَارِضٍ ؛
و قَد يُعَالَجُ .
البَكَمُ : فَقدُ النُّطقِ مُنذُ الوِلادَةِ .
28ـ الشَّلَلُ : فَقدُ حَرَكَةِ الأطرَافِ لِعَارِضٍ ؛
و قَد يُعَالَجُ .
الكُسَاحُ : فَقدُ حَرَكَةِ الأطرَافِ مُنذُ الوِلادَةِ .
29ـ العُقْرُ : عَدَمُ الإنجَابِ لِعَارِضٍ ؛
و قَد يُعَالَجُ .
العُقْمُ : عَدَمُ الإنجَابِ خِلْقَةً .
30ـ الشَّقِيقُ : الّذي يَشتَرِكُ
بِنَفْسِ الأبِ و الأمِّ .
الأخُ : الّذي يَشتَرِكُ بِالأبِ أو بِالأمِّ .
31ـ الفِطرَةُ : الخِلْقَةُ ، و الطَّبيعَةُ ،
في الإنسانِ .
الغَرِيزَةُ : الخِلْقَةُ ، و الطَّبيعَةُ ،
في الحَيَوانِ .
32ـ مَاتَ : مَن تُوُفِّيَ و لَهُ وَرَثَةٌ .
هَلَكَ : مَن تُوُفِّيَ و لَيسَ لَهُ وَرَثَةٌ .
33ـ القُبُورُ : مَدَافِنُ أجسَادِ المَوتَى .
الأجدَاثُ : أمَاكِنُ إحيَاءِ أجسَادِ المَوتَى ؛ لأصوَاتِ خُرُوجِ أصحَابِهَا مُسرِعِينَ لأرضِ المَحشَرِ ( الجَدَثَةُ : صَوتُ الأخفَافِ و الحَوَافِرِ ، و مَضْغِ اللَّحمِ ) .
[ *و اللَّهُ ـ ﷻ ـ العَلِيمُ أعلَمُ* ] •
... إلى غَيرِ ذلكَ مِن التَّرَادُفِ الرَّائِع
في لُغَتِنَا العَرَبِيَّةِ الرّائِعَةِ السّاطِعَة
و الحَمْدُ لِلَّهِ أوَّلًا و آخِرًا .
كنايات عربية :
• فلان طويل الذيل: أي (غني)
• فلان جَعْدُ اليدين: أي (بخيل)
• فلان لا يضع العصا عن عاتقه: أي (كثير الأسفار)
• فلان ألقى عصاه: أي (أقام في المكان وترك السفر)
• فلان كثير الرماد: أي (كثير الكرم والسخاء)
📚جواهر البلاغة / لسان العرب
• فلان طويل الذيل: أي (غني)
• فلان جَعْدُ اليدين: أي (بخيل)
• فلان لا يضع العصا عن عاتقه: أي (كثير الأسفار)
• فلان ألقى عصاه: أي (أقام في المكان وترك السفر)
• فلان كثير الرماد: أي (كثير الكرم والسخاء)
📚جواهر البلاغة / لسان العرب
قالت العرب:
خيرُ الأمورِ لا رَوْش ولَا وَرْش.
- الرَّوشُ: الأكل الكثير.
- الوَرشُ: الأكل القليل.
- لسانُ العربِ."
خيرُ الأمورِ لا رَوْش ولَا وَرْش.
- الرَّوشُ: الأكل الكثير.
- الوَرشُ: الأكل القليل.
- لسانُ العربِ."
في حدة اللسان والفصاحة :
• إذا كان الرجل حادّ اللسان قيل : ذَرِب اللسان، وفتيق اللسان .
• فإذا كان جيد اللسان فهو لسن .
• فإذا كان يضع لسانه حيث يريد فهو : ذليق .
• فإذا كان فصيحاً بين اللهجة فهو : حذاقي .
• فإذا كان مع حدة لسانه بليغاً فهو : مسلاق .
• فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة ، ولا بيانه عجمة فهو : مصقع .
• فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو : مدره .
• إذا كان الرجل حادّ اللسان قيل : ذَرِب اللسان، وفتيق اللسان .
• فإذا كان جيد اللسان فهو لسن .
• فإذا كان يضع لسانه حيث يريد فهو : ذليق .
• فإذا كان فصيحاً بين اللهجة فهو : حذاقي .
• فإذا كان مع حدة لسانه بليغاً فهو : مسلاق .
• فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة ، ولا بيانه عجمة فهو : مصقع .
• فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو : مدره .
في معايب العين :
• الحَوَصُ : ضيق العينين .
• الخَوَصُ : غُئُورُهما مع الضيق .
• الشَّتَرُ : انقلاب الجفن .
• العَمَشُ : أن لا تزال العين تسيل وتَرْقُصُ .
• الكَمَشُ : ألا تكاد تبصر ليلاً .
• الغَطَشُ : شبه العمش .
• الجَهَرُ : أن لا تبصر نهاراً .
• العَشَا : أن لا تبصر ليلاً .
• الخَزَرُ : أن ينظر بمؤخر عينه .
• الغَضَنُ : أن يكسر عينه حتى تَتَغَضَّنَ جُفُونه .
• القَتَلُ : أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحَوَلِ .
• الشُّطُورُ : أن تراه ينظر إليك ، وهو ينظر إلى غيرك .
• الشَّوَسُ : أن ينظر بإحدى عينيه ويُميلَ وجهَهُ في شقّ العينِ التي يريد أن ينظر بها .
• الخَفَشُ : صِغَرُ العين وضعف البصر .
• الدَّوَشُ : ضيق العين وفساد البصر .
• الإِطْرَاقُ : استرخاء الجفون .
• الجُحُوظُ : خروج المقلة وظهورها من الحجاج .
• البَخَق : أن يذهب البصر والعين منفتحة .
• الكَمَهُ : أن يولد الإِنسان أعمى .
• البَخَصُ : أن يكون فوق العينين أو تحتها لحم ناتىء .
• الحَوَصُ : ضيق العينين .
• الخَوَصُ : غُئُورُهما مع الضيق .
• الشَّتَرُ : انقلاب الجفن .
• العَمَشُ : أن لا تزال العين تسيل وتَرْقُصُ .
• الكَمَشُ : ألا تكاد تبصر ليلاً .
• الغَطَشُ : شبه العمش .
• الجَهَرُ : أن لا تبصر نهاراً .
• العَشَا : أن لا تبصر ليلاً .
• الخَزَرُ : أن ينظر بمؤخر عينه .
• الغَضَنُ : أن يكسر عينه حتى تَتَغَضَّنَ جُفُونه .
• القَتَلُ : أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحَوَلِ .
• الشُّطُورُ : أن تراه ينظر إليك ، وهو ينظر إلى غيرك .
• الشَّوَسُ : أن ينظر بإحدى عينيه ويُميلَ وجهَهُ في شقّ العينِ التي يريد أن ينظر بها .
• الخَفَشُ : صِغَرُ العين وضعف البصر .
• الدَّوَشُ : ضيق العين وفساد البصر .
• الإِطْرَاقُ : استرخاء الجفون .
• الجُحُوظُ : خروج المقلة وظهورها من الحجاج .
• البَخَق : أن يذهب البصر والعين منفتحة .
• الكَمَهُ : أن يولد الإِنسان أعمى .
• البَخَصُ : أن يكون فوق العينين أو تحتها لحم ناتىء .
#فائدة_لغوية
الفرقُ بينَ «ويح» و«ويل»
• وَيْحٌ: كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقُّها، فيُرثى له رحمةً، كما في قوله ﷺ: «يا ويح عمَّار تقتُله الفئة الباغية».
• وَيْلٌ: كلمة تقال لمن يستحقُّ الهلكة، كما في قوله تعالى: ﴿وهما يستغيثان الله ويلك آمن إنَّ وعد الله حقٌّ﴾.
الفرقُ بينَ «ويح» و«ويل»
• وَيْحٌ: كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقُّها، فيُرثى له رحمةً، كما في قوله ﷺ: «يا ويح عمَّار تقتُله الفئة الباغية».
• وَيْلٌ: كلمة تقال لمن يستحقُّ الهلكة، كما في قوله تعالى: ﴿وهما يستغيثان الله ويلك آمن إنَّ وعد الله حقٌّ﴾.
- لا تقل (شَعَرَ بألم).
ولكن قل (أَحَسَّ بألم) أو (وَجَدَ ألمًا).
لأن شَعَر معناه عَلِم.
- قال الله تعالى:
﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يعلمون.
ومنه قول العرب:
ليت شعري أي: ليتني علمت."
ولكن قل (أَحَسَّ بألم) أو (وَجَدَ ألمًا).
لأن شَعَر معناه عَلِم.
- قال الله تعالى:
﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يعلمون.
ومنه قول العرب:
ليت شعري أي: ليتني علمت."
قال ابن عباس رضي الله عنه :
"الخطُّ لسانُ اليدِ، والبلاغةُ لسانُ العقلِ، والعقلُ لسانُ المحاسنِ، والمحاسنُ كمالُ الإنسانِ"..
"الخطُّ لسانُ اليدِ، والبلاغةُ لسانُ العقلِ، والعقلُ لسانُ المحاسنِ، والمحاسنُ كمالُ الإنسانِ"..
من الخطأ الشائع تسكينُ باءِ (السبُع) في قوله تعالى:
﴿…وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ…﴾ [المائدة ٣].
❎ {..وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبْعُ..}.
✅ {..وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ..}.
⬅️ السَّبْعُ: من العدد.
⬅️ السَّبُع: كالأسد والنَّمِر.
﴿…وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ…﴾ [المائدة ٣].
❎ {..وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبْعُ..}.
✅ {..وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ..}.
⬅️ السَّبْعُ: من العدد.
⬅️ السَّبُع: كالأسد والنَّمِر.
[إِيَّاك، هِيَّاك، وِيَّاك]
«و(إيَّا) بالكسر والفتح [أيَّا]: اسْمٌ مُبْهَمٌ تَتَّصِلُ به جَميعُ المُضْمَراتِ المُتَّصِلَةِ التي للنَّصْبِ:
إيّاكَ، وإيّاهُ، وإيّايَ.
وتُبْدَلُ هَمْزَتُه هاءً [هِيَّاك]، وتارَةً واوًا؛ تقولُ: وِيَّاكَ».
الفيروز آبادي: القاموس المحيط (١/ ١٣٤٩).
«و(إيَّا) بالكسر والفتح [أيَّا]: اسْمٌ مُبْهَمٌ تَتَّصِلُ به جَميعُ المُضْمَراتِ المُتَّصِلَةِ التي للنَّصْبِ:
إيّاكَ، وإيّاهُ، وإيّايَ.
وتُبْدَلُ هَمْزَتُه هاءً [هِيَّاك]، وتارَةً واوًا؛ تقولُ: وِيَّاكَ».
الفيروز آبادي: القاموس المحيط (١/ ١٣٤٩).
#لا_أصل_ولا_فصل
*قال يحيى بن معين:*
رأيت يحيى بن سعيد القطان يبكي، وقال له شيخ من جيرانه إنك لا أصل لك فجئته وهو يبكي وهو يقول: أجل، والله ما لي أصل ولا فصل، وما أنا، ومن أنا. [١]
*قال ابن تيمية:*
وقد يقول المعير للرجل: مالك أصل ولا فصل، ولكن الإنسان أصله التراب، وفصله الماء المهين. [٢]
*قال الكسائي [٣] والجوهري [٤]*
الأصل: الحسب
الفصل: اللسان
*بينما قال ثعلب [٥] والراغب الأصفهاني [٦]*
الأصل: الوالد
الفصل: الولد
*ذكر أبو الوليد الباجي:*
أن من قال لرجل ليس لك أصل ولا فصل فعليه العقوبة اتفاقا ولكنها لا تصل إلى إقامة حد القذف على القائل لأن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وقطع النسب، وإنما يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول ونفي الشرف فلا يجب بذلك الحد وإنما يجب به العقوبة.
وقد جعل بعضهم العقوبة هي إقامة حد القذف على القائل لأن مقتضى اللفظ في اللغة نفي النسب ولا يكاد يستعمل إلا في مشاتمة فحمل على ذلك.
وفرق بعضهم بين العرب والعجم فإن قيلت لعربي فعلى القائل حد القذف لأنه قطع نسبه إلا أن يحلف أنه لم يرد بذلك نسبه فيعاقب بغير حد القذف كما يعاقب من قالها لعجمي بغير حد القذف.
ووجه الفرق بين العرب والعجم أن العرب هي التي تتعلق بالأنساب، وتتواصل بها وتتفاخر باتصالها وتذم بانقطاعها فاختص هذا الحكم بها. [٧]
‐-----------------------
[١] شعب الإيمان للبيهقي (٨٤٦٧)
[٢] كتاب النبوات (٣٢٦)
[٣] مقاييس اللغة (١/١٠٩)
[٤] مختار الصحاح (ص١٩)
[٥] البصائر والذخائر لأبي حيان (١/٢٠)
[٦] محاضرات الأدباء (١/٤١٣)
[٧] المنتقى شرح الموطأ (٧/١٥١).
منقول
*قال يحيى بن معين:*
رأيت يحيى بن سعيد القطان يبكي، وقال له شيخ من جيرانه إنك لا أصل لك فجئته وهو يبكي وهو يقول: أجل، والله ما لي أصل ولا فصل، وما أنا، ومن أنا. [١]
*قال ابن تيمية:*
وقد يقول المعير للرجل: مالك أصل ولا فصل، ولكن الإنسان أصله التراب، وفصله الماء المهين. [٢]
*قال الكسائي [٣] والجوهري [٤]*
الأصل: الحسب
الفصل: اللسان
*بينما قال ثعلب [٥] والراغب الأصفهاني [٦]*
الأصل: الوالد
الفصل: الولد
*ذكر أبو الوليد الباجي:*
أن من قال لرجل ليس لك أصل ولا فصل فعليه العقوبة اتفاقا ولكنها لا تصل إلى إقامة حد القذف على القائل لأن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وقطع النسب، وإنما يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول ونفي الشرف فلا يجب بذلك الحد وإنما يجب به العقوبة.
وقد جعل بعضهم العقوبة هي إقامة حد القذف على القائل لأن مقتضى اللفظ في اللغة نفي النسب ولا يكاد يستعمل إلا في مشاتمة فحمل على ذلك.
وفرق بعضهم بين العرب والعجم فإن قيلت لعربي فعلى القائل حد القذف لأنه قطع نسبه إلا أن يحلف أنه لم يرد بذلك نسبه فيعاقب بغير حد القذف كما يعاقب من قالها لعجمي بغير حد القذف.
ووجه الفرق بين العرب والعجم أن العرب هي التي تتعلق بالأنساب، وتتواصل بها وتتفاخر باتصالها وتذم بانقطاعها فاختص هذا الحكم بها. [٧]
‐-----------------------
[١] شعب الإيمان للبيهقي (٨٤٦٧)
[٢] كتاب النبوات (٣٢٦)
[٣] مقاييس اللغة (١/١٠٩)
[٤] مختار الصحاح (ص١٩)
[٥] البصائر والذخائر لأبي حيان (١/٢٠)
[٦] محاضرات الأدباء (١/٤١٣)
[٧] المنتقى شرح الموطأ (٧/١٥١).
منقول
قوة الحركة تتحكم بصورة الهمزة المتوسطة، نحو :
سُئِلَ: همزة على ياء لقوة الكسرة
سُؤَال: همزة على واو لقوة الضمة
مسْألة: همزة على ألف لقوة الفتحة
أسْئِلة: همزة على ياء لقوة الكسرة
مسائِل: همزة على ياء لقوة الكسرة
سُؤْل: همزة على الواو لقوة الضمة
مسؤُول:همزة على الواو لقوة الضمة
سُئِلَ: همزة على ياء لقوة الكسرة
سُؤَال: همزة على واو لقوة الضمة
مسْألة: همزة على ألف لقوة الفتحة
أسْئِلة: همزة على ياء لقوة الكسرة
مسائِل: همزة على ياء لقوة الكسرة
سُؤْل: همزة على الواو لقوة الضمة
مسؤُول:همزة على الواو لقوة الضمة
الأشياء الرديئة :
• الخُلْقُ : القَوْلُ الرَّدِيءُ .
• الحَشَفُ : التَّمْرُ الرَّدِيءُ .
• الحَنِيفُ : الكِتَّانُ الرَّدِيءُ .
• السَّفْسَافُ : الأمْرُ الرَّدِيءُ .
• الهُرَاءُ : الكلامُ الرَّدِيءُ .
• المُهَلْهَلَةُ : الدِّرْعُ الرَّدِيئَةُ .
• البَهْرَجُ والزَّائِفُ : الدِّرْهَمُ الرَّدِيءُ .
• الخُلْقُ : القَوْلُ الرَّدِيءُ .
• الحَشَفُ : التَّمْرُ الرَّدِيءُ .
• الحَنِيفُ : الكِتَّانُ الرَّدِيءُ .
• السَّفْسَافُ : الأمْرُ الرَّدِيءُ .
• الهُرَاءُ : الكلامُ الرَّدِيءُ .
• المُهَلْهَلَةُ : الدِّرْعُ الرَّدِيئَةُ .
• البَهْرَجُ والزَّائِفُ : الدِّرْهَمُ الرَّدِيءُ .
📒 جمال اللغة العربية
أَتَى : جاء من مكان قريب
قَدم : جاء من مكان بعيد
أَقْبَلَ: جاء راغبا متحمسا
حَضَر : جاء تلبية لدعوة
زارَ : جاء بقصد التواصل والبر
طَرَق: جاء ليلا
غَشِي: جاء صدفة دون علم
وافَى:جاء والتقى بالمقصود في الطريق
وَرَدَ: جاء بقصد التزود بالماء
وَفَدَ : جاء مع جماعة
أَتَى : جاء من مكان قريب
قَدم : جاء من مكان بعيد
أَقْبَلَ: جاء راغبا متحمسا
حَضَر : جاء تلبية لدعوة
زارَ : جاء بقصد التواصل والبر
طَرَق: جاء ليلا
غَشِي: جاء صدفة دون علم
وافَى:جاء والتقى بالمقصود في الطريق
وَرَدَ: جاء بقصد التزود بالماء
وَفَدَ : جاء مع جماعة
للفائده:
العَنْكَبُوت أنثى، ذكَرُها العنكَب.
العَقْرَب أنثى، ذكَرُها العُقْرُبان.
الأفعى أنثى، ذَكَرُها الأُفعُوان.
النَّمْلة أنثى، ذكَرها الشَّيْصَبان.
النَّحْلة أنثى، ذكَرُها اليعسوب.
البقرة أنثى، ذكَرُها الثور.
اللبؤة أنثى، ذَكَرُها الأسد.
الأتان أُنثَى، ذَكَرُها الحمار.
السلحفاة أنثى، ذَكَرها الغَيْلَم.
العَيثُوم أنثى، ذَكَرها الفيل.
الفرس أنثى، ذكَرها الحصان، وكلاهما خَيْل.
الناقة أنثى، ذكَرُها الجَمَل، وكلاهما بَعِير.
العنزة أنثى، ذكَرُها التَّيْس، وكلاهما ماعز.
النعجة أنثى، ذكَرُها الخَرُوف، وكلاهما ضأن.
المرأة أنثى، ذكَرُها الرجل، وكلاهما إنسان.
📚 لسان العرب
العَنْكَبُوت أنثى، ذكَرُها العنكَب.
العَقْرَب أنثى، ذكَرُها العُقْرُبان.
الأفعى أنثى، ذَكَرُها الأُفعُوان.
النَّمْلة أنثى، ذكَرها الشَّيْصَبان.
النَّحْلة أنثى، ذكَرُها اليعسوب.
البقرة أنثى، ذكَرُها الثور.
اللبؤة أنثى، ذَكَرُها الأسد.
الأتان أُنثَى، ذَكَرُها الحمار.
السلحفاة أنثى، ذَكَرها الغَيْلَم.
العَيثُوم أنثى، ذَكَرها الفيل.
الفرس أنثى، ذكَرها الحصان، وكلاهما خَيْل.
الناقة أنثى، ذكَرُها الجَمَل، وكلاهما بَعِير.
العنزة أنثى، ذكَرُها التَّيْس، وكلاهما ماعز.
النعجة أنثى، ذكَرُها الخَرُوف، وكلاهما ضأن.
المرأة أنثى، ذكَرُها الرجل، وكلاهما إنسان.
📚 لسان العرب
فصل في معايب خلق الانسان :
• إذا كان صغير الرَّأْسِ فهو : أَصْعَلُ وسَمَعْمَعُ .
• إذا كان فيه عِوَجٌ فهو : أَشْدَفُ .
• إذا كان عريضه فهو : أَفْطَح .
• إذا كانت به شَجَّةٌ فهو : أَشَجُ .
• إذا أدبرت جبهته وأقبلت هامته فهو : أَكْبَسُ .
• إذا كان ناقص الخلق فهو : أَكْثَمُ .
• إذا كان مُعْوَجَّ القَدِّ فهو : أَخْفَجُ .
• إذا كان مائل الشقّ فهو : أَحْدَلُ .
• إذا كان طويلاً منحنياً فهو : أَسْقَفُ .
• إذا كان منحني الظهر فهو : أَدَنُ .
• إذا خرج ظهره ودخل صدره فهو : أَحْدَبُ .
• إذا خرج صدره ودخل ظهره فهو : أَقْعَسُ .
• إذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه فهو : أَلَصّ .
• إذا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى صدره فهو : أَجْنَأُ وأَدْنَأُ .
• إذا كان يتكلم من قِبَل خَيْشُومه فهو : أَغَنُّ .
• إذا كانت في صوته بُحَّةٌ فهو : أَصْحَلُ .
• إذا كان صغير الرَّأْسِ فهو : أَصْعَلُ وسَمَعْمَعُ .
• إذا كان فيه عِوَجٌ فهو : أَشْدَفُ .
• إذا كان عريضه فهو : أَفْطَح .
• إذا كانت به شَجَّةٌ فهو : أَشَجُ .
• إذا أدبرت جبهته وأقبلت هامته فهو : أَكْبَسُ .
• إذا كان ناقص الخلق فهو : أَكْثَمُ .
• إذا كان مُعْوَجَّ القَدِّ فهو : أَخْفَجُ .
• إذا كان مائل الشقّ فهو : أَحْدَلُ .
• إذا كان طويلاً منحنياً فهو : أَسْقَفُ .
• إذا كان منحني الظهر فهو : أَدَنُ .
• إذا خرج ظهره ودخل صدره فهو : أَحْدَبُ .
• إذا خرج صدره ودخل ظهره فهو : أَقْعَسُ .
• إذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه فهو : أَلَصّ .
• إذا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى صدره فهو : أَجْنَأُ وأَدْنَأُ .
• إذا كان يتكلم من قِبَل خَيْشُومه فهو : أَغَنُّ .
• إذا كانت في صوته بُحَّةٌ فهو : أَصْحَلُ .
حَرْفُ الجَر " فِي " :
• ظَرفِيَّةٌ مَكَانِيَّةٌ: "أَقَامَ فِي الْجَبَلِ" .
• ظَرفِيَّةٌ زَمَانِيَّةٌ: "وَصَلَ فِي الْمَسَاءِ" .
• ظَرفِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ : "الْمَعَادِنُ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ" .
• ظَرفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ : "السَّعَادَةُ فِي رَاحَةِ النَّفْسِ" .
• المُقَايَسَةُ : "لَسْتُ شَيْئاً يُذْكَرُ فِي بِلاَدِهِ": أَيْ بِالقِيَاسِ إِلَى مَا فِي بِلاَدِهِ
﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيل﴾ .
•المُصَاحَبَةُ : "خَرَجْتُ فِي صُحْبَتِهِ" ، "جَاءَ فِي مَوْكِبِ الرَّئِيسِ" .
• السَّبَبِيَّةُ : "عُوقِبَ فِي ذَنْبِهِ": أَيْ بِسَبَبِ .
• الاستِعلاَءُ بِمَعْنَى عَلَى : ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل﴾ .
• يَجِيءُ بِمَعْنَى "بِ" : "وَقَفَ الْحَارِسُ فِي البَابِ" ، "دَخَلَ فِي زِيِّهِ العَسْكَرِيِّ" .
• كَمَا يَجِيءُ بِمَعْنَى "إِلَى" : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً﴾ أَي إِلَى كُلِّ .
• ويَجِيءُ بِمَعْنَى "مِنْ" التَّبْعِيضِيَّةِ : "أَخَذْتُ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ" .
• ظَرفِيَّةٌ مَكَانِيَّةٌ: "أَقَامَ فِي الْجَبَلِ" .
• ظَرفِيَّةٌ زَمَانِيَّةٌ: "وَصَلَ فِي الْمَسَاءِ" .
• ظَرفِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ : "الْمَعَادِنُ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ" .
• ظَرفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ : "السَّعَادَةُ فِي رَاحَةِ النَّفْسِ" .
• المُقَايَسَةُ : "لَسْتُ شَيْئاً يُذْكَرُ فِي بِلاَدِهِ": أَيْ بِالقِيَاسِ إِلَى مَا فِي بِلاَدِهِ
﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيل﴾ .
•المُصَاحَبَةُ : "خَرَجْتُ فِي صُحْبَتِهِ" ، "جَاءَ فِي مَوْكِبِ الرَّئِيسِ" .
• السَّبَبِيَّةُ : "عُوقِبَ فِي ذَنْبِهِ": أَيْ بِسَبَبِ .
• الاستِعلاَءُ بِمَعْنَى عَلَى : ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل﴾ .
• يَجِيءُ بِمَعْنَى "بِ" : "وَقَفَ الْحَارِسُ فِي البَابِ" ، "دَخَلَ فِي زِيِّهِ العَسْكَرِيِّ" .
• كَمَا يَجِيءُ بِمَعْنَى "إِلَى" : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً﴾ أَي إِلَى كُلِّ .
• ويَجِيءُ بِمَعْنَى "مِنْ" التَّبْعِيضِيَّةِ : "أَخَذْتُ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ" .
تحولات الأسماء بتغير الأحوال :
• لا يُقال : بِسَاط، إلا إذا كان مَبْسُوطاً، وإلا فهو طُوُّق .
• لا يُقال : وِعَاء، إلا إذا كان مملوءاً، وإلا فهو جَفْنَة .
• لا يُقال : سَفِينَة، إلا إذا كانت في البحر، وإلا فهي قَارِب .
• لا يُقال : قُبَّة، إلا إذا كان فوقها سقف، وإلا فهي خِبَاء .
• لا يُقال : مَصْبَاح، إلا إذا كان مُضَاءً، وإلا فهو فَانُوس .
• لا يُقال : مِقْعَد، إلا إذا كان مُرْتَفِعاً، وإلا فهو دَكَّة .
• لا يُقال : مِظَلَّة، إلا إذا كانت مفتوحة، وإلا فهي طَرِيقَة .
• لا يُقال : حَقِيبَة، إلا إذا كان لها غَطَاء، وإلا فهي صُرَّة .
• لا يُقال : سَاعَة، إلا إذا كانت تُشِير إلى الوقت، وإلا فهي عَقْرَب .
• لا يُقال : سَيْف، إلا إذا كان له نَصْل، وإلا فهو غِمْد .
• لا يُقال : بِسَاط، إلا إذا كان مَبْسُوطاً، وإلا فهو طُوُّق .
• لا يُقال : وِعَاء، إلا إذا كان مملوءاً، وإلا فهو جَفْنَة .
• لا يُقال : سَفِينَة، إلا إذا كانت في البحر، وإلا فهي قَارِب .
• لا يُقال : قُبَّة، إلا إذا كان فوقها سقف، وإلا فهي خِبَاء .
• لا يُقال : مَصْبَاح، إلا إذا كان مُضَاءً، وإلا فهو فَانُوس .
• لا يُقال : مِقْعَد، إلا إذا كان مُرْتَفِعاً، وإلا فهو دَكَّة .
• لا يُقال : مِظَلَّة، إلا إذا كانت مفتوحة، وإلا فهي طَرِيقَة .
• لا يُقال : حَقِيبَة، إلا إذا كان لها غَطَاء، وإلا فهي صُرَّة .
• لا يُقال : سَاعَة، إلا إذا كانت تُشِير إلى الوقت، وإلا فهي عَقْرَب .
• لا يُقال : سَيْف، إلا إذا كان له نَصْل، وإلا فهو غِمْد .
جَعْبَتك:
💭يقولون:
- هات أو قُلْ ما في (جَعْبَتك): أي أخرج ما في صدرك من كلام وأخبار وغيره.
- ليس في (جَعْبَته) شيء: أي ليس عنده أخبار.
• (الجَعْبَة) بالفتح✔️ لا بالضمّ (الجُعْبة)❌، تعني: (وعاء السِّهام والنِّبال)، فيقال: قاتَل حتّى آخر سهمٍ في (جَعْبَته).
💭يقولون:
- هات أو قُلْ ما في (جَعْبَتك): أي أخرج ما في صدرك من كلام وأخبار وغيره.
- ليس في (جَعْبَته) شيء: أي ليس عنده أخبار.
• (الجَعْبَة) بالفتح✔️ لا بالضمّ (الجُعْبة)❌، تعني: (وعاء السِّهام والنِّبال)، فيقال: قاتَل حتّى آخر سهمٍ في (جَعْبَته).
- وجمع قِطّ قِطَطَة، لا قِطَط: جمع القِطّ قِطَطَة، كما نجمع دِيك على دِيَكة وفيل على فِيَلة... أما جمع القطة فهو قِطط.
- وجمع هِرّ هِرَرَة، لا هِرَر: جمع الهِرّ هِرَرَة، كما نجمع دِيك على دِيَكة وفيل على فِيَلة... أما جمع الهِرَّة فهو هِرَر.
- وجمع هِرّ هِرَرَة، لا هِرَر: جمع الهِرّ هِرَرَة، كما نجمع دِيك على دِيَكة وفيل على فِيَلة... أما جمع الهِرَّة فهو هِرَر.