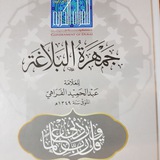بلاغة المشاعر 🍃
ميشيل لكروا في كتابه عبادة المشاعر يقسم المشاعر الى مشاعر هائجة ومنفعلة ( مشاعر الصدمة ) وإلى مشاعر هادئة وتأملية ( مشاعر الإحساس ) ويرى مشكلة العصر الحديث في تغلب مشاعر الصدمة على مشاعر الإحساس هذا من جانب فلسفي ونفسي
ومن جانب فني وجمالي فإن المذاهب الحديثة في الفن تسعى إلى التجديد المستثير لمشاعر الصدمة بشكل هوسي ومحموم في اللوحات الفنية والروايات والشعر والإعلام وغيرها
بينما الأعمال الأدبية القديمة تتسم باستثارة هادئة متوازنة لمشاعر القارئ
ذات الفرق نجده بين الأدب الجاهلي والأموي وبين أدب العصور المتأخرة
وإذا وجدت القارئ يفضل قصيدة لأبي تمام مليئة بالمحسنات البديعية على قصيدة للنابغة أو يفضل شعر المتنبي المزدحم بالحكم والمواعظ المباشرة على قصائد زهير فاحكم على ذوق القارئ بالارتهان لمشاعر الصدمة
وإصلاح القارئ لذوقه وتحرير نفسه من هوس التجديد وتهذيب المعلم أذواق تلامذته هو السبيل لإعادة اكتشاف وإنتاج الجمال الحقيقي .
ميشيل لكروا في كتابه عبادة المشاعر يقسم المشاعر الى مشاعر هائجة ومنفعلة ( مشاعر الصدمة ) وإلى مشاعر هادئة وتأملية ( مشاعر الإحساس ) ويرى مشكلة العصر الحديث في تغلب مشاعر الصدمة على مشاعر الإحساس هذا من جانب فلسفي ونفسي
ومن جانب فني وجمالي فإن المذاهب الحديثة في الفن تسعى إلى التجديد المستثير لمشاعر الصدمة بشكل هوسي ومحموم في اللوحات الفنية والروايات والشعر والإعلام وغيرها
بينما الأعمال الأدبية القديمة تتسم باستثارة هادئة متوازنة لمشاعر القارئ
ذات الفرق نجده بين الأدب الجاهلي والأموي وبين أدب العصور المتأخرة
وإذا وجدت القارئ يفضل قصيدة لأبي تمام مليئة بالمحسنات البديعية على قصيدة للنابغة أو يفضل شعر المتنبي المزدحم بالحكم والمواعظ المباشرة على قصائد زهير فاحكم على ذوق القارئ بالارتهان لمشاعر الصدمة
وإصلاح القارئ لذوقه وتحرير نفسه من هوس التجديد وتهذيب المعلم أذواق تلامذته هو السبيل لإعادة اكتشاف وإنتاج الجمال الحقيقي .
Forwarded from طُروس 📚
وتلك المشاغل التي يصفها كانت في التدريس وفي الإشراف على معاهد وكلّيات وأمور جسام! غفر الله له ورحمه.
☝️🏻أصدرت مجلة الهند عدداً خاصاً بالفراهي رحمه الله تعالى فيه دراسات كثيرة عنه وكل عدد بحجم كتاب
" إن أهمية عمله ( السكاكي ) تكمن في اكتشاف منطقة تقاطع النحو والمنطق والشعر ، أي في وصوله شخصياً إلى عاصمة البلاغة وبذلك خرج من خطاب التنافي بين النحو والمنطق والشعر الذي تاه فيه متى بن يونس والسيرافي وغيرهما ، وكان من خقه أن يقول : وجدتها "
محمد العمري
محمد العمري
" يبدو أن السكاكي قد حاول في البداية أن يتلافى مصطلحي " بلاغة وفصاحة" فراراً من حمولتهما الفكرية والعقدية ..
غير أنه انتبه في نهاية المطاف إلى أن إشعاع الكلمتين في التراث العربي يجعل السكوت عنهما أو تعويضهما أمراً عسيراً ، خاصة وأن النحز بمفهومه الدقيق في عصره أصبح أكثر صورية وضيقاً بحيث لا يتسع كما كان في وقت سابق _عند صاحب الخصائص مثلاً بل عند مؤسس النحو سيبويه _ "
محمد العمري
غير أنه انتبه في نهاية المطاف إلى أن إشعاع الكلمتين في التراث العربي يجعل السكوت عنهما أو تعويضهما أمراً عسيراً ، خاصة وأن النحز بمفهومه الدقيق في عصره أصبح أكثر صورية وضيقاً بحيث لا يتسع كما كان في وقت سابق _عند صاحب الخصائص مثلاً بل عند مؤسس النحو سيبويه _ "
محمد العمري
ماذا لو تم تعريف وبناء علم البلاغة على غرار بناء النحو علم بمقاييس كلام العرب
وسبيله استقراء نصوص العرب
وبراهينه شواهد عصر الاحتجاج
بدلا من تعريفه تعريفا عاما يشمل بلاغة الأمم جميعا ثم يكون مضمونه أوفى لبلاغة اليونان منه لبلاغة العرب
وبدلا من التسوية بين شواهد الجاهليين وشواهد المولدين ثم يكون أغلب ذكرهم للمولدين
وتكون غايته اتباع المتكلم سبيل العرب في الكلام
وفهم خطاب القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الاحتجاج لصحة القرآن وفصاحته ومساعدة المتكلم على حسن البيان تبعا وضمناً
بدلا من أن تكون غايته إثبات الإعجاز او إثبات نظرية معينة ضمن الجدل الكلامي او مساعدة المتأدبين أصالة .
وماذا لو كانت للبلاغة مدارس كمدارس النحو والفقه تحافظ كل مدرسة على خصوصيات من دقيق العلم وتتضح أصول كل مدرسة وفروعها
وماذا لو نشأ علم البلاغة مع علم النحو بين القراء والأعراب والشعراء الفحول في القرن الأول للهجرة وفي حواضر العرب وبواديهم بدلا من نشأته في القرن الثالث أوالخامس أوالسادس بعد أن انطفأت أنوار السليقة العربية
يتمنى الإنسان لو كانت البلاغة فعلاً تأثرت بالنحو
وسبيله استقراء نصوص العرب
وبراهينه شواهد عصر الاحتجاج
بدلا من تعريفه تعريفا عاما يشمل بلاغة الأمم جميعا ثم يكون مضمونه أوفى لبلاغة اليونان منه لبلاغة العرب
وبدلا من التسوية بين شواهد الجاهليين وشواهد المولدين ثم يكون أغلب ذكرهم للمولدين
وتكون غايته اتباع المتكلم سبيل العرب في الكلام
وفهم خطاب القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الاحتجاج لصحة القرآن وفصاحته ومساعدة المتكلم على حسن البيان تبعا وضمناً
بدلا من أن تكون غايته إثبات الإعجاز او إثبات نظرية معينة ضمن الجدل الكلامي او مساعدة المتأدبين أصالة .
وماذا لو كانت للبلاغة مدارس كمدارس النحو والفقه تحافظ كل مدرسة على خصوصيات من دقيق العلم وتتضح أصول كل مدرسة وفروعها
وماذا لو نشأ علم البلاغة مع علم النحو بين القراء والأعراب والشعراء الفحول في القرن الأول للهجرة وفي حواضر العرب وبواديهم بدلا من نشأته في القرن الثالث أوالخامس أوالسادس بعد أن انطفأت أنوار السليقة العربية
يتمنى الإنسان لو كانت البلاغة فعلاً تأثرت بالنحو
روى ابن فارس رحمه الله عن أبيه: قيل لأعرابي ما القلم ؟
فقال لا أدري
فقيل له : توهمه،
فقال : هو عود قُلّم من جانبيه كتقليم الأظفور فسمّي قلماً
وهذا الحس المرهف بدلالة الحروف والأصوات على المعاني وطبيعة العرب في تسمية الأشياءيحصل للإنسان بالاكتساب وليس حكرا على الأعراب
قال ابن جني : ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه ، وآخذ معناه من قوة لفظه ، ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشف فأجده كما فهمته أو قريبا منه
قال ابن القيم فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني فقال وأنا كثيراً ما يجري لي ذلك
فقال لا أدري
فقيل له : توهمه،
فقال : هو عود قُلّم من جانبيه كتقليم الأظفور فسمّي قلماً
وهذا الحس المرهف بدلالة الحروف والأصوات على المعاني وطبيعة العرب في تسمية الأشياءيحصل للإنسان بالاكتساب وليس حكرا على الأعراب
قال ابن جني : ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه ، وآخذ معناه من قوة لفظه ، ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشف فأجده كما فهمته أو قريبا منه
قال ابن القيم فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني فقال وأنا كثيراً ما يجري لي ذلك
" لم يكن ضيقي حين كلفتني كلية الآداب تدريس مادة البلاغة بأقلّ من سروري بذلك التكليف، فقد سررت لأن هذا التكليف جاء منسجماً مع ما في نفسي من تقدير للبلاغة العربية، وأما ضيقي فللفكرة التي رسبت في أذهان طلابنا وناشئتنا عن البلاغة العربية .
ولست أكتم أنني لاقيت الكثير من العنت حتى استطعت _ إلى حد ما _ أن أقتلع من أذهان الطلاب ما استقر فيها من أن البلاغة مادة متحفية وأن دراستها اليوم والرجوع إليها لا يعني أكثر من جولة بين الآثار القديمة أو وقفة بين الأطلال "
مازن المبارك
ولست أكتم أنني لاقيت الكثير من العنت حتى استطعت _ إلى حد ما _ أن أقتلع من أذهان الطلاب ما استقر فيها من أن البلاغة مادة متحفية وأن دراستها اليوم والرجوع إليها لا يعني أكثر من جولة بين الآثار القديمة أو وقفة بين الأطلال "
مازن المبارك
مقولة الجاحظ (والمعاني مطروحة على الطريق
يعرفها العربي والأعجمي... وإنما الشأن في حسن الصياغة وجودة السبك وكثرة الماء ...)
يمكن صرفها إلى طائفة من المعاني مطروحة فعلا
على الطرقات وذلك مثل تشبيه الكريم بالبحر والجميل بالبدر والافتخار بالكرم والشجاعة والهجاء بالبخل والوضاعة ونحو ذلك مما نجده في كلام العوام
وثمت معان أخرى ليست مباحة ولا متاحة لكل أحد
والسبب في تعميم مقولة الجاحظ وانتقاص قدر المعاني أمران :
الأول هو النظرة الكلية المنطقية فمن نظر إلى المدح مثلا عند الشعراء والخطباء والعرب والعجم وجده يرجع إلى معان محصورة تتكرر بأشكال مختلفة لقصور النظر الكلي عن إدراك التفاصيل المؤثرة وهذه آفة منطقية لا تختص بهذا المقام
والثاني هو اقتصار النقاد على دراسة الشعر ، ومعاني
الشعر ليست مثل معاني الكتب الإلهية وكتب الحكمة وخطب خطباء العرب والعجم
يقول الفراهي رحمه الله: وأما البلاغة فاستخرجوها من أشعار العرب، والأشعار لضيق مجالها كانت مقتصرة على جودة السبك ورشاقة اللفظ والبديع
أما حسن الاستدلال ورباط المعاني وضرب الأمثال
والاعتبار من القصص وجر الكلام ثم العود الى عموده والوعد والزجر والتأكيد بشدة يقين المتكلم
والإعراض إعراض المترفع ، والحسرة حسرة المعلم الناصح وغير ذلك مما يوجد في خطبات البلغاء ووحي الأنبياء فما ذكروه في علم البلاغة
لأنهم فاتتهم خطبات العرب وما نظروا في خطبات العجم ".
وهذا رأي أبي موسى في كلمة الجاحظ :
"ولابد أن نفرق بين ما اتفق عليه أهل العلم بالشعر من أن المعاني لا مدخل لها في فضل كلام على كلام ، وأن المهم هو التأليف والتصوير ، وإحداث هيئات وصور في تلك المعاني على حد ما هو معروف ، وأن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والبدوي، لابد أن نفرق بين هذا وبين ما نحن فيه ، لأنه لا يجوز لمن له عقل أن يقول في الإعجاز إن المعاني مطروحة في الطريق لأن معاني القرآن داخلة في وجوه إعجازه وهي جزء من آياته البينات ...
لا شك في أن معاني القرآن من أبرز وجوه إعجازه وإنما تجاوزها عبد القاهر في هذا النص وفي غيره لأن الله سبحانه و تعالى لما طلب منهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله خفف عنهم وقبل منهم المماثلة في أي باب من أبواب المعاني يشاؤون وليس في معانيه لأن هذا تشديد عليهم في التحدي وكانوا قد راضوا بيانهم على أبواب من أبواب المعاني برعوا فيها ...
لأن التحدي لا يكون إلا فيما برع فيه القوم ولم يتحد نبي قومه بباب من أبواب العلم لم يبلغوا فيه الغاية ".
والمعاني التي يقصدها أبو موسى ويعلل تجاوز الاهتمام البلاغي بها غير التي يستدركها الفراهي
فالمعاني التي يقصدها هي معاني الهدى والنور وهي داخلة في إعجاز القرآن بلا خلاف
أما المعاني التي يستدركها الفراهي فلا تتعلق بصحة المعنى من عدمه بل تتعلق ببيان بليغ وأساليب بديعة مختلفة عن أساليب الشعر وبيانه ويقع الإعجاز للعرب لمعرفتهم بها عن طريق الخطب النثرية وغيرها
وعلى هذا فالمعاني التي لم تدرسها البلاغة التقليدية نوعان .
يعرفها العربي والأعجمي... وإنما الشأن في حسن الصياغة وجودة السبك وكثرة الماء ...)
يمكن صرفها إلى طائفة من المعاني مطروحة فعلا
على الطرقات وذلك مثل تشبيه الكريم بالبحر والجميل بالبدر والافتخار بالكرم والشجاعة والهجاء بالبخل والوضاعة ونحو ذلك مما نجده في كلام العوام
وثمت معان أخرى ليست مباحة ولا متاحة لكل أحد
والسبب في تعميم مقولة الجاحظ وانتقاص قدر المعاني أمران :
الأول هو النظرة الكلية المنطقية فمن نظر إلى المدح مثلا عند الشعراء والخطباء والعرب والعجم وجده يرجع إلى معان محصورة تتكرر بأشكال مختلفة لقصور النظر الكلي عن إدراك التفاصيل المؤثرة وهذه آفة منطقية لا تختص بهذا المقام
والثاني هو اقتصار النقاد على دراسة الشعر ، ومعاني
الشعر ليست مثل معاني الكتب الإلهية وكتب الحكمة وخطب خطباء العرب والعجم
يقول الفراهي رحمه الله: وأما البلاغة فاستخرجوها من أشعار العرب، والأشعار لضيق مجالها كانت مقتصرة على جودة السبك ورشاقة اللفظ والبديع
أما حسن الاستدلال ورباط المعاني وضرب الأمثال
والاعتبار من القصص وجر الكلام ثم العود الى عموده والوعد والزجر والتأكيد بشدة يقين المتكلم
والإعراض إعراض المترفع ، والحسرة حسرة المعلم الناصح وغير ذلك مما يوجد في خطبات البلغاء ووحي الأنبياء فما ذكروه في علم البلاغة
لأنهم فاتتهم خطبات العرب وما نظروا في خطبات العجم ".
وهذا رأي أبي موسى في كلمة الجاحظ :
"ولابد أن نفرق بين ما اتفق عليه أهل العلم بالشعر من أن المعاني لا مدخل لها في فضل كلام على كلام ، وأن المهم هو التأليف والتصوير ، وإحداث هيئات وصور في تلك المعاني على حد ما هو معروف ، وأن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والبدوي، لابد أن نفرق بين هذا وبين ما نحن فيه ، لأنه لا يجوز لمن له عقل أن يقول في الإعجاز إن المعاني مطروحة في الطريق لأن معاني القرآن داخلة في وجوه إعجازه وهي جزء من آياته البينات ...
لا شك في أن معاني القرآن من أبرز وجوه إعجازه وإنما تجاوزها عبد القاهر في هذا النص وفي غيره لأن الله سبحانه و تعالى لما طلب منهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله خفف عنهم وقبل منهم المماثلة في أي باب من أبواب المعاني يشاؤون وليس في معانيه لأن هذا تشديد عليهم في التحدي وكانوا قد راضوا بيانهم على أبواب من أبواب المعاني برعوا فيها ...
لأن التحدي لا يكون إلا فيما برع فيه القوم ولم يتحد نبي قومه بباب من أبواب العلم لم يبلغوا فيه الغاية ".
والمعاني التي يقصدها أبو موسى ويعلل تجاوز الاهتمام البلاغي بها غير التي يستدركها الفراهي
فالمعاني التي يقصدها هي معاني الهدى والنور وهي داخلة في إعجاز القرآن بلا خلاف
أما المعاني التي يستدركها الفراهي فلا تتعلق بصحة المعنى من عدمه بل تتعلق ببيان بليغ وأساليب بديعة مختلفة عن أساليب الشعر وبيانه ويقع الإعجاز للعرب لمعرفتهم بها عن طريق الخطب النثرية وغيرها
وعلى هذا فالمعاني التي لم تدرسها البلاغة التقليدية نوعان .
تقول ريطة أخت عمرو ذي الكلب ترثي أخاها :
أبلغ هذيلاً وبلّغ من يبلّغها
عني حديثاً وبعض القول تكذيب
بأن ذا الكلب عمراً خيرهم حسباً
ببطن شريان يعوي عنده الذيب
تمشي النسور إليه وهي لاهيةٌ
مشي العذارى عليهن الجلابيب
أفردت الذئب وجمعت النسور والعذارى لأن غرضها من ذكر الذئب التفظيع وبيان مصرع أخيها بمكان قفر لا أنيس فيه إلا الذئب وعواءه فناسب ذكر الذئب الوحيد .
أما غرضها من ذكر النسور فهو بيان استسلام أخيها وعدم امتناعه بنفسه أو بقومه ممن أراد به الشر ولذلك ذكرت في صفة النسور اللهو وشبهت مشيهن بمشي العذارى المتجلببات أي أن النسور لا تبالي وهي تقترب من أخيها وذكر النسور يكفي في بيان هذا المعنى لأنها لا تأكل إلا الجيف أما الضباع فقد تقتل الأحياء وقد تجهز على الجرحى.
وهذان المعنيان معنى مقتل أخيها في مكان قفر ومعنى أكل النسور أشلاءه مناسبان لاستصراخ العشيرة فالأول دال على أن القوم تركوه في مكان موحش وهذا يحتمل الموت والدفن في قبر كما يحتمل القتل فأزالت هذا الاحتمال بالبيت الثاني وبينت أن أخاها قُتل ولم يدفن .
وقد ذكرت الشاعرة مشهد مشي النسور دون مشهد أكل الميت لسببين :
الأول عادة العرب في الكناية والتعبير بالشيء عن لازمه في مقامات التهويل .
والثاني دلالة مشي النسور على استسلام الميت وهذا غرضها من البيت بيان هوان أخيها لا التوجع لما أصاب جثمانه
يقول النابغة في وصف جيش ملك غسان :
إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم
عصائب طير تهتدي بعصائب
ففي بيان شجاعة جيش الملك وانتصاراته المتكررة ذكر طيران النسور وذلك أدل على طمعها وعلى معرفتها بعادة الملك في الحروب
أما في الرثاء وبيان استسلام الميت فناسب ذكر المشي والنسر أضعف ما يكون وهو يمشي فدل مشيه على تهاونه وأمنه كما دل تحليقه على طمعه وحرصه .
واختارت العذارى في التشبيه لغلبة الحياء عليهن مما يؤثر في قوة السير فيجعل مشيهن متكسراً متمهلاً ودل ذكر الجلابيب على زيادة في صفة الحياء.
أحسن الله خاتمتنا ووالدينا والمسلمين
أبلغ هذيلاً وبلّغ من يبلّغها
عني حديثاً وبعض القول تكذيب
بأن ذا الكلب عمراً خيرهم حسباً
ببطن شريان يعوي عنده الذيب
تمشي النسور إليه وهي لاهيةٌ
مشي العذارى عليهن الجلابيب
أفردت الذئب وجمعت النسور والعذارى لأن غرضها من ذكر الذئب التفظيع وبيان مصرع أخيها بمكان قفر لا أنيس فيه إلا الذئب وعواءه فناسب ذكر الذئب الوحيد .
أما غرضها من ذكر النسور فهو بيان استسلام أخيها وعدم امتناعه بنفسه أو بقومه ممن أراد به الشر ولذلك ذكرت في صفة النسور اللهو وشبهت مشيهن بمشي العذارى المتجلببات أي أن النسور لا تبالي وهي تقترب من أخيها وذكر النسور يكفي في بيان هذا المعنى لأنها لا تأكل إلا الجيف أما الضباع فقد تقتل الأحياء وقد تجهز على الجرحى.
وهذان المعنيان معنى مقتل أخيها في مكان قفر ومعنى أكل النسور أشلاءه مناسبان لاستصراخ العشيرة فالأول دال على أن القوم تركوه في مكان موحش وهذا يحتمل الموت والدفن في قبر كما يحتمل القتل فأزالت هذا الاحتمال بالبيت الثاني وبينت أن أخاها قُتل ولم يدفن .
وقد ذكرت الشاعرة مشهد مشي النسور دون مشهد أكل الميت لسببين :
الأول عادة العرب في الكناية والتعبير بالشيء عن لازمه في مقامات التهويل .
والثاني دلالة مشي النسور على استسلام الميت وهذا غرضها من البيت بيان هوان أخيها لا التوجع لما أصاب جثمانه
يقول النابغة في وصف جيش ملك غسان :
إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم
عصائب طير تهتدي بعصائب
ففي بيان شجاعة جيش الملك وانتصاراته المتكررة ذكر طيران النسور وذلك أدل على طمعها وعلى معرفتها بعادة الملك في الحروب
أما في الرثاء وبيان استسلام الميت فناسب ذكر المشي والنسر أضعف ما يكون وهو يمشي فدل مشيه على تهاونه وأمنه كما دل تحليقه على طمعه وحرصه .
واختارت العذارى في التشبيه لغلبة الحياء عليهن مما يؤثر في قوة السير فيجعل مشيهن متكسراً متمهلاً ودل ذكر الجلابيب على زيادة في صفة الحياء.
أحسن الله خاتمتنا ووالدينا والمسلمين
التأثير المحتمل لبلاغة العرب على اللسانيات
"تشومسكي قد صرح بأنه قبل أن يبدأ دراسة اللسانيات العامة كان مشغولاً ببعض الأبحاث التي تدور حول اللسانيات السامية "
محمد عبد المطلب البلاغة العربية قراءة أخرى
"تشومسكي قد صرح بأنه قبل أن يبدأ دراسة اللسانيات العامة كان مشغولاً ببعض الأبحاث التي تدور حول اللسانيات السامية "
محمد عبد المطلب البلاغة العربية قراءة أخرى
Forwarded from مركز تفسير للدراسات القرآنية
يتناول هذا البحث مفهوم منهج البلاغة الساميّة في دراسة بنية القرآن الكريم عند ميشيل كويبرس، ومصادره، والأسس النظرية والمنهجية التي يقوم عليها، وأهميته في حل إشكال بنية القرآن الكريم، ويقدم جملة من الملاحظات التقييمية لهذا المنهج.
tafsir.net/research/41
#مركز_تفسير
tafsir.net/research/41
#مركز_تفسير
" إن بين منهج دراسة نظام القرآن عند الفراهي ودراسة بنية القرآن من منظور البلاغة السامية عند كويبرس تقارباً كبيراً لا يقتصر على المفهوم فحسب وإنما يشمل الأسس النظرية والمنهجية والنتائج المتوخاة من وراء دراسة نظام القرآن وبنيته "
محمد المجود
محمد المجود
"النحو من أكثر العلوم إمتاعاً لمن أخذه بعلله وأسراره لأنه علم يخاطب العقل والذوق معاً ...
وحقيق أن يعيب البلاغة من لا يعرف غير التلخيص والإيضاح وذلك أن من انتهى إليها وجعلها غايته في تحصيل العلم أورثته ضيقاً في النظر وكلالاً في الحد ووهناً في الملكة بما حُرم من التفرج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن لذة الاطلاع على اختلاف مشاربها ومساربها ومن متعة التكشيف عن أصولها والامتحان لعللها والمراجعة لأحكامها وذلك لما يغلب عليها من شدة الإيجاز والمبالغة في الاختزال والإهمال لذكر الخلاف والإسقاط للعلل"
فيصل المنصور
وحقيق أن يعيب البلاغة من لا يعرف غير التلخيص والإيضاح وذلك أن من انتهى إليها وجعلها غايته في تحصيل العلم أورثته ضيقاً في النظر وكلالاً في الحد ووهناً في الملكة بما حُرم من التفرج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن لذة الاطلاع على اختلاف مشاربها ومساربها ومن متعة التكشيف عن أصولها والامتحان لعللها والمراجعة لأحكامها وذلك لما يغلب عليها من شدة الإيجاز والمبالغة في الاختزال والإهمال لذكر الخلاف والإسقاط للعلل"
فيصل المنصور
" وقد حد الناس البلاغة بحدود إذا حققت كانت كالرسوم والعلائم وليست بالحدود الصحيحة "
ابن سنان الخفاجي
ابن سنان الخفاجي
مراعاة أول ما نزل في التحليل البلاغي
" قوله تعالى(( اقرأ باسم ربك الذي خلق .خلق الإنسان من علق .اقرأ وربك الأكرم .الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم ))
في هذه الآيات الخمس تسع مسائل مرتبط بعضها ببعض ارتباط السبب بالمسبب والعامّ بالخاص والدليل بالمدلول عليه ...
وقد قال عنها ابن تيمية: إنها وأمثالها من السور التي فيها العجائب ، وذلك لما جاء فيها من التأسيس لافتتاحية تلك الرسالة العظيمة ..
وقد كتب فيها شيخ الإسلام بأسلوبه مائتين وعشرين صفحة متتالية
قال ابن تيمية: إن المقام هنا مقام دلالة على وجود الله فبدأ بما يعرفونه ويسلمون به لله ، ولم يبدأ من النطفة أو التراب لأن خلق آدم من تراب لم يشاهدوه ، ولأن النطفة ليست بلازم لها خلق الإنسان فقد تقذف في غير رحم كالمحتلم وقد تكون فيه ولا تكون مخلقة "
الشيخ عطية سالم
واعتبر الشيخ عطية المقام مقام إثبات للوحي والاستدلال بالخلق عليه
" وجملة (( خلق الإنسان من علق )) يجوز أن تكون بدلاً من جملة (( الذي خلق )) .. وسُلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداءً لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملّة الإسلام
ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل "
ابن عاشور
" قوله تعالى(( اقرأ باسم ربك الذي خلق .خلق الإنسان من علق .اقرأ وربك الأكرم .الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم ))
في هذه الآيات الخمس تسع مسائل مرتبط بعضها ببعض ارتباط السبب بالمسبب والعامّ بالخاص والدليل بالمدلول عليه ...
وقد قال عنها ابن تيمية: إنها وأمثالها من السور التي فيها العجائب ، وذلك لما جاء فيها من التأسيس لافتتاحية تلك الرسالة العظيمة ..
وقد كتب فيها شيخ الإسلام بأسلوبه مائتين وعشرين صفحة متتالية
قال ابن تيمية: إن المقام هنا مقام دلالة على وجود الله فبدأ بما يعرفونه ويسلمون به لله ، ولم يبدأ من النطفة أو التراب لأن خلق آدم من تراب لم يشاهدوه ، ولأن النطفة ليست بلازم لها خلق الإنسان فقد تقذف في غير رحم كالمحتلم وقد تكون فيه ولا تكون مخلقة "
الشيخ عطية سالم
واعتبر الشيخ عطية المقام مقام إثبات للوحي والاستدلال بالخلق عليه
" وجملة (( خلق الإنسان من علق )) يجوز أن تكون بدلاً من جملة (( الذي خلق )) .. وسُلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداءً لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملّة الإسلام
ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل "
ابن عاشور