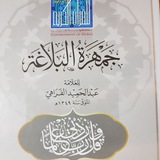عندما توفي الملك فيصل ملك العراق وتولى بعده ابنه الملك غازي أنشد معروف الرصافي قصيدة في مدح الملك الجديد أولها :
أبو غازي قضى فأقيم غازي
فأنطقنا التهاني والتعازي
واعتبر المطلع تهكمياً لكونه قدّم التهاني بوفاة الملك فيصل والتعازي بتولي ابنه وكان المفترض أن يوافق ترتيب التهنئة والتعزية في القصيدة ترتيبهما في الوجود .
ومعروف الرصافي معارض ساخر مما ساعد على هذا التأويل ، وإلا فالواو لا تقتضي الترتيب بالضرورة ، وإن كانت ترجحه.
أبو غازي قضى فأقيم غازي
فأنطقنا التهاني والتعازي
واعتبر المطلع تهكمياً لكونه قدّم التهاني بوفاة الملك فيصل والتعازي بتولي ابنه وكان المفترض أن يوافق ترتيب التهنئة والتعزية في القصيدة ترتيبهما في الوجود .
ومعروف الرصافي معارض ساخر مما ساعد على هذا التأويل ، وإلا فالواو لا تقتضي الترتيب بالضرورة ، وإن كانت ترجحه.
#معايير_بلاغية
الأصمعي بنى كلامه في كتاب فحولة الشعراء على أساس السبق إلى المعنى ولعل هذا هو معنى الفحل عنده فإن السابق إلى المعنى غالب عليه لا يستطيع أحد بعده أن ينازعه فيه .
يدل على ذلك تعليله تقديم امرئ القيس بكونه أسبق الناس إلى المعاني .
ثم مدحه لجرير بقوله له ثلاثون قصيدة لم يسرق فيها شيئا إلا نصف بيت .
وقوله عن الفرزدق تسعة أعشار شعره سرقة وأمثال هذا من التعليل .
وبذلك ينحل إشكال موقف الأصمعي من امرئ القيس والنابغة حيث قدم النابغة أولاً ثم استدرك وقدم امرأالقيس فالنابغة أجود شعراً وهذه الجودة لا يمكن اعتبارها في ترتيب الشعراء لتعدد ظروف الشعراء واعتبارات التفضيل فلابد من معيار واضح يتم التحاكم إليه وهو السبق إلى المعنى .
الأصمعي بنى كلامه في كتاب فحولة الشعراء على أساس السبق إلى المعنى ولعل هذا هو معنى الفحل عنده فإن السابق إلى المعنى غالب عليه لا يستطيع أحد بعده أن ينازعه فيه .
يدل على ذلك تعليله تقديم امرئ القيس بكونه أسبق الناس إلى المعاني .
ثم مدحه لجرير بقوله له ثلاثون قصيدة لم يسرق فيها شيئا إلا نصف بيت .
وقوله عن الفرزدق تسعة أعشار شعره سرقة وأمثال هذا من التعليل .
وبذلك ينحل إشكال موقف الأصمعي من امرئ القيس والنابغة حيث قدم النابغة أولاً ثم استدرك وقدم امرأالقيس فالنابغة أجود شعراً وهذه الجودة لا يمكن اعتبارها في ترتيب الشعراء لتعدد ظروف الشعراء واعتبارات التفضيل فلابد من معيار واضح يتم التحاكم إليه وهو السبق إلى المعنى .
تعليقاً على قول البلاغيين
( كلما ازداد التشبيه خفاءاً زادت الاستعارة حسناً )
قال ابن عميرة:
"ذكر الخفاء هنا مضلِّلٌ وموهمٌ أن إبعاده من الأفهام يفيده حسناً ويزيده قبولاً وليس كذلك بل الأمر بالضد كلما كان أوضح وأبين كان أجود وأحسن،"
وقال الفراهي
" المذهب الباطل في التشبيه :
اعلم أن المولدين زعموا أن الندرة والبعد في التشبيه من محاسنه ..وأتوا بتشبيهات رديئة سخيفة " بتصرف يسير
وهو كذلك مذهب الرماني في اشتراط الوضوح في التشبيه وهو خلاف المشهور في البلاغة .
والسبب في إنكار الفراهي غرابة التشبيه -والله أعلم- أنه يرى للتشبيه ثلاثة بواعث :
١_حرص الناطق على إظهار ضميره
٢_والتأثير في السامع وتحريكه
٣_وتقرير الأدلة عن طريق قياس المشبه على المشبه به وتصوير المعاني العقلية محسوسة.
وكل هذه البواعث تتجلى في التشبيه الواضح ويعوقها ويبعدها عن غايتها التشبيه النادر والغريب وإن أمتع الأسماع مؤقتاً لطرافته .
( كلما ازداد التشبيه خفاءاً زادت الاستعارة حسناً )
قال ابن عميرة:
"ذكر الخفاء هنا مضلِّلٌ وموهمٌ أن إبعاده من الأفهام يفيده حسناً ويزيده قبولاً وليس كذلك بل الأمر بالضد كلما كان أوضح وأبين كان أجود وأحسن،"
وقال الفراهي
" المذهب الباطل في التشبيه :
اعلم أن المولدين زعموا أن الندرة والبعد في التشبيه من محاسنه ..وأتوا بتشبيهات رديئة سخيفة " بتصرف يسير
وهو كذلك مذهب الرماني في اشتراط الوضوح في التشبيه وهو خلاف المشهور في البلاغة .
والسبب في إنكار الفراهي غرابة التشبيه -والله أعلم- أنه يرى للتشبيه ثلاثة بواعث :
١_حرص الناطق على إظهار ضميره
٢_والتأثير في السامع وتحريكه
٣_وتقرير الأدلة عن طريق قياس المشبه على المشبه به وتصوير المعاني العقلية محسوسة.
وكل هذه البواعث تتجلى في التشبيه الواضح ويعوقها ويبعدها عن غايتها التشبيه النادر والغريب وإن أمتع الأسماع مؤقتاً لطرافته .
" حينما كنت مسيحياً كنت أقول كما كان يقول عمٌّ لي متعلم بليغ ، بأن أسلوب القرآن ليس معجزاً ، وليس من علامات النبوة ، لأنه في استطاعة الناس كلهم ، ولكن عندما حاولت تقليده واطلعت على مدلول كلماته ، علمت أن أبناء القرآن على حق فيما يدعونه له ، لأني لم أطلع على كتاب يأمر بالخير وينهى عن الشر كالقرآن.
فعندما يحمل لنا شخص كتاباً يحمل نفس الميزات ويوحي إلينا بهذه الطلاوة، وتلك الروعة في القلوب، ويحوز مثل هذا النجاح، ويكون في مثل هذا الوقت أمياً لم يتعلم أبدا فني الكتابة والبلاغة فهذا الكتاب يكون بلا شك من علامات النبوة "
العلامة الطبيب علي بن ربّن الطبري رحمه الله.
في هذا النص يذكر الطبري أن معرفته مدلول كلمات القرآن هو ما جعله يبصر إعجازه ويدرك بلاغته
وهذا يمكن فهمه على أن الطبري يقول بأن البلاغة في المعنى لا النظم وهو الظاهر .
ويمكن فهمه على أن من شرط إدراك بلاغة النظم معرفة المعنى .
ولا ينقضي العجب ممن يجادل في بلاغة القرآن وهو في معزل عن إدراك معانيه ومناهج التأويل والنظر فيه .
وبعض البلاغيين قد يبني تحليله البلاغي على قول واحد دون غيره من أقوال المفسرين ، وقد يكون قولاً مرجوحاً.
هذا فضلا عن أن النظر الكلي للسورة القرآنية والذي تتبين به معانيها شبه غائب عن دراسات البلاغيين .
ولعل إدراك قريش بلاغة القرآن يرجع إلى معرفتهم معانيه أكثر مما يرجع إلى معرفتهم بلاغة العرب وأساليبهم وإن كان الأمران لابد منهما .
فعندما يحمل لنا شخص كتاباً يحمل نفس الميزات ويوحي إلينا بهذه الطلاوة، وتلك الروعة في القلوب، ويحوز مثل هذا النجاح، ويكون في مثل هذا الوقت أمياً لم يتعلم أبدا فني الكتابة والبلاغة فهذا الكتاب يكون بلا شك من علامات النبوة "
العلامة الطبيب علي بن ربّن الطبري رحمه الله.
في هذا النص يذكر الطبري أن معرفته مدلول كلمات القرآن هو ما جعله يبصر إعجازه ويدرك بلاغته
وهذا يمكن فهمه على أن الطبري يقول بأن البلاغة في المعنى لا النظم وهو الظاهر .
ويمكن فهمه على أن من شرط إدراك بلاغة النظم معرفة المعنى .
ولا ينقضي العجب ممن يجادل في بلاغة القرآن وهو في معزل عن إدراك معانيه ومناهج التأويل والنظر فيه .
وبعض البلاغيين قد يبني تحليله البلاغي على قول واحد دون غيره من أقوال المفسرين ، وقد يكون قولاً مرجوحاً.
هذا فضلا عن أن النظر الكلي للسورة القرآنية والذي تتبين به معانيها شبه غائب عن دراسات البلاغيين .
ولعل إدراك قريش بلاغة القرآن يرجع إلى معرفتهم معانيه أكثر مما يرجع إلى معرفتهم بلاغة العرب وأساليبهم وإن كان الأمران لابد منهما .
الشعر الجاهلي 🍃
من أسباب جودة أشعار الجاهلية وتفضيلها على ما بعدها :
كون العرب أمة أمية لا تكتب _ غالباً_ وهذا منعهم من حفظ ما لا يستحق فلا يبقى في الذاكرة إلا الجزل البليغ ولا يٌنقل إلينا إلا المنتخب النفيس
وهذا له أثر مرة أخرى على جودة ما ينشدونه فإذا لم يحفظوا إلا الجيد لم يؤلفوا إلا الجيد .
ثم علو قدر الشعر في الجاهلية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الشعر كان علم قوم لم يكن لهم علم غيره .
وشعراء الجاهلية هم أشراف القبائل وفرسانها بخلاف العصور اللاحقة
وكذلك شعر الجاهليين كان في الأمور المهمة والخطوب الداهمة كتهديد العدو والإصلاح بين المتحاربين والاعتذار والافتخار والرثاء
ولم يظهر في الجاهلية الغزل والهجاء كما ظهر في عصر بني أمية وما بعده بل كان الغزل مقصودا به غيره في شعرهم والهجاء كان نادراً وأغلبه يرجع إلى التهديد بالحرب .
أما هجاء العصر الأموي فغالبه لهو وفراغ وقلة مروءة وتأمل أشهر متهاجيين في ذلك العصر جريراً والفرزدق تجد عجباً
كلاهما من تميم وليس بين قومهما حرب ولا أثمر الهجاء بينهما حرباً ولما مات الفرزدق رثاه جرير
ولما فضل الراعي النميري والأخطل التغلبي الفرزدق على جرير أدخلهما جرير في الهجاء
فهجاء هذا أسبابه وتلك نهايته يكون بعيداً عن صدق الشعور وإن كان أبلغ من هجاء الجاهليين في النظر الجزئي.
مما يعني أن الشعر عموماً والهجاء خصوصاً أصبح
حرفة للشاعر معزولة عن معانيها و مقاصدها الأولى.
وأهم مما مضى في جودة أشعار الجاهلية هو السلامة النفسية واللغوية والعقلية فعرب الجاهلية لم يظهر فيهم اللحن الفاحش والسجع المتكلف ولم تظهر فيهم الوساوس والمذاهب الكلامية .
وكذلك التطور الدلالي للمفردات كان أقل في زمنهم فالصلاة والزكاة مثلا يحتفظان بمعنى الدعاء والنماء في لغة الجاهلية وصدر الإسلام وإن قصد بهما المعنى الاصطلاحي إلا أن ذلك لا يقطع الصلة بالأصل فأسباب اختيار الألفاظ عندهم ترجع للاشتقاق والمعهود أما عند اللاحقين فهي من المعهود فقط غالباً .
وهذا ألقى بظلاله على لغة الشعر وموازين النقد فغدا الشعر الجاهلي مثالاً يقتفى أثره وميزاناً يحتكم إليه وصار التعليل بما يوافق ذوقهم واختياراتهم يقوم مقام الدليل ولا يٌنظر في ما وراءه .
من أسباب جودة أشعار الجاهلية وتفضيلها على ما بعدها :
كون العرب أمة أمية لا تكتب _ غالباً_ وهذا منعهم من حفظ ما لا يستحق فلا يبقى في الذاكرة إلا الجزل البليغ ولا يٌنقل إلينا إلا المنتخب النفيس
وهذا له أثر مرة أخرى على جودة ما ينشدونه فإذا لم يحفظوا إلا الجيد لم يؤلفوا إلا الجيد .
ثم علو قدر الشعر في الجاهلية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الشعر كان علم قوم لم يكن لهم علم غيره .
وشعراء الجاهلية هم أشراف القبائل وفرسانها بخلاف العصور اللاحقة
وكذلك شعر الجاهليين كان في الأمور المهمة والخطوب الداهمة كتهديد العدو والإصلاح بين المتحاربين والاعتذار والافتخار والرثاء
ولم يظهر في الجاهلية الغزل والهجاء كما ظهر في عصر بني أمية وما بعده بل كان الغزل مقصودا به غيره في شعرهم والهجاء كان نادراً وأغلبه يرجع إلى التهديد بالحرب .
أما هجاء العصر الأموي فغالبه لهو وفراغ وقلة مروءة وتأمل أشهر متهاجيين في ذلك العصر جريراً والفرزدق تجد عجباً
كلاهما من تميم وليس بين قومهما حرب ولا أثمر الهجاء بينهما حرباً ولما مات الفرزدق رثاه جرير
ولما فضل الراعي النميري والأخطل التغلبي الفرزدق على جرير أدخلهما جرير في الهجاء
فهجاء هذا أسبابه وتلك نهايته يكون بعيداً عن صدق الشعور وإن كان أبلغ من هجاء الجاهليين في النظر الجزئي.
مما يعني أن الشعر عموماً والهجاء خصوصاً أصبح
حرفة للشاعر معزولة عن معانيها و مقاصدها الأولى.
وأهم مما مضى في جودة أشعار الجاهلية هو السلامة النفسية واللغوية والعقلية فعرب الجاهلية لم يظهر فيهم اللحن الفاحش والسجع المتكلف ولم تظهر فيهم الوساوس والمذاهب الكلامية .
وكذلك التطور الدلالي للمفردات كان أقل في زمنهم فالصلاة والزكاة مثلا يحتفظان بمعنى الدعاء والنماء في لغة الجاهلية وصدر الإسلام وإن قصد بهما المعنى الاصطلاحي إلا أن ذلك لا يقطع الصلة بالأصل فأسباب اختيار الألفاظ عندهم ترجع للاشتقاق والمعهود أما عند اللاحقين فهي من المعهود فقط غالباً .
وهذا ألقى بظلاله على لغة الشعر وموازين النقد فغدا الشعر الجاهلي مثالاً يقتفى أثره وميزاناً يحتكم إليه وصار التعليل بما يوافق ذوقهم واختياراتهم يقوم مقام الدليل ولا يٌنظر في ما وراءه .
ذهب الدكتور أحمد أبو زيد إلى أن هناك نظريتي نظم واحدة معتزلية وأخرى أشعرية .
ويقول الدكتور أبو موسى:
" يظهر أن عبد القاهر كان بين سلف معتزلي هو الجاحظ وخلف معتزلي موغل هو الزمخشري ، ولذلك أتردد كثيراً في قبول من يرجعون الخلافات العلمية غير الداخلة في مسائل الخلاف عند الفرق إلى اختلاف المذاهب لأني رأيت الكل يأخذ عن الكل والكل يرد على الكل"
الجاحظ صورته الأدبية تطغى على صورته العقدية فلا ينحصر الأخذ منه في المعتزلة .
والزمخشري مشهور أنه طبق نظرية النظم في الكشاف مع أنه لم يذكر عبد القاهر إلا مرة واحدة .
ولو صح وجود نظريتين فهذا أثرى للدرس البلاغي من اعتبار الكل مدرسة واحدة .
ويقول الدكتور أبو موسى:
" يظهر أن عبد القاهر كان بين سلف معتزلي هو الجاحظ وخلف معتزلي موغل هو الزمخشري ، ولذلك أتردد كثيراً في قبول من يرجعون الخلافات العلمية غير الداخلة في مسائل الخلاف عند الفرق إلى اختلاف المذاهب لأني رأيت الكل يأخذ عن الكل والكل يرد على الكل"
الجاحظ صورته الأدبية تطغى على صورته العقدية فلا ينحصر الأخذ منه في المعتزلة .
والزمخشري مشهور أنه طبق نظرية النظم في الكشاف مع أنه لم يذكر عبد القاهر إلا مرة واحدة .
ولو صح وجود نظريتين فهذا أثرى للدرس البلاغي من اعتبار الكل مدرسة واحدة .
🍃مناسبة زرقاء اليمامة في معلقة النابغة 🍃
النابغة كان من حاشية النعمان بن المنذر ملك الحيرة ووشى به أعداؤه إلى النعمان بتهمة كاذبة وخاف النابغة على نفسه فهرب إلى ملك غسان ثم اشتاق إلى النعمان وإلى عطاياه فكتب المعلقة يعتذر بها ويظهر خوفه وضعفه ويقدم الحجج والإقناع للنعمان المعروف ببطشه وغضبه المسعور ويوم بؤسه الذي يقتل فيه من يقدم عليه كائنا من كان .
قال النابغة
احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت
إلى حمام شراع وارد الثمد
يحفه جانبا نيق وتتبعه
مثل الزجاجة لم تٌكحل من الرمد
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا ونصفه فقد
فحسبوه فألفوه كما زعمت
تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد
فكمّلت مائة فيها حمامتها
وأحسنت حسبة في ذلك العدد
النابغة لم يذكر اسم زرقاء اليمامة ولا وصفها بل عبر عنها باسم يقلل من شأنها ويصغر من عمرها( فتاة الحي ) وذلك أنه في مقام تحريض الملك أن لا يكون حكمه أقل من حكم فتاة .
بعد أن ذكر في أبيات سابقة ملكا عادلا ونبياصالحاً هو سليمان عليه السلام وذكر أنه مع قوته وتسخير الجن له لم يحكم بظلم بل عاقب العاصي وأثاب المطيع فبعد أن أعطى النعمان مثلاً من الملوك العظام أعطاه مثلا آخر من الرعية الضعيفة
لتتم الحجة العربية المشهورة قياس الأولى من جهتين
أنت أكمل عقلاً ونظراً وحكماً من فتاة الحي فينبغي أن لا تحكم أقل من حكمها
وسليمان أقوى منك وأعظم ملكا ولم يظلم فينبغي أن لا تظلم أيضاً
ولو تأملت الشعر من غير هذا التأويل لوجدت أنه من الغريب أن يطلب الشاعر من ملك أن يحكم مثل حكم فتاة الحي ومن الغريب أيضا أن يذكر فضل سليمان عليه السلام على النعمان في قصيدة يمدح فيها النعمان ويعتذر له
وهذه الحجة مشهورة عند العرب يستعملونها كثيرا ومن أمثلة استعمالهم إياها قول الشاعر:
كليب لعمري كان أكثر ناصراً
وأيسر جرماً منك ضرّج بالدم
أي لا تظن أنك ستنجو لكثرة أنصارك فكليب كان أنصاره أكثر ولا لصغر ذنبك فكليب أصغر جرما منك
وهي حجة يستعملها الناس جميعا ولكن للعرب بها فضل عناية ولطف نظر .
ومن جهة أخرى ففي طمع الفتاة بسرب الحمام وعدم اكتفائها بحمامتها ما يشبه أن يكون تعريضا بالنعمان وتحريضا له أن لا يزهد في النعمان ويكتفي بمن عنده من الشعراء والحاشية
وإن وجدت في ذلك بعداً فقارن بين قصة المتنبي وسيف الدولة وقصة النابغة والنعمان فبينهما تشابه يعين على فهم مقاصدهما في شعر الاعتذار وإن كان النابغة أصدق شعورا وأحر قلباً .
النابغة كان من حاشية النعمان بن المنذر ملك الحيرة ووشى به أعداؤه إلى النعمان بتهمة كاذبة وخاف النابغة على نفسه فهرب إلى ملك غسان ثم اشتاق إلى النعمان وإلى عطاياه فكتب المعلقة يعتذر بها ويظهر خوفه وضعفه ويقدم الحجج والإقناع للنعمان المعروف ببطشه وغضبه المسعور ويوم بؤسه الذي يقتل فيه من يقدم عليه كائنا من كان .
قال النابغة
احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت
إلى حمام شراع وارد الثمد
يحفه جانبا نيق وتتبعه
مثل الزجاجة لم تٌكحل من الرمد
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا ونصفه فقد
فحسبوه فألفوه كما زعمت
تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد
فكمّلت مائة فيها حمامتها
وأحسنت حسبة في ذلك العدد
النابغة لم يذكر اسم زرقاء اليمامة ولا وصفها بل عبر عنها باسم يقلل من شأنها ويصغر من عمرها( فتاة الحي ) وذلك أنه في مقام تحريض الملك أن لا يكون حكمه أقل من حكم فتاة .
بعد أن ذكر في أبيات سابقة ملكا عادلا ونبياصالحاً هو سليمان عليه السلام وذكر أنه مع قوته وتسخير الجن له لم يحكم بظلم بل عاقب العاصي وأثاب المطيع فبعد أن أعطى النعمان مثلاً من الملوك العظام أعطاه مثلا آخر من الرعية الضعيفة
لتتم الحجة العربية المشهورة قياس الأولى من جهتين
أنت أكمل عقلاً ونظراً وحكماً من فتاة الحي فينبغي أن لا تحكم أقل من حكمها
وسليمان أقوى منك وأعظم ملكا ولم يظلم فينبغي أن لا تظلم أيضاً
ولو تأملت الشعر من غير هذا التأويل لوجدت أنه من الغريب أن يطلب الشاعر من ملك أن يحكم مثل حكم فتاة الحي ومن الغريب أيضا أن يذكر فضل سليمان عليه السلام على النعمان في قصيدة يمدح فيها النعمان ويعتذر له
وهذه الحجة مشهورة عند العرب يستعملونها كثيرا ومن أمثلة استعمالهم إياها قول الشاعر:
كليب لعمري كان أكثر ناصراً
وأيسر جرماً منك ضرّج بالدم
أي لا تظن أنك ستنجو لكثرة أنصارك فكليب كان أنصاره أكثر ولا لصغر ذنبك فكليب أصغر جرما منك
وهي حجة يستعملها الناس جميعا ولكن للعرب بها فضل عناية ولطف نظر .
ومن جهة أخرى ففي طمع الفتاة بسرب الحمام وعدم اكتفائها بحمامتها ما يشبه أن يكون تعريضا بالنعمان وتحريضا له أن لا يزهد في النعمان ويكتفي بمن عنده من الشعراء والحاشية
وإن وجدت في ذلك بعداً فقارن بين قصة المتنبي وسيف الدولة وقصة النابغة والنعمان فبينهما تشابه يعين على فهم مقاصدهما في شعر الاعتذار وإن كان النابغة أصدق شعورا وأحر قلباً .
" نظرية الانحراف التي هي أساس تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ترجع إلى أرسطو ، الذي جعل الاستعارة دليلا على وجود القدرة على رؤية التشابهات، فنجم عن ذلك فرضية سيئة هي أن الاستعارة انحراف عن النمط العادي للاستعمال بدلا من أن تكون المنطق الحاضر أبداً في نشاط اللغة الحر وليس هذا خاصاً بالاستعارة، بل الصورة البلاغية كلها تصورت على أنها انحراف منذ أرسطو تنحرف عما يلائمها للحصول على هو أسمى .
من خلال التقابل الذي وضعه أرسطو بين المبتذل والملغز ، بين القومي والأجنبي، بين المألوف والغريب، انزلق التقابل بين الحقيقي والمجازي "
" الأبعاد التداولية للمجاز عند ابن تيمية" لفريدة زمرد .
تظهر فكرة الانحراف في تفضيل الغرابة في التشبيه على التشبيه المألوف وتظهر في جعل الكناية أبلغ من التصريح والمجاز أبلغ من الحقيقة
وتظهر في تعليلات البلاغيين لأساليب الاستعارة والكناية والتشبيه والحذف والالتفات والتأكيد والتقديم والتأخير والستة الأخيرة اختلف فيها البلاغيون أهي من الحقيقية أم من المجاز
وكلمة الجاحظ( والمعاني مطروحة على الطريق يعرفها العربي والأعجمي ) لها تعلق بذلك والله أعلم.
من خلال التقابل الذي وضعه أرسطو بين المبتذل والملغز ، بين القومي والأجنبي، بين المألوف والغريب، انزلق التقابل بين الحقيقي والمجازي "
" الأبعاد التداولية للمجاز عند ابن تيمية" لفريدة زمرد .
تظهر فكرة الانحراف في تفضيل الغرابة في التشبيه على التشبيه المألوف وتظهر في جعل الكناية أبلغ من التصريح والمجاز أبلغ من الحقيقة
وتظهر في تعليلات البلاغيين لأساليب الاستعارة والكناية والتشبيه والحذف والالتفات والتأكيد والتقديم والتأخير والستة الأخيرة اختلف فيها البلاغيون أهي من الحقيقية أم من المجاز
وكلمة الجاحظ( والمعاني مطروحة على الطريق يعرفها العربي والأعجمي ) لها تعلق بذلك والله أعلم.
التجديد الهدّام 🍃
قال أحمد شوقي :
لا تحذُ حذو عصابة مفتونة
يجدون كل قديم شيء منكرا
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا
من مات من آبائهم أو عمّرا
من كل ماض في القديم وهدمه
وإذا تقدّم للبناية قصّرا
وأتى الحضارة بالصناعة رثة
والعلم نزرا والبيان مثرثرا
وقال في فضيلة الأوائل :
فلا تجحدنّ يد الغارسين
وهذا الجنى في يديك اعترف
وكان محمود شاكر رحمه الله تعالى يسمي أدعياء
التجديد ( المجددينات) يخلط في وصفهم بين جمعي المذكر والمؤنث .
التقليد الأعمى 🍃
(هل ترك الأولون للآخرين؟
حدث أن واجهتني هذه المقولة مرّة بحضور أستاذنا اللغوي الكبير الدكتور مازن المبارك فكان أن تلطّف وردّها على صاحبها بنفسه قائلاً : أخبرنا إذن ، في أية سنة بالضبط تنتهي حقبة الأولين وتبدأ حقبة الآخرين ؟
قال عبد القاهر رحمه الله:
وكلام كثير قد جرى على ألسنة الناس وله مضرّة شديدة وثمرة مرّة .
فمن أضرّ ذلك قولهم : لم يدع الأول للآخر شيئاً .قال فلو أن علماء كل عصر ، مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم، تركوا الاستنباط لِما لك ينتهِ إليهم عمّن قبلهم لرأيت العلم مختلّا .)
أحمد بسام ساعي
قال أحمد شوقي :
لا تحذُ حذو عصابة مفتونة
يجدون كل قديم شيء منكرا
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا
من مات من آبائهم أو عمّرا
من كل ماض في القديم وهدمه
وإذا تقدّم للبناية قصّرا
وأتى الحضارة بالصناعة رثة
والعلم نزرا والبيان مثرثرا
وقال في فضيلة الأوائل :
فلا تجحدنّ يد الغارسين
وهذا الجنى في يديك اعترف
وكان محمود شاكر رحمه الله تعالى يسمي أدعياء
التجديد ( المجددينات) يخلط في وصفهم بين جمعي المذكر والمؤنث .
التقليد الأعمى 🍃
(هل ترك الأولون للآخرين؟
حدث أن واجهتني هذه المقولة مرّة بحضور أستاذنا اللغوي الكبير الدكتور مازن المبارك فكان أن تلطّف وردّها على صاحبها بنفسه قائلاً : أخبرنا إذن ، في أية سنة بالضبط تنتهي حقبة الأولين وتبدأ حقبة الآخرين ؟
قال عبد القاهر رحمه الله:
وكلام كثير قد جرى على ألسنة الناس وله مضرّة شديدة وثمرة مرّة .
فمن أضرّ ذلك قولهم : لم يدع الأول للآخر شيئاً .قال فلو أن علماء كل عصر ، مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم، تركوا الاستنباط لِما لك ينتهِ إليهم عمّن قبلهم لرأيت العلم مختلّا .)
أحمد بسام ساعي
حول أمثلة أسلوب الحكيم في القرآن الكريم
إذا قارنت بين تحليل بلاغة الآيات في كتب البلاغة وبين كتب التفسير وجدت فرقاً وتفاوتاً ورأيت أمثلة البلاغيين غير محررة
وقد ساعد على هذا الخلل في أمثلة البلاغيين أمران:
١_جهل بعضهم بعلم التفسير أو عدم العناية باستحضاره داخل كتب الفن
٢_اشتهار مقولة عدم الاعتراض على الأمثلة إذ المقصود منها التصور كما قال الناظم:
والشأن لا يُعترض المثال ُ
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ
وثمت فرق بين المثال والشاهد فالشواهد لابد من تحريرها وورود الأسلوب في القرآن وعدد مرات وروده مؤثر في التسليم بصحته وبلاغته وسلامة الاستشهاد به فالأمثلة القرآنية شواهد على أصل المسألة أو على رتبتها .
ومن ذلك ما ذكروه في أمثلة أسلوب الحكيم وهو ترك جواب السائل والإجابة عما هو أهم وأولى أن يُسأل عنه أو تلقي المخاطب بغير ما يترقب والسائل بغيرما يتطلب
وأشهر ما استشهدوا به من القرآن ثلاث آيات :
١_ قول الله تعالى(( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ))
اعتمد البلاغيون على رواية تقول : سأل الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ فنزلت الآية.
قال الحافظ العراقي لم أقف على إسناد لهذه الرواية .
والرواية الثانية قالوا يا رسول الله لم خلقت الأهلة فأنزل الله الآية يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وهذه الرواية أصح من الأولى .
ويكون الجواب عندها جواباً مطابقاً وهو الذي اعتمده غير واحد من العلماء منهم الزمخشري
وحتى على الرواية الأولى فقد رأى بعض العلماء أن سؤال الصحابة صحيح وأن الجواب مطابق له وذلك بجعل سؤالهم عن الحكمة في الاختلاف لا عن السبب المادي .
وفي بعض الروايات أن السائل معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة .
٢_ آية الإنفاق(( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ))
قالوا عدل عن جواب ماهية النفقة إلى بيان مصارف الإنفاق
وهذا خلاف تفسير السلف للآية حيث فسرها ابن عباس ومجاهد : يسألونك كيف ينفقون؟
وقال ابن جريج يسألون أين يضعون أموالهم ؟
قال ابن عاشور: _ليس في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب المذكور كما قيل ، إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال المنفَق بمعنى السؤال عن النوع من ذهب أو ورق ...
ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بما، وهي يُسأل بها عن الجنس لا عن العوارض، فإن ذلك اصطلاح منطقي لتقريب ما ترجموه من تقسيمات مبنية على اللغة اليونانية وأخذ به بعض البلاغيين احتفالاً باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العربي _ بتصرف يسير
٣_ قول الله تعالى :(( قال فرعون وما رب العالمين .قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين)) .
ذكروا أن فرعون سأل عن الماهية فترك موسى عليه السلام جوابه وأجاب عن الصفات .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
قال له : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ، هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف ..
ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهيّة فقد غلط ، فإنه لم يكن مقرّاً بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً له فيما يظهر .
ورجح الزمخشري هذا الوجه أن يكون سؤال فرعون عن وجود إله غيره لا عن الماهية .
وقال الزمخشري في موضع آخر تقول ما زيد ؟ أي ما صفته طويل أم قصير فقيه أم طبيب .
وحتى على القول بأن ما سؤال عن الماهية فقد رأى ابن عاشور أن جواب موسى مطابق للسؤال تمام المطابقة .
وقال السمعاني : جواب موسى عليه السلام عن معنى السؤال لا عن عين السؤال .
ونقل الخلاف والنص على علّة اختيار القول الموافق للقاعدة مناسب ذكره في كتب البلاغة وليس خارجاً عن موضوعها لا سيما إن كان الخلاف قوياً أو بيان كون الآية موافقة على قول.
والطالب إن لم يكن قرأ التفسير رسخت الأمثلة في ذهنه وصعب إرجاعه عنها فمما ينبغي أن يعتني به مقارنة أمثلة البلاغة بكتب التفسير البلاغي كالكشاف والتحرير والتنوير.
والله الموفق .
إذا قارنت بين تحليل بلاغة الآيات في كتب البلاغة وبين كتب التفسير وجدت فرقاً وتفاوتاً ورأيت أمثلة البلاغيين غير محررة
وقد ساعد على هذا الخلل في أمثلة البلاغيين أمران:
١_جهل بعضهم بعلم التفسير أو عدم العناية باستحضاره داخل كتب الفن
٢_اشتهار مقولة عدم الاعتراض على الأمثلة إذ المقصود منها التصور كما قال الناظم:
والشأن لا يُعترض المثال ُ
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ
وثمت فرق بين المثال والشاهد فالشواهد لابد من تحريرها وورود الأسلوب في القرآن وعدد مرات وروده مؤثر في التسليم بصحته وبلاغته وسلامة الاستشهاد به فالأمثلة القرآنية شواهد على أصل المسألة أو على رتبتها .
ومن ذلك ما ذكروه في أمثلة أسلوب الحكيم وهو ترك جواب السائل والإجابة عما هو أهم وأولى أن يُسأل عنه أو تلقي المخاطب بغير ما يترقب والسائل بغيرما يتطلب
وأشهر ما استشهدوا به من القرآن ثلاث آيات :
١_ قول الله تعالى(( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ))
اعتمد البلاغيون على رواية تقول : سأل الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ فنزلت الآية.
قال الحافظ العراقي لم أقف على إسناد لهذه الرواية .
والرواية الثانية قالوا يا رسول الله لم خلقت الأهلة فأنزل الله الآية يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وهذه الرواية أصح من الأولى .
ويكون الجواب عندها جواباً مطابقاً وهو الذي اعتمده غير واحد من العلماء منهم الزمخشري
وحتى على الرواية الأولى فقد رأى بعض العلماء أن سؤال الصحابة صحيح وأن الجواب مطابق له وذلك بجعل سؤالهم عن الحكمة في الاختلاف لا عن السبب المادي .
وفي بعض الروايات أن السائل معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة .
٢_ آية الإنفاق(( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ))
قالوا عدل عن جواب ماهية النفقة إلى بيان مصارف الإنفاق
وهذا خلاف تفسير السلف للآية حيث فسرها ابن عباس ومجاهد : يسألونك كيف ينفقون؟
وقال ابن جريج يسألون أين يضعون أموالهم ؟
قال ابن عاشور: _ليس في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب المذكور كما قيل ، إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال المنفَق بمعنى السؤال عن النوع من ذهب أو ورق ...
ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بما، وهي يُسأل بها عن الجنس لا عن العوارض، فإن ذلك اصطلاح منطقي لتقريب ما ترجموه من تقسيمات مبنية على اللغة اليونانية وأخذ به بعض البلاغيين احتفالاً باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العربي _ بتصرف يسير
٣_ قول الله تعالى :(( قال فرعون وما رب العالمين .قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين)) .
ذكروا أن فرعون سأل عن الماهية فترك موسى عليه السلام جوابه وأجاب عن الصفات .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
قال له : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ، هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف ..
ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهيّة فقد غلط ، فإنه لم يكن مقرّاً بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً له فيما يظهر .
ورجح الزمخشري هذا الوجه أن يكون سؤال فرعون عن وجود إله غيره لا عن الماهية .
وقال الزمخشري في موضع آخر تقول ما زيد ؟ أي ما صفته طويل أم قصير فقيه أم طبيب .
وحتى على القول بأن ما سؤال عن الماهية فقد رأى ابن عاشور أن جواب موسى مطابق للسؤال تمام المطابقة .
وقال السمعاني : جواب موسى عليه السلام عن معنى السؤال لا عن عين السؤال .
ونقل الخلاف والنص على علّة اختيار القول الموافق للقاعدة مناسب ذكره في كتب البلاغة وليس خارجاً عن موضوعها لا سيما إن كان الخلاف قوياً أو بيان كون الآية موافقة على قول.
والطالب إن لم يكن قرأ التفسير رسخت الأمثلة في ذهنه وصعب إرجاعه عنها فمما ينبغي أن يعتني به مقارنة أمثلة البلاغة بكتب التفسير البلاغي كالكشاف والتحرير والتنوير.
والله الموفق .
"البلاغة السامية - على عكس البلاغة اليونانية الخطية - تقوم على التوازي والبناء المحوري العكسي الذي لابد من استكشافه لفهم بنية المعنى"
ميشال كويبرز
وهذا المستشرق متأثر بالفراهي وتلاميذه وهذه الفكرة والطريقة هي فكرة الفراهي نظّر لها في عدة مواضع فبنى عليها هذا الرجل وخلط بينها وبين بعض مناهج اللسانيات في الغرب ومناهج دراسة الكتب المقدسة .
ولهذا المستشرق دسائس وتحريفات لا يُنصح بكتبه لغير المختص.
ومن المؤسف والخطير أن يتنبه المستشرقون للفراهي ويكملون دراساته ويهمله العرب ثم تعود إلينا بضاعتنا من موانئهم وقد كذبوا معها مائة كذبة فيقبلها مطلقا ضعيف الإيمان وينكرها مطلقا ضعيف العلم .
وأذكر كلمة لأحدهم قال من نعمة الله علينا أن تراث ابن تيمية أعيد اكتشافه ونشره بأيد شرقية قبل أن تبعثه وتحييه البحوث الاستشراقية .
ميشال كويبرز
وهذا المستشرق متأثر بالفراهي وتلاميذه وهذه الفكرة والطريقة هي فكرة الفراهي نظّر لها في عدة مواضع فبنى عليها هذا الرجل وخلط بينها وبين بعض مناهج اللسانيات في الغرب ومناهج دراسة الكتب المقدسة .
ولهذا المستشرق دسائس وتحريفات لا يُنصح بكتبه لغير المختص.
ومن المؤسف والخطير أن يتنبه المستشرقون للفراهي ويكملون دراساته ويهمله العرب ثم تعود إلينا بضاعتنا من موانئهم وقد كذبوا معها مائة كذبة فيقبلها مطلقا ضعيف الإيمان وينكرها مطلقا ضعيف العلم .
وأذكر كلمة لأحدهم قال من نعمة الله علينا أن تراث ابن تيمية أعيد اكتشافه ونشره بأيد شرقية قبل أن تبعثه وتحييه البحوث الاستشراقية .
محمد شحرور وفتنة اللغة
يقول أحمد شوقي في رثاء علي بهجت_ وهي أجمل مرثية لمعلم وصديق_ أبياتاً تصلح وصفاً لمحمد شحرور والمفتونين به :
زعمت الغيب خلف لسان طيرٍ
جهلت لسانه فزعمت غيّا
أصاب الغيب عند الطير قوم
وصار البوم عندهم نبيّا
إذا غنّاهموا وجدوا سطيحاً
على فمه وأفعى الجرهميا
وقال في نفس القصيدة :
إذا رشد المعلم كان موسى
وإن هو ضلً كان السامريّا
الباب الذي دخل منه شحرور _ومعه الكثير _ هو تبسيط اللغة و الفروق الدلالية والبلاغية وهو مدخل غير معتنى به حق العناية فأجرى خيله في ميدان خالٍ وصادف قلباً أخلى .
وهو الباب الذي دخل منه الشعراوي وفاضل السامرائي _ مع التفاوت بين الفريقين _ إلى عوام الناس وأحدثا أثراً حسناً مع التزامهما بقواعد السابقين .
وهذه الفتنة الأولى .
والفتنة الثانية غرابة ما يأتي به وتجاوزه سقف التوقعات في تفسير آيات يعرف الجميع لفظها ومعناها .
وسمعت من البروفيسور جعفر ميرغني مقولة صادقة _ينقلها _ :
"أمتع الحديث أن تحدثني حديثا جديداً كل الجدة عن أمر أعرفه كل المعرفة ".
فهي متعة معرفية مسمومة وإثارة عقلية ملغومة .
وعلى من يتصدى للجماهير معرفة هذين المدخلين واستعمالهما في الحق .
يقول أحمد شوقي في رثاء علي بهجت_ وهي أجمل مرثية لمعلم وصديق_ أبياتاً تصلح وصفاً لمحمد شحرور والمفتونين به :
زعمت الغيب خلف لسان طيرٍ
جهلت لسانه فزعمت غيّا
أصاب الغيب عند الطير قوم
وصار البوم عندهم نبيّا
إذا غنّاهموا وجدوا سطيحاً
على فمه وأفعى الجرهميا
وقال في نفس القصيدة :
إذا رشد المعلم كان موسى
وإن هو ضلً كان السامريّا
الباب الذي دخل منه شحرور _ومعه الكثير _ هو تبسيط اللغة و الفروق الدلالية والبلاغية وهو مدخل غير معتنى به حق العناية فأجرى خيله في ميدان خالٍ وصادف قلباً أخلى .
وهو الباب الذي دخل منه الشعراوي وفاضل السامرائي _ مع التفاوت بين الفريقين _ إلى عوام الناس وأحدثا أثراً حسناً مع التزامهما بقواعد السابقين .
وهذه الفتنة الأولى .
والفتنة الثانية غرابة ما يأتي به وتجاوزه سقف التوقعات في تفسير آيات يعرف الجميع لفظها ومعناها .
وسمعت من البروفيسور جعفر ميرغني مقولة صادقة _ينقلها _ :
"أمتع الحديث أن تحدثني حديثا جديداً كل الجدة عن أمر أعرفه كل المعرفة ".
فهي متعة معرفية مسمومة وإثارة عقلية ملغومة .
وعلى من يتصدى للجماهير معرفة هذين المدخلين واستعمالهما في الحق .
للأستاذ يوسف الصيداوي كتاب ظريف اسمه بيضة الديك في تزييف لغة وبلاغة شحرور وقد ألّفه قديماً .
ومن لم يرغب في قراءة الكتاب فللدكتور عبد الله الفيفي عشرة مقالات ساخرة بعنوان في مجلس ابن جني خصصها للنقد اللغوي لشحرور .
ومن لم يرغب في قراءة الكتاب فللدكتور عبد الله الفيفي عشرة مقالات ساخرة بعنوان في مجلس ابن جني خصصها للنقد اللغوي لشحرور .
حكمة العرب وصناعتها 🍃
ابن تيمية رحمه الله سمّى سيبويه حكيم لسان العرب وقال عن كتابه ( ليس في العالم مثله وفيه حكمة لسان العرب )
قال العلماء : حكمة اليونان في عقولها ، وحكمة الصين في أيديها، وحكمة العرب في لسانها .
مصطلح الحكمة يطلق على المنطق والفلسفة وعلى الطب وعلى غير ذلك إلا أن استعماله هنا يمكن أن يشعر بنوع من تشبيه اللغة بالمنطق اليوناني والصنائع الصينية
وقد كثر تشبيه العلماء للبلاغة في اللسان بالنسج والذي تتميز به الصين بما أنها بلد الحرير والصنائع المستحسنة.
يقول الجاحظ: وإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير .
ويقول عبد القاهر: قد استعاروا النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم.
وأول من شبه الكلام بالنسج هو النابغة حيث قال :
أتاك بقول هلهل النسج كاذب
ولم يأت بالحق الذي هو ساطع
وفي مناظرات السيرافي مع متى المنطقي اعتبر السيرافي النحو منطقاً عربياً كما أن المنطق نحو يوناني
ويقول الشافعي إنما ضل الناس لما تركوا لسان العرب وأخذوا لسان أرسططاليس.
فسمى الشافعي رحمه الله المنطق لساناً .
ابن تيمية رحمه الله سمّى سيبويه حكيم لسان العرب وقال عن كتابه ( ليس في العالم مثله وفيه حكمة لسان العرب )
قال العلماء : حكمة اليونان في عقولها ، وحكمة الصين في أيديها، وحكمة العرب في لسانها .
مصطلح الحكمة يطلق على المنطق والفلسفة وعلى الطب وعلى غير ذلك إلا أن استعماله هنا يمكن أن يشعر بنوع من تشبيه اللغة بالمنطق اليوناني والصنائع الصينية
وقد كثر تشبيه العلماء للبلاغة في اللسان بالنسج والذي تتميز به الصين بما أنها بلد الحرير والصنائع المستحسنة.
يقول الجاحظ: وإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير .
ويقول عبد القاهر: قد استعاروا النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم.
وأول من شبه الكلام بالنسج هو النابغة حيث قال :
أتاك بقول هلهل النسج كاذب
ولم يأت بالحق الذي هو ساطع
وفي مناظرات السيرافي مع متى المنطقي اعتبر السيرافي النحو منطقاً عربياً كما أن المنطق نحو يوناني
ويقول الشافعي إنما ضل الناس لما تركوا لسان العرب وأخذوا لسان أرسططاليس.
فسمى الشافعي رحمه الله المنطق لساناً .
السبب في صعوبة النحو أنه وضع لفهم لسان العرب لا لتقويم ألسنة العجم .
وما يذكره النحاة من تعليل واستثناءات وشواذ وتقديرات متكلفة لا تفيد الأعجمي في تقويم لسانه وإنما غايتها فهم حكمة لسان العرب .
والمحاولات التيسيرية للنحو ينبغي أن تلحظ هذا الفرق بين غاية التعليم وغاية الفهم .
وما يذكره النحاة من تعليل واستثناءات وشواذ وتقديرات متكلفة لا تفيد الأعجمي في تقويم لسانه وإنما غايتها فهم حكمة لسان العرب .
والمحاولات التيسيرية للنحو ينبغي أن تلحظ هذا الفرق بين غاية التعليم وغاية الفهم .
" الدراسات البلاغية التي قامت على الحديث النبوي الشريف _في معظمها _ انطلقت من تتبّع الظواهر البيانية والبديعية وفق المفاهيم التي حددتها النظرية البلاغية التي تأسست على الخطاب الشعري
إن الحديث النبوي الشريف أبعد ما يكون عن أن يكون خطابا شعرياً ، وعلى الرغم من أن هذه حقيقة لا أرى عاقلاً يجادل فيها، فإن الدراسات البلاغية التي تناولت الحديث النبوي الشريف _ في معظمها _ استغرقت استغراقاً تاماً في رؤيته بأدوات الشعر التي تراه خطاباً فنياً يهدف إلى تحقيق غاية جمالية إمتاعية "
عيد بلبع _ مقدمة في نظرية البلاغة النبوية _
إن الحديث النبوي الشريف أبعد ما يكون عن أن يكون خطابا شعرياً ، وعلى الرغم من أن هذه حقيقة لا أرى عاقلاً يجادل فيها، فإن الدراسات البلاغية التي تناولت الحديث النبوي الشريف _ في معظمها _ استغرقت استغراقاً تاماً في رؤيته بأدوات الشعر التي تراه خطاباً فنياً يهدف إلى تحقيق غاية جمالية إمتاعية "
عيد بلبع _ مقدمة في نظرية البلاغة النبوية _
فخ التعميم في التحليل البلاغي 🍃
من القواعد التي يُعملها البعض في تفسير القرآن الكريم دون انتباه لما تحمله من أخطار هي قاعدة حمل اللفظ على أوسع معانيه وترجيح الأقوال والقراءات إذا كانت أعم في دلالتها.
قال ابن عميرة منتقداً البلاغيين الذين يفسرون القرآن ويؤولونه من أجل أن يكون المعنى أعم وأبلغ:
أخذوا هذا المعنى من نقاد الأشعار فإنهم إذا لاح لهم معنى كان أعم دلالةً وأبلغ صفة حملوا اللفظ عليه ، والتجاسر بمثل هذا على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خطر شديد فلعل المقصود باللفظ المدلول الأخص أو المعنى الأخف .
قال ابن تيمية في ترجيح قراءة (( وهو يطعم ولا يُطعَم )) بضم الياء الثانية وهي قراءة العشرة على فتحها _ مع أن الفتح أعم وأوسع دلالة _:
هذه الآية لم تسق لبيان تنزهه عن الأكل ، فإن ذلك مبيّن فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص الدالة على أن هذه النقائص مستلزمة لكون صاحبها مخلوقاً لا إلهاً ونحو ذلك.
وإنما سيقت لبيان حاجة الخلق إليه وإحسانه إليهم ، وبيان غناه عنهم وامتناع إحسانهم إليه، فإنه يطعمهم وهم لا يطعمونه، وهذا الوصف دالّ على هذا المقصود .
من القواعد التي يُعملها البعض في تفسير القرآن الكريم دون انتباه لما تحمله من أخطار هي قاعدة حمل اللفظ على أوسع معانيه وترجيح الأقوال والقراءات إذا كانت أعم في دلالتها.
قال ابن عميرة منتقداً البلاغيين الذين يفسرون القرآن ويؤولونه من أجل أن يكون المعنى أعم وأبلغ:
أخذوا هذا المعنى من نقاد الأشعار فإنهم إذا لاح لهم معنى كان أعم دلالةً وأبلغ صفة حملوا اللفظ عليه ، والتجاسر بمثل هذا على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خطر شديد فلعل المقصود باللفظ المدلول الأخص أو المعنى الأخف .
قال ابن تيمية في ترجيح قراءة (( وهو يطعم ولا يُطعَم )) بضم الياء الثانية وهي قراءة العشرة على فتحها _ مع أن الفتح أعم وأوسع دلالة _:
هذه الآية لم تسق لبيان تنزهه عن الأكل ، فإن ذلك مبيّن فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص الدالة على أن هذه النقائص مستلزمة لكون صاحبها مخلوقاً لا إلهاً ونحو ذلك.
وإنما سيقت لبيان حاجة الخلق إليه وإحسانه إليهم ، وبيان غناه عنهم وامتناع إحسانهم إليه، فإنه يطعمهم وهم لا يطعمونه، وهذا الوصف دالّ على هذا المقصود .