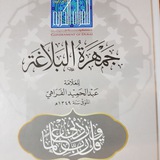أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة وهي : أن يؤدي القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئاً
قالوا وهذه إجازة كلا إجازة لأن في كلام العرب خصوصاً في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها
المأموني
قالوا وهذه إجازة كلا إجازة لأن في كلام العرب خصوصاً في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها
المأموني
من تأمل معلقة عنترة عرف أن عبلة فتاة من بني ذبيان وليست ابنة عمه كما تذكره السيرة المختلقة
انظر إليه يقول :
وتحل عبلة بالجواء وأهلنا
بالحزن فالصمان فالمتثلم
كيف تكون ابنة عمه وتسكن غير مسكن أهله؟
ويقول :
حلت بأرض الزائرين فأصبحت
عسراً علي طلابك ابنة مخرم
علقتها عرضا وأقتل قومها
زعما لعمر أبيك ليس بمزعم
فهذا دليل على عداوته لقوم عبلة
وكذلك قوله نهاية المعلقة :
حالت رماح ابني بغيض دونكم
وزوت جواني الحرب من لم يجرم
وابنا بغيض هما عبس وذبيان
فإن قلت كيف يذكر فتاة من أعدائه ويمدحها ويسلم على ديارها ؟
فالجواب أن هذا مذهب للشعراء يذكرون نسوة أعدائهم في قصائدهم
كما قال الأخطل :
ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر
وإن كان حيّانا عدىً آخر الدهر
وكما قال القطامي :
قفي قبل التفرق يا ضباعا
ولا يك موقف منك الوداعا
قفي فادي أسيرك إن قومي
وقومك لا أرى لهم اجتماعا
وتعليل هذا المذهب وتفصيله له موضع غير هذا _إن شاء الله _
وفي المعلقة أبيات ركيكة زادها الرواة تحرف غرض الشاعر إلى الغزل وهو عنه بمعزل مثل البيتين المشهورين :
(ولقد ذكرتك والرماح نواهل
مني وبيض الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل السيوف لأنها
لمعت كبارق ثغرك المتبسم)
ولا يليقان بعنترة ولا بشاعر عربي وقد ضعفهما النقاد
والله أعلم
انظر إليه يقول :
وتحل عبلة بالجواء وأهلنا
بالحزن فالصمان فالمتثلم
كيف تكون ابنة عمه وتسكن غير مسكن أهله؟
ويقول :
حلت بأرض الزائرين فأصبحت
عسراً علي طلابك ابنة مخرم
علقتها عرضا وأقتل قومها
زعما لعمر أبيك ليس بمزعم
فهذا دليل على عداوته لقوم عبلة
وكذلك قوله نهاية المعلقة :
حالت رماح ابني بغيض دونكم
وزوت جواني الحرب من لم يجرم
وابنا بغيض هما عبس وذبيان
فإن قلت كيف يذكر فتاة من أعدائه ويمدحها ويسلم على ديارها ؟
فالجواب أن هذا مذهب للشعراء يذكرون نسوة أعدائهم في قصائدهم
كما قال الأخطل :
ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر
وإن كان حيّانا عدىً آخر الدهر
وكما قال القطامي :
قفي قبل التفرق يا ضباعا
ولا يك موقف منك الوداعا
قفي فادي أسيرك إن قومي
وقومك لا أرى لهم اجتماعا
وتعليل هذا المذهب وتفصيله له موضع غير هذا _إن شاء الله _
وفي المعلقة أبيات ركيكة زادها الرواة تحرف غرض الشاعر إلى الغزل وهو عنه بمعزل مثل البيتين المشهورين :
(ولقد ذكرتك والرماح نواهل
مني وبيض الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل السيوف لأنها
لمعت كبارق ثغرك المتبسم)
ولا يليقان بعنترة ولا بشاعر عربي وقد ضعفهما النقاد
والله أعلم
قال ابن الأعرابي : كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره ، كان أبوه شاعراً وخاله شاعراً وأخته سلمى شاعرة وابناه كعب وبجير شاعران وأخته الخنساء شاعرة.
ولزهير طريقة في تقريب المبالغة .... كراهية للكذب الثقيل وبغضة لسوء التأليف الذي يجيء من ناحية الإغراب
فتراه يداور المعاني حتى يبصر لها طريقاً إلى الحقيقة ويجد لها مخلصاً إلى الواقع كقوله :
لو كنت من شيء سوى بشرٍ
كنت المنور ليلة البدر
وكقوله :
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم
قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا
وعلى هذه الطريقة يحمل قول عمر : إنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه .
الرافعي
فتراه يداور المعاني حتى يبصر لها طريقاً إلى الحقيقة ويجد لها مخلصاً إلى الواقع كقوله :
لو كنت من شيء سوى بشرٍ
كنت المنور ليلة البدر
وكقوله :
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم
قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا
وعلى هذه الطريقة يحمل قول عمر : إنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه .
الرافعي
أقرب حقل علمي للبلاغة هو التفسير
أقرب حتى من النحو وكتب الأدب
وان كانت جهة القرب مختلفة فالتفسير تطبيق للقواعد البلاغية والنحو مصدر لها
إلا أن حجم استفادة البلاغي من كتب التفسير أكبر وحاجته إليها أمس
وهذه فضيلة لعلم البلاغة لا يدانيه بها علم من علوم الآلة
وجهات تعلق البلاغة بالتفسير أربع:
تناثر القواعد البلاغية في كتب التفسير
توقف التفسير على فنون البلاغة بشكل أكبر من غيره من العلوم
توقف المعرفة التفصيلية لإعجاز القرآن البلاغي عليها
اشتمال القرآن على فنون البلاغة كلها مما يصلح أن يكون في القرآن
أقرب حتى من النحو وكتب الأدب
وان كانت جهة القرب مختلفة فالتفسير تطبيق للقواعد البلاغية والنحو مصدر لها
إلا أن حجم استفادة البلاغي من كتب التفسير أكبر وحاجته إليها أمس
وهذه فضيلة لعلم البلاغة لا يدانيه بها علم من علوم الآلة
وجهات تعلق البلاغة بالتفسير أربع:
تناثر القواعد البلاغية في كتب التفسير
توقف التفسير على فنون البلاغة بشكل أكبر من غيره من العلوم
توقف المعرفة التفصيلية لإعجاز القرآن البلاغي عليها
اشتمال القرآن على فنون البلاغة كلها مما يصلح أن يكون في القرآن
👆🏻نقد مكثف وعميق وتلخيص لأهم الانتقادات على الدرس البلاغي للدكتور محمد إقبال عروي
ويستفيد دارس البلاغة من هذا النقد في ترشيد قراءته البلاغية وليس نفعه محصوراً على النقاد والمؤلفين في الدرس البلاغي
ويستفيد دارس البلاغة من هذا النقد في ترشيد قراءته البلاغية وليس نفعه محصوراً على النقاد والمؤلفين في الدرس البلاغي
Forwarded from طُروس 📚
جزى الله عني من دلّني على هذا الكتاب خير الجزاء في الدارين، وكتب أجره ونفع به، كتاب لعله نافع لمن يبحث في الأصول البلاغية وعلاقتها بعلم الكلام.
إعجاز الكتب السماوية 🍃
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها معجزة من جهة المعنى والأمر والنهي والأخبار الغيبية أما من جهة اللفظ والنظم فالأمر محتمل ويرجع فيه إلى أهل اللغة التي نزلت بها الكتب ا.ه
والإنجيل لم يكتب بلغة المسيح عيسى عليه السلام الآرامية
والتوراة كذلك نزلت باللغة العبرية القديمة التي تختلف عن العبرية المعاصرة
فالموجود هو ترجمة في حالة الإنجيل وشبه ترجمة في حالة التوراة والزبور
فلا يمكن التحقق من الإعجاز في اللفظ في الكتب السابقة .
فضلاً عن التحريف في المعنى والزيادة والنقصان من اهل الكتاب
فضلاً عن أن الآداب العبرية والارامية القديمة نادرة بحيث لا يتهيأ للناظر دراسة النصوص ومعرفة معايير البلاغة في تلك الآداب .
وفائدة هذا البحث هو في معرفة هل إعجاز القرآن لأجل كونه كلام الرب تعالى فتكون كل الكتب السابقة كذلك ،
أو لأجل خصوصية العرب في علم البيان جاءهم الكتاب المعجز لفظياً ؟
وفي الإعجاز أمران :
الدلالة على ربانية المصدر فلا يجوز خلو الكتب السابقة منه وهو إعجاز المعنى وما يستتبعه من ألفاظ .
والتحدي للناس وهذا يجوز أن تخلو منه الكتب السابقة لعدم صلاحية الأقوام للتحدي البياني أو لعدم صلاحية اللغات واتساعها كما ذكره بعضهم .
مع التنبه إلى أن اشتراك القرآن مع الكتب السابقة في الإعجاز لا يعني التساوي ولا يذهب خصوصية القرآن في درجة بلاغته وإعجازه وكونه آية النبوة وفي الذروة من البلاغة في الألفاظ والمعاني والهدى في الشرائع والعقائد والله أعلم.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها معجزة من جهة المعنى والأمر والنهي والأخبار الغيبية أما من جهة اللفظ والنظم فالأمر محتمل ويرجع فيه إلى أهل اللغة التي نزلت بها الكتب ا.ه
والإنجيل لم يكتب بلغة المسيح عيسى عليه السلام الآرامية
والتوراة كذلك نزلت باللغة العبرية القديمة التي تختلف عن العبرية المعاصرة
فالموجود هو ترجمة في حالة الإنجيل وشبه ترجمة في حالة التوراة والزبور
فلا يمكن التحقق من الإعجاز في اللفظ في الكتب السابقة .
فضلاً عن التحريف في المعنى والزيادة والنقصان من اهل الكتاب
فضلاً عن أن الآداب العبرية والارامية القديمة نادرة بحيث لا يتهيأ للناظر دراسة النصوص ومعرفة معايير البلاغة في تلك الآداب .
وفائدة هذا البحث هو في معرفة هل إعجاز القرآن لأجل كونه كلام الرب تعالى فتكون كل الكتب السابقة كذلك ،
أو لأجل خصوصية العرب في علم البيان جاءهم الكتاب المعجز لفظياً ؟
وفي الإعجاز أمران :
الدلالة على ربانية المصدر فلا يجوز خلو الكتب السابقة منه وهو إعجاز المعنى وما يستتبعه من ألفاظ .
والتحدي للناس وهذا يجوز أن تخلو منه الكتب السابقة لعدم صلاحية الأقوام للتحدي البياني أو لعدم صلاحية اللغات واتساعها كما ذكره بعضهم .
مع التنبه إلى أن اشتراك القرآن مع الكتب السابقة في الإعجاز لا يعني التساوي ولا يذهب خصوصية القرآن في درجة بلاغته وإعجازه وكونه آية النبوة وفي الذروة من البلاغة في الألفاظ والمعاني والهدى في الشرائع والعقائد والله أعلم.
مقدمات أشعار العرب 🍃
قال ابن طباطبا " وما أبدعه المحدثون من الشعراء في التخلص أفضل ممن تقدمهم لأن مذهب الأوائل في التخلص مذهب واحد، وهو قولهم عند وصف الفيافي وقطعها بسير الليالي وحكاية ما عانوا في أسفارهم إنا تجشمنا ذلك إلى فلان يعنون الممدوح "
نعم العرب الأوائل كانوا يتواردون على هذا المعنى في المديح خاصة ولا يخجلون من تكراره ولكنه لم يكن تخلصاً بل كان أسلوباً مقصوداً يقتضيه المقام ولا يحل غيره محله ولا يعذر من تركه عندهم فكان أشبه بما ذكره ابن عاشور رحمه الله قال :
نجد لشعراء العرب في كلامهم سنناً لا يكادون يحيدون عنها ، يتبع فيها المتأخر خطوات المتقدم بحيث يعد الإخلال بها حيدةٌ عن الطريقة المألوفة فكانت لغة من لغة الأدب وأصبحت بكثرة الاستعمال لا يلاحظون فيها خصوصية من خصوصيات علم المعاني والبيان بل يعاملونها معاملة الأساليب التركيبية في فصيح الكلام "
بتصرف يسير من مقالات ابن عاشور
قال ابن طباطبا " وما أبدعه المحدثون من الشعراء في التخلص أفضل ممن تقدمهم لأن مذهب الأوائل في التخلص مذهب واحد، وهو قولهم عند وصف الفيافي وقطعها بسير الليالي وحكاية ما عانوا في أسفارهم إنا تجشمنا ذلك إلى فلان يعنون الممدوح "
نعم العرب الأوائل كانوا يتواردون على هذا المعنى في المديح خاصة ولا يخجلون من تكراره ولكنه لم يكن تخلصاً بل كان أسلوباً مقصوداً يقتضيه المقام ولا يحل غيره محله ولا يعذر من تركه عندهم فكان أشبه بما ذكره ابن عاشور رحمه الله قال :
نجد لشعراء العرب في كلامهم سنناً لا يكادون يحيدون عنها ، يتبع فيها المتأخر خطوات المتقدم بحيث يعد الإخلال بها حيدةٌ عن الطريقة المألوفة فكانت لغة من لغة الأدب وأصبحت بكثرة الاستعمال لا يلاحظون فيها خصوصية من خصوصيات علم المعاني والبيان بل يعاملونها معاملة الأساليب التركيبية في فصيح الكلام "
بتصرف يسير من مقالات ابن عاشور
أولويات طالب العلم 🍃
"إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ومنها تحقيق الألفاظ المفردة "
الراغب الأصفهاني
"إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ومنها تحقيق الألفاظ المفردة "
الراغب الأصفهاني
لماذا قال زكريا عليه السلام ( وهن العظم مني ) ولم يقل وهنت العظام مني ؟
مع أن العظام أوسع دلالة والمقام مقام مبالغة وتهويل ؟
يقول الزمخشري :
( ذكر العظم ..ووحده- أفرده_ لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ، ولو جمع لكان قصداً إلى معنىً آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها ) انتهى من الكشاف
وكذلك قول زكريا عليه السلام (واشتعل الرأس شيبا ) معناه أن الرأس الذي يشيب غالبا بعد اللحية قد عمه الشيب فكيف باللحية ؟
وهذا المعنى لا يتحصل لو اطردت المبالغة فلو قيل وهنت العظام واشتعل الشعر شيباً لما تحصل مقصود الدعاء من إظهار الضعف بطريق الكناية والله أعلم
مع أن العظام أوسع دلالة والمقام مقام مبالغة وتهويل ؟
يقول الزمخشري :
( ذكر العظم ..ووحده- أفرده_ لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ، ولو جمع لكان قصداً إلى معنىً آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها ) انتهى من الكشاف
وكذلك قول زكريا عليه السلام (واشتعل الرأس شيبا ) معناه أن الرأس الذي يشيب غالبا بعد اللحية قد عمه الشيب فكيف باللحية ؟
وهذا المعنى لا يتحصل لو اطردت المبالغة فلو قيل وهنت العظام واشتعل الشعر شيباً لما تحصل مقصود الدعاء من إظهار الضعف بطريق الكناية والله أعلم
#تنبيهات_بلاغية
قال الكندي الفيلسوف: أجد في كلام العرب حشوًا، يقولون: عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد.
فقال المبرد: بل مختلفة؛ فعبد الله قائم، إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم، جواب عن سؤال، وإن عبد الله لقائم، جواب عن إنكار.
الظاهر _ والله أعلم _أن المبرد قصد التمثيل لفوائد التأكيد من عدمه بذكر مواضع قد يحتاج فيها المتكلم إلى التأكيد كخطابه للمنكر ولم يقصد أن هذا خطاب للمنكر وذاك خطاب لخالي الذهن وإذا وضعت أحدهما موضع الآخر كنت خرجت عن مقتضى الظاهر فينبغي لك البحث عن نكتة وتأويل
وإليك ما ذكره محمد بن يوسف الأباضي حول هذه القاعدة :
"وفائدة (أن) تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ سواء كانت إيجابية أو سلبية ، سواء كانت في جواب مُنكِرٍ أو ظانٍّ أو شاكٍّ أو خالي الذهن أو موقن ،
بحسب غرض المتكلم في إخباره من مبالغة أو عدمها .
هذا ما ظهر لي ، لا ما اشتهر في كتب المعاني من أن الإتيان بها في إخبارك من أيقن لا يجوز أو يخل بالبلاغة "
قال الكندي الفيلسوف: أجد في كلام العرب حشوًا، يقولون: عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد.
فقال المبرد: بل مختلفة؛ فعبد الله قائم، إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم، جواب عن سؤال، وإن عبد الله لقائم، جواب عن إنكار.
الظاهر _ والله أعلم _أن المبرد قصد التمثيل لفوائد التأكيد من عدمه بذكر مواضع قد يحتاج فيها المتكلم إلى التأكيد كخطابه للمنكر ولم يقصد أن هذا خطاب للمنكر وذاك خطاب لخالي الذهن وإذا وضعت أحدهما موضع الآخر كنت خرجت عن مقتضى الظاهر فينبغي لك البحث عن نكتة وتأويل
وإليك ما ذكره محمد بن يوسف الأباضي حول هذه القاعدة :
"وفائدة (أن) تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ سواء كانت إيجابية أو سلبية ، سواء كانت في جواب مُنكِرٍ أو ظانٍّ أو شاكٍّ أو خالي الذهن أو موقن ،
بحسب غرض المتكلم في إخباره من مبالغة أو عدمها .
هذا ما ظهر لي ، لا ما اشتهر في كتب المعاني من أن الإتيان بها في إخبارك من أيقن لا يجوز أو يخل بالبلاغة "
مذهب العرب في التكرار 🍃
العرب لا تأنف من التكرار ولا تبحث له عن مسوغ بل تكرر المعاني والألفاظ والأساليب بحسب اقتضاء المقام لأن الأصل في خطب العرب وأشعارها وسائر كلامها النطق بها بحسب قيام الداعي فإن تكرر الداعي تكرر الكلام ولابد
وذلك من نضج البلاغة عند العرب حيث صحت ملاحظتهم للمقامات المقتضية للكلام ودق اختيارهم للكلام فعرفوا أن لا ينفع في هذا المقام إلا هذا المقال فتواطئوا عليه وتتابعوا .
ولو نشأ منهم ناشئ لم يبلغ مبلغهم في العلم وتكلم بالشعر على غير طريقتهم لما التفتوا له بعين إعجاب ولا أصغوا له سمع إقرار .
ومهما ظننت أن في شعر بعض شعرائهم اختلافاً وتفرداً فاتهم اطلاعك فلو قرأت أكثر لوجدت لكل بيت نظائر حتى ربما لا يسلم لك من ديوان أحد الجاهليين الا معنيين أو ثلاثة لم تعرف نظيراً لها وربما لو نُقل لنا كل شعرهم لما بقي حتى معنى واحد
وليس معنى ذلك عدم وجود شخصية لكل شاعر بل شخصية الشاعر الجاهلي أكثر تميزاً من غيره من شعراء العصور اللاحقة ولكن فهمها محتاج إلى تأمل ودربة
فإن قلت إن في ذلك التكرار إملالاً والنفس إن ملّت استثقلت الحسن واستبردت الفصيح
فالجواب أن سرعة الملل وحب التغيير من أمراض النفوس وآفات المدنية التي ينتشر فيها الهوس بالتجديد والشذوذ
ولو راض الإنسان نفسه وساسها بسياسة العلم فسيكتسب صبراً على معاناة المعاني وسينظر بعين المقت لدعوات التجديد والهدم.
ثم إن علة الملل هو نظر الإنسان إلى التكرار من جهة غير الجهة التي ينبغي النظر من خلالها ،
فمن سمع كلاماً واحداً جيء به للتذكير مرة وللاخبار مرة وللتأكيد الدال على عناد المخالفين مرة أخرى ولتعليل ما أصابهم عند مخالفته مرة رابعة ولضرب المثل والمقابلة بين النظائر مرة خامسة وسادسة ثم التمس فروقاً دلالية بينها فقد ظلم نفسه وظلم الكلام الذي حكم عليه والله أعلم.
العرب لا تأنف من التكرار ولا تبحث له عن مسوغ بل تكرر المعاني والألفاظ والأساليب بحسب اقتضاء المقام لأن الأصل في خطب العرب وأشعارها وسائر كلامها النطق بها بحسب قيام الداعي فإن تكرر الداعي تكرر الكلام ولابد
وذلك من نضج البلاغة عند العرب حيث صحت ملاحظتهم للمقامات المقتضية للكلام ودق اختيارهم للكلام فعرفوا أن لا ينفع في هذا المقام إلا هذا المقال فتواطئوا عليه وتتابعوا .
ولو نشأ منهم ناشئ لم يبلغ مبلغهم في العلم وتكلم بالشعر على غير طريقتهم لما التفتوا له بعين إعجاب ولا أصغوا له سمع إقرار .
ومهما ظننت أن في شعر بعض شعرائهم اختلافاً وتفرداً فاتهم اطلاعك فلو قرأت أكثر لوجدت لكل بيت نظائر حتى ربما لا يسلم لك من ديوان أحد الجاهليين الا معنيين أو ثلاثة لم تعرف نظيراً لها وربما لو نُقل لنا كل شعرهم لما بقي حتى معنى واحد
وليس معنى ذلك عدم وجود شخصية لكل شاعر بل شخصية الشاعر الجاهلي أكثر تميزاً من غيره من شعراء العصور اللاحقة ولكن فهمها محتاج إلى تأمل ودربة
فإن قلت إن في ذلك التكرار إملالاً والنفس إن ملّت استثقلت الحسن واستبردت الفصيح
فالجواب أن سرعة الملل وحب التغيير من أمراض النفوس وآفات المدنية التي ينتشر فيها الهوس بالتجديد والشذوذ
ولو راض الإنسان نفسه وساسها بسياسة العلم فسيكتسب صبراً على معاناة المعاني وسينظر بعين المقت لدعوات التجديد والهدم.
ثم إن علة الملل هو نظر الإنسان إلى التكرار من جهة غير الجهة التي ينبغي النظر من خلالها ،
فمن سمع كلاماً واحداً جيء به للتذكير مرة وللاخبار مرة وللتأكيد الدال على عناد المخالفين مرة أخرى ولتعليل ما أصابهم عند مخالفته مرة رابعة ولضرب المثل والمقابلة بين النظائر مرة خامسة وسادسة ثم التمس فروقاً دلالية بينها فقد ظلم نفسه وظلم الكلام الذي حكم عليه والله أعلم.
دروب بلاغية
☝️🏻أصدرت مجلة الهند عدداً خاصاً بالفراهي رحمه الله تعالى فيه دراسات كثيرة عنه وكل عدد بحجم كتاب
تم نشر الجزء الأول والثالث والرابع
وهذه بقية الأجزاء ينتفع بها _ إن شاء الله _ محبو اللغة والتفسير خصوصاً وطلاب العلم عموماً 🍃