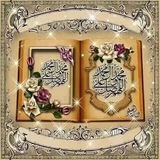🎤 زاد.الخطـيـب.الدعــــوي.tt
✍ طريقك إلى الخطابة والإلقاء7⃣3⃣
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
كيف.تكون.خطبتك.مؤثرة.cc؟
للشيخ/ محمد بن عبد الله الخضيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💥 مضمون الخطبة هو الجانب الأهم في الخطبة، وهو الذي عليه مدار إصلاح القلوب والأعمال، والأخلاق والسلوك، تثبيتا للصواب، وتكثيراً له، وتحذيراً من الخطأ وتقليلا له، وهناك عدة معالم وأسس تنطلق منها الخطبة الهادفة وترتكز عليها:
1⃣ - تقرير الأصول والأركان
حيث يكون للخطيب عناية خاصة بتقرير مسائل الإيمان والعقيدة، ولا يأنف من ذكرها والتأكيد عليها بين الفينة والأخرى، ولا يستبد به الولع بالمستجدات أيا كانت، وتطغى عليه هذه النـزعة، فيهمل تلك الجوانب العظيمة، ولربما تركها أو تساهل فيها بعض الخطباء؛ اعتماداً على سبق معرفة المستمعين لها أو دراسته إياها .
🔸وهذا على فرض ثبوته
فإن لغة الخطيب قدسية المكان وعبودية الاستماع تختلف عن لغة التعليم والدراسة فهما، وتأثراً وتطبيقا، إضافة إلى أن في المستمعين ربما من لم يتعلم في التعليم النظامي، أو ليست هذه المسائل من ضمن فقرات المنهج، ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه القضايا الأساسية .
🔸يقول ابن القيم- رحمه الله
كما في زاد المعاد: ( كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعده لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيدا..)
🔸ويقول أيضا: ( ومن تأمل خطب النبي- صلى الله عليه وسلم- وخطب أصحابه، وجدها كفيلة ببيان الهدي والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله، وأصول الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم )[1]
2⃣ - التنويع، فالخطبة الناجحة النافعة هي التي ينوع الخطيب في موضوعاتها كل خطبة بما يناسب مقامها وظروفها الزمانية والمكانية، بحيث لا يكرر ولا يعيد، بل يرسم لنفسه خطاً بيانياً علميا يحاول أن يأتي عليه جميعا في فترة معينة يحددها؛ بحيث إن المستمع الذي لا يكاد يفارق هذا الخطيب؛ يطمئن إلى أنه استوعب واستمع إلى جميع ما يحتاجه في أمور دينه، ولم يفته منه شيء .
🔹وقد يعيد الخطيب بعض الموضوعات التي تتأكد الحاجة إليها، ولكن بأسلوب مغاير وعرض مختلف، وتهيئة الخطيب نفسه على تنويع الموضوعات حسب ما تقتضيه المناسبات أو الظروف والأزمات؛ يقضي على الرتابة عنده والتكرار الذي ربما لا يحس به، كمن يأسره مثلا موضوع معين أو أكثر أو تخصص معين ؛ فتجده لا ينفك عن طرحه إلا قليلا، وكان سيد الخطباء صلى الله عليه وسلم يراعي مقتضى الحال في خطبه، ويذكر عنه ابن القيم- رحمه الله-: ( وكان- صلى الله عليه وسلم- يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم).
🔸ويقول أيضا: ( وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم)
🔹ومن هنا فإن على الخطيب
أن يتناول في خطبته القضايا الإيمانية والعبادية والأخلاق والسلوكيات .
3⃣ - العلمية : فالخطبة الناجحة المؤثرة؛ هي التي يعتمد فيها الخطيب على التأصيل العلمي؛ لأنه يتحدث من منبر شرعي، يحضره الناس لتلقي الطرح الشرعي المؤصل، وليس المنبر موقعاً خاصاً أو ديوانية أو وسيلة إعلامية تنسب للشخص ذاته، فعلى الخطيب أن يتقي الله فيما يطرح، فلا يخوض في القضايا بغير تأصيل وعلم وسبق تحر وبحث، وألا يكون طرحه للقضايا المهمة مبنياً على وجهة نظر شخصية عارية عن التنقيح أو التحقيق، ومهما كان للخطيب فصاحة وبلاغة وثقافة، فلا يغنيه ذلك عن التأصيل العلمي والرجوع إلى المحكمات دون المشتبهات، وإلى اليقينيات دون الظنيات، وإلى ما تثبت منه دون ما ظنه، أو اشتبه عليه، يقول أحد السلف: ( من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ).
🔸وقد أعجبني كلاماً للشيخ الطنطاوي - يرحمه الله - وهو يتحدث عن عيوب الخطبة في زمانه فيقول: ( ومن أعظم عيوب الخطبة في أيامنا؛ أن الخطيب ينسى أنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بلسان الشرع، وأن عليه أن يبين حكم الله فقط لا آراءه هو، وخطرات ذهنه، إلى أن يقول: ومن الخطباء من يأتي بأحكام غير محققة ولا مسلمة عند أهل العلم، يفتي بها على المنبر، ويأمر الناس بها، ولو اقتصر على المسائل المتفق عليها فأمر بها العامة، وترك الخلافية لمجالس العلماء لكان أحسن )
4⃣ - الاستدلالية : فالخطبة المؤثرة ؛ هي التي يزينها الخطيب بكثرة الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ليربط السامعين بمصادر التلقي الشرعية أولا، وليثبت القضية المطروحة ثانيا، ويحسن أن يكون الاستدلال بعد عرض المسألة وطرحها؛ لتتهيأ ا
✍ طريقك إلى الخطابة والإلقاء7⃣3⃣
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
كيف.تكون.خطبتك.مؤثرة.cc؟
للشيخ/ محمد بن عبد الله الخضيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💥 مضمون الخطبة هو الجانب الأهم في الخطبة، وهو الذي عليه مدار إصلاح القلوب والأعمال، والأخلاق والسلوك، تثبيتا للصواب، وتكثيراً له، وتحذيراً من الخطأ وتقليلا له، وهناك عدة معالم وأسس تنطلق منها الخطبة الهادفة وترتكز عليها:
1⃣ - تقرير الأصول والأركان
حيث يكون للخطيب عناية خاصة بتقرير مسائل الإيمان والعقيدة، ولا يأنف من ذكرها والتأكيد عليها بين الفينة والأخرى، ولا يستبد به الولع بالمستجدات أيا كانت، وتطغى عليه هذه النـزعة، فيهمل تلك الجوانب العظيمة، ولربما تركها أو تساهل فيها بعض الخطباء؛ اعتماداً على سبق معرفة المستمعين لها أو دراسته إياها .
🔸وهذا على فرض ثبوته
فإن لغة الخطيب قدسية المكان وعبودية الاستماع تختلف عن لغة التعليم والدراسة فهما، وتأثراً وتطبيقا، إضافة إلى أن في المستمعين ربما من لم يتعلم في التعليم النظامي، أو ليست هذه المسائل من ضمن فقرات المنهج، ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه القضايا الأساسية .
🔸يقول ابن القيم- رحمه الله
كما في زاد المعاد: ( كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعده لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيدا..)
🔸ويقول أيضا: ( ومن تأمل خطب النبي- صلى الله عليه وسلم- وخطب أصحابه، وجدها كفيلة ببيان الهدي والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله، وأصول الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم )[1]
2⃣ - التنويع، فالخطبة الناجحة النافعة هي التي ينوع الخطيب في موضوعاتها كل خطبة بما يناسب مقامها وظروفها الزمانية والمكانية، بحيث لا يكرر ولا يعيد، بل يرسم لنفسه خطاً بيانياً علميا يحاول أن يأتي عليه جميعا في فترة معينة يحددها؛ بحيث إن المستمع الذي لا يكاد يفارق هذا الخطيب؛ يطمئن إلى أنه استوعب واستمع إلى جميع ما يحتاجه في أمور دينه، ولم يفته منه شيء .
🔹وقد يعيد الخطيب بعض الموضوعات التي تتأكد الحاجة إليها، ولكن بأسلوب مغاير وعرض مختلف، وتهيئة الخطيب نفسه على تنويع الموضوعات حسب ما تقتضيه المناسبات أو الظروف والأزمات؛ يقضي على الرتابة عنده والتكرار الذي ربما لا يحس به، كمن يأسره مثلا موضوع معين أو أكثر أو تخصص معين ؛ فتجده لا ينفك عن طرحه إلا قليلا، وكان سيد الخطباء صلى الله عليه وسلم يراعي مقتضى الحال في خطبه، ويذكر عنه ابن القيم- رحمه الله-: ( وكان- صلى الله عليه وسلم- يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم).
🔸ويقول أيضا: ( وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم)
🔹ومن هنا فإن على الخطيب
أن يتناول في خطبته القضايا الإيمانية والعبادية والأخلاق والسلوكيات .
3⃣ - العلمية : فالخطبة الناجحة المؤثرة؛ هي التي يعتمد فيها الخطيب على التأصيل العلمي؛ لأنه يتحدث من منبر شرعي، يحضره الناس لتلقي الطرح الشرعي المؤصل، وليس المنبر موقعاً خاصاً أو ديوانية أو وسيلة إعلامية تنسب للشخص ذاته، فعلى الخطيب أن يتقي الله فيما يطرح، فلا يخوض في القضايا بغير تأصيل وعلم وسبق تحر وبحث، وألا يكون طرحه للقضايا المهمة مبنياً على وجهة نظر شخصية عارية عن التنقيح أو التحقيق، ومهما كان للخطيب فصاحة وبلاغة وثقافة، فلا يغنيه ذلك عن التأصيل العلمي والرجوع إلى المحكمات دون المشتبهات، وإلى اليقينيات دون الظنيات، وإلى ما تثبت منه دون ما ظنه، أو اشتبه عليه، يقول أحد السلف: ( من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ).
🔸وقد أعجبني كلاماً للشيخ الطنطاوي - يرحمه الله - وهو يتحدث عن عيوب الخطبة في زمانه فيقول: ( ومن أعظم عيوب الخطبة في أيامنا؛ أن الخطيب ينسى أنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بلسان الشرع، وأن عليه أن يبين حكم الله فقط لا آراءه هو، وخطرات ذهنه، إلى أن يقول: ومن الخطباء من يأتي بأحكام غير محققة ولا مسلمة عند أهل العلم، يفتي بها على المنبر، ويأمر الناس بها، ولو اقتصر على المسائل المتفق عليها فأمر بها العامة، وترك الخلافية لمجالس العلماء لكان أحسن )
4⃣ - الاستدلالية : فالخطبة المؤثرة ؛ هي التي يزينها الخطيب بكثرة الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ليربط السامعين بمصادر التلقي الشرعية أولا، وليثبت القضية المطروحة ثانيا، ويحسن أن يكون الاستدلال بعد عرض المسألة وطرحها؛ لتتهيأ ا
لنفوس لسماع ما يثبت ذلك؛ فإذا سمعته بعد ذلك؛ وعته وعقلته وأحسنت ربط القضية بدليلها .
🔺قال عمران بن حطان : خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية، ولم أدع لطاعة علة، فمررت ببعض المجالس فسمعت شيخاً يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن[2].
💥وفي قضية الاستدلال: يجب على الخطيب أن يتحرى الأحاديث التي يلقيها في خطبته، فيتقي الله أن يأتي بأحاديث موضوعة أو منكرة أو ضعيفة، أو يتبع فيها غيره ممن يتساهل من مؤلفي دواوين الخطب القديمة أو الحديثة ورسائل التخريج، وتمييز الصحيح من غيره أصبحت ميسرة جدا بحمد لله ، سواء كان عن طريق البحث الموضوعي في أبواب كتب السنة عن طريق فهارسها، والحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية، سهلت ذلك أكثر وأكثر فلا عذر في التقاعس والتقصير في التخريج أو في الحكم على الحديث.
5⃣ - الوعظية : ولابد من اشتمال الخطبة الناجحة على عنصر الوعظ، كما كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وليس الوعظ قسيما للعلم، أو مقابلا له، كما قد يتصور الكثيرون ممن يقصرون معنى الوعظ على الجانب التخويفي أو الترغيب فقط، وهذا فهم قاصر؛ إذ الوعظ في اصطلاح القرآن أعم من مجرد الترغيب والترهيب .
🔹ولهذا جاء وصف القرآن كله بأنه موعظة: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)) (يونس: 57).
🔸وفي الأحكام قال تعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً)) ( الطلاق: 2)
🔺ومن هنا يتضح أن الموعظة وعاء، ومَرْكَب وقالب لجميع الموضوعات الإيمانية أو العبادية، أو الأخلاقية أو الاجتماعية، فلا تكون الخطبة مجرد عرض بارد أو تقرير هادئ، أو أخبار مسرودة، وإنما لابد أن تساق بسياق وعظي بالندب للفعل إن كان الموضوع علميا، والتحذير منه إن كان يتعلق بمحرم ومعصية، والتحفيز على ما وراء الخبر إن كان الموضوع خبرا أو قصص قرآني، وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته، حتى كأنه منذر حرب يقول صبحكم ومساكم، وهكذا مفهوم اللغة الوعظية في الخطبة، لا يتصور أن يفضَّل عليها أي مضمون .
6⃣ - الاستباقية : لابد لكي تكون الخطبة ناجحة ومؤثرة علينا نناقش - إضافة إلى القضايا الحاضرة الراهنة وما يحتاج إليه المسلمون في كافة أمورهم ومسائلهم، أن نناقش أيضاً القضايا التي يتوقع وقوعها وحدوثها، أو الأحداث والفتن التي يخشى وقوعها، وذلك توضيحاً لأحكامها إن كانت مناسبات ومواسم، أو تحذيراً من أسبابها إن كانت مصائب وفتنا ومنكرات .
⏪ وهاهنا قاعدة شرعية تقول:
( الدفع أولى من الرفع)؛ لأن مدافعة الشيء قبل وقوعه تكون من حيث السهولة وقلة مفسدته.
🔸يقول الغزال- رحمه الله- :
( إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة فلفقت لها شبه، وثبت لها كلام مؤلف صار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذونا فيه"[3] .
⏹ وإذا تأملنا بعض خطب النبي -
صلى الله عليه وسلم- وجدناها على هذا النسق في مثل قوله: (( ويل للعرب من شر قد اقترب))[4] .
وقوله: (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))[5].
وقوله: (( والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم))[6].
وقوله: (( إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ))[7].
____________________________
[1] الزاد 1/423
[2] البيان والتبيين 1/ 77
[3] إحياء علوم الدين 1/ 22
[4] رواه البخاري رقم الحديث 3168
[5] رواه أحمد في مسنده رقم الحديث 23680
[6] رواه البخاري حديث 2988
[7] رواه ابن ماجه حديث 4036 وأحمد حديث 7899
=======================
🔺قال عمران بن حطان : خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية، ولم أدع لطاعة علة، فمررت ببعض المجالس فسمعت شيخاً يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن[2].
💥وفي قضية الاستدلال: يجب على الخطيب أن يتحرى الأحاديث التي يلقيها في خطبته، فيتقي الله أن يأتي بأحاديث موضوعة أو منكرة أو ضعيفة، أو يتبع فيها غيره ممن يتساهل من مؤلفي دواوين الخطب القديمة أو الحديثة ورسائل التخريج، وتمييز الصحيح من غيره أصبحت ميسرة جدا بحمد لله ، سواء كان عن طريق البحث الموضوعي في أبواب كتب السنة عن طريق فهارسها، والحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية، سهلت ذلك أكثر وأكثر فلا عذر في التقاعس والتقصير في التخريج أو في الحكم على الحديث.
5⃣ - الوعظية : ولابد من اشتمال الخطبة الناجحة على عنصر الوعظ، كما كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وليس الوعظ قسيما للعلم، أو مقابلا له، كما قد يتصور الكثيرون ممن يقصرون معنى الوعظ على الجانب التخويفي أو الترغيب فقط، وهذا فهم قاصر؛ إذ الوعظ في اصطلاح القرآن أعم من مجرد الترغيب والترهيب .
🔹ولهذا جاء وصف القرآن كله بأنه موعظة: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)) (يونس: 57).
🔸وفي الأحكام قال تعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً)) ( الطلاق: 2)
🔺ومن هنا يتضح أن الموعظة وعاء، ومَرْكَب وقالب لجميع الموضوعات الإيمانية أو العبادية، أو الأخلاقية أو الاجتماعية، فلا تكون الخطبة مجرد عرض بارد أو تقرير هادئ، أو أخبار مسرودة، وإنما لابد أن تساق بسياق وعظي بالندب للفعل إن كان الموضوع علميا، والتحذير منه إن كان يتعلق بمحرم ومعصية، والتحفيز على ما وراء الخبر إن كان الموضوع خبرا أو قصص قرآني، وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته، حتى كأنه منذر حرب يقول صبحكم ومساكم، وهكذا مفهوم اللغة الوعظية في الخطبة، لا يتصور أن يفضَّل عليها أي مضمون .
6⃣ - الاستباقية : لابد لكي تكون الخطبة ناجحة ومؤثرة علينا نناقش - إضافة إلى القضايا الحاضرة الراهنة وما يحتاج إليه المسلمون في كافة أمورهم ومسائلهم، أن نناقش أيضاً القضايا التي يتوقع وقوعها وحدوثها، أو الأحداث والفتن التي يخشى وقوعها، وذلك توضيحاً لأحكامها إن كانت مناسبات ومواسم، أو تحذيراً من أسبابها إن كانت مصائب وفتنا ومنكرات .
⏪ وهاهنا قاعدة شرعية تقول:
( الدفع أولى من الرفع)؛ لأن مدافعة الشيء قبل وقوعه تكون من حيث السهولة وقلة مفسدته.
🔸يقول الغزال- رحمه الله- :
( إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة فلفقت لها شبه، وثبت لها كلام مؤلف صار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذونا فيه"[3] .
⏹ وإذا تأملنا بعض خطب النبي -
صلى الله عليه وسلم- وجدناها على هذا النسق في مثل قوله: (( ويل للعرب من شر قد اقترب))[4] .
وقوله: (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))[5].
وقوله: (( والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم))[6].
وقوله: (( إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ))[7].
____________________________
[1] الزاد 1/423
[2] البيان والتبيين 1/ 77
[3] إحياء علوم الدين 1/ 22
[4] رواه البخاري رقم الحديث 3168
[5] رواه أحمد في مسنده رقم الحديث 23680
[6] رواه البخاري حديث 2988
[7] رواه ابن ماجه حديث 4036 وأحمد حديث 7899
=======================
﴿خُلِقَ الإِنسانُ مِن عَجَلٍ سَأُريكُم آياتي فَلا تَستَعجِلونِ﴾
﴿فَمَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلا كُفرانَ لِسَعيِهِ وَإِنّا لَهُ كاتِبونَ﴾
﴿يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُم إِنَّ زَلزَلَةَ السّاعَةِ شَيءٌ عَظيمٌ﴾
السلام.عليكم.ورحمة.الله.وبركاتة.cc
⛅️ إشــツـراقة.الصبـاح.cc⛅️
❁ الجمــ☼ــعــة ❁
🌹جمعة.مباااااركة.cc🌹
27/ جمـ➄ـادى الأولى/١٤٣٨هـ
24/ فــبــــ➁ــرايـــر/ 2017مـ
❂:::ــــــــــــــــ✺ـــــــــــــــــ:::❂
﴿فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته﴾
رُغم ضيق المكان إلا أنّه نال وصف الانتشار للرحمة؛ ثِقْ أن الاستجابة لأمر الله تُورث العطايا ..
وتجعل الأماكن الموحشة واحات مؤنسة.
صبــ⛅ــاح.الاستجابة.لامر.الله.cc
⛅️ إشــツـراقة.الصبـاح.cc⛅️
❁ الجمــ☼ــعــة ❁
🌹جمعة.مباااااركة.cc🌹
27/ جمـ➄ـادى الأولى/١٤٣٨هـ
24/ فــبــــ➁ــرايـــر/ 2017مـ
❂:::ــــــــــــــــ✺ـــــــــــــــــ:::❂
﴿فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته﴾
رُغم ضيق المكان إلا أنّه نال وصف الانتشار للرحمة؛ ثِقْ أن الاستجابة لأمر الله تُورث العطايا ..
وتجعل الأماكن الموحشة واحات مؤنسة.
صبــ⛅ــاح.الاستجابة.لامر.الله.cc
🎤
خطبـةجمعــةبعنـــوان.tt
سليمان عليه السلام وملكة سبأ
للشيخ/ عبدالله بن عبده نعمان العواضي
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
الخطبــــة.الاولــــى.cc
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الناس، من الشام إلى مأرب حملَ الحرصُ سفيرَ الهداية على الانطلاق قاطعًا الفيافي والقفار ليجد قومًا تاهوا عن الغاية التي خُلقوا من أجلها، فعاد مستنفراً سرايا النور المبين بعد أن جاء من سبأ بنبأ يقين، فاستجاب النور دعوةَ سفيره الأمين فأرسل بعث الدعوة مبشرين ومنذرين، وبعد المراسلة، واتضاح الحقيقة خلعت الملكة عنها أسمال الضلال والظلام، ولبست جلباب الهداية والإسلام، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
عباد الله، جاء في سنن أبي دود وفي سنن الترمذي -بسند حسن صحيح- عن فروة بن مسيك المرادي قال: إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما سبأ: أأرض هو أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام، وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا: فالأزد والأشعريون وحمير، وكندة ومذحِج وأنمار).
لقد كان من خبر هذا الرجل (سبأ) أنه كان من نسل قحطان، وكان امرأً مسلمًا، وقد أرسل الله إلى قومه أنبياء فاهتدوا فأنعم الله عليهم بنعم كثيرة، فطاب هواؤهم، وطابت أرضهم، ودر رزقهم، وحسن حالهم في حلهم وترحالهم [1].
فاستمروا على هذه النعم إلى أن كفروا وجحدوا، وأعرضوا عن الهدى، فأبدلهم الله تعالى بعد تلك النعم: جوعًا ونقمًا، وخوفًا وتفرقًا شذر مذر في الجزيرة العربية، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ [سبأ: 15 - 17].
عــــباد الله :
لقد بقي قوم سبأ على الكفر حتى صاروا يعبدون الشمس من دون الله إلى زمن ملكتهم بلقيس، وكان ذلك في عهد نبي الله سليمان عليه السلام ومُلْكِه، الذي كان مستقراً في الشام، وقد أنعم الله تعالى عليه بالنبوة والملك وتسخير الجن له، ومعرفته لغة المخلوقات كالطير.
وفي يوم من الأيام خرج سليمان عليه السلام بجنده في مسير له فتفقد الطير، وكان من بينها هدد متميز فيها، لكنه لم يجده بين الحاضرين، فتوعّده بالعذاب أو الذبح؛ لكونه غاب من غير إذنه، إلا أن يأتي بعذر يقضي بعدم استحقاقه العقوبة، قال تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ * وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [النمل: 16 - 21].
أيها المسلمون، من
خطبـةجمعــةبعنـــوان.tt
سليمان عليه السلام وملكة سبأ
للشيخ/ عبدالله بن عبده نعمان العواضي
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
الخطبــــة.الاولــــى.cc
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها الناس، من الشام إلى مأرب حملَ الحرصُ سفيرَ الهداية على الانطلاق قاطعًا الفيافي والقفار ليجد قومًا تاهوا عن الغاية التي خُلقوا من أجلها، فعاد مستنفراً سرايا النور المبين بعد أن جاء من سبأ بنبأ يقين، فاستجاب النور دعوةَ سفيره الأمين فأرسل بعث الدعوة مبشرين ومنذرين، وبعد المراسلة، واتضاح الحقيقة خلعت الملكة عنها أسمال الضلال والظلام، ولبست جلباب الهداية والإسلام، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
عباد الله، جاء في سنن أبي دود وفي سنن الترمذي -بسند حسن صحيح- عن فروة بن مسيك المرادي قال: إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما سبأ: أأرض هو أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام، وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا: فالأزد والأشعريون وحمير، وكندة ومذحِج وأنمار).
لقد كان من خبر هذا الرجل (سبأ) أنه كان من نسل قحطان، وكان امرأً مسلمًا، وقد أرسل الله إلى قومه أنبياء فاهتدوا فأنعم الله عليهم بنعم كثيرة، فطاب هواؤهم، وطابت أرضهم، ودر رزقهم، وحسن حالهم في حلهم وترحالهم [1].
فاستمروا على هذه النعم إلى أن كفروا وجحدوا، وأعرضوا عن الهدى، فأبدلهم الله تعالى بعد تلك النعم: جوعًا ونقمًا، وخوفًا وتفرقًا شذر مذر في الجزيرة العربية، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ [سبأ: 15 - 17].
عــــباد الله :
لقد بقي قوم سبأ على الكفر حتى صاروا يعبدون الشمس من دون الله إلى زمن ملكتهم بلقيس، وكان ذلك في عهد نبي الله سليمان عليه السلام ومُلْكِه، الذي كان مستقراً في الشام، وقد أنعم الله تعالى عليه بالنبوة والملك وتسخير الجن له، ومعرفته لغة المخلوقات كالطير.
وفي يوم من الأيام خرج سليمان عليه السلام بجنده في مسير له فتفقد الطير، وكان من بينها هدد متميز فيها، لكنه لم يجده بين الحاضرين، فتوعّده بالعذاب أو الذبح؛ لكونه غاب من غير إذنه، إلا أن يأتي بعذر يقضي بعدم استحقاقه العقوبة، قال تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ * وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [النمل: 16 - 21].
أيها المسلمون، من
خلال الآيات السابقة يستفاد: أن الواجب على الإنسان - إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة- أن يعترف لربه بها، ويشكره عليها، ويستعملها فيما يرضي مُعطيْها، وأن يتواضع بها بين عباد الله، وأن لا يتكبر بها عليهم، وأن على ولي الأمر أن يتفقد شؤون رعيته، ويسأل عن أحوالهم، وأن يكون حازمًا صارمًا في الحق، وأن يكون جنوده مسخرين في إصلاح أحوال الرعية: توفيراً للأمن والحاجات، وحماية من الخوف والمهلكات.
أيها الأحبة الفضلاء، لقد انطلق هدهد سليمان من أرض الشام إلى أرض مأرب من اليمن في مهمة عظيمة، وغاية جسيمة، قطع تلك المسافة البعيدة داعيًا إلى الله عز وجل، فوجد في أرض سبأ ما يغضب الله تعالى من الشرك والمشركين؛ إذ كانوا يعبدون الشمس من دون الله، وكان عليهم امرأة قد أوتيت من زينة الدنيا في ملكها من كل شيء يؤتاه ملوك عصرها، ومن ذلك كرسي عظيم تجلس عليه في مملكتها، ثم رجع الهدهد إلى سليمان بهذا الخبر الأكيد الذي رآه عيانًا، قال تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: 22- 26].
أيها الأخوة الأكارم، في هذا المقطع الجميل الذي تحدث عن هذه المهمة الدعوية التي قام بها الهدهد الذي خلّد الله تعالى ذكره بها في القرآن الكريم بسبب هذا العمل العظيم؛ نستفيد: أن على الرسول إذا كان في مهمة أن ينجزها ويعود سريعًا بلا تأخر، وأن الإنسان مهما بلغ علمه فقد يفوته شيء كثير من العلم قد يستفيده ممن هو أقل منه شأنًا وعلمًا، وأن على ناقل الأخبار أن يتثبت فيها، فلا ينقلها إلى الناس إلا بعد يقين من صحتها، وأن الباطل يكون عند أصحابه حسنًا محبوبًا؛ بسبب تزيين الشيطان له، وأن من أدلة استحقاق الله للعبودية بلا شريك: علمه الغيب، ورزقه الخلق.
أيها المسلمون، إن نبي الله سليمان عليه السلام لما رجع إليه الهدهد بهذا الخبر العظيم-وكان قد توعد الهدهد بالعقوبة، إلا أن يكون له عذر مقبول؛ اهتم للأمر، ولكنه لم يلاقه بالقبول ابتداء حتى يتأكد من صدقه، فأرسل الهدهد برسالة إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الله تعالى وتركِ الشرك- الذي تدين به مع قومها- والدخول تحت سلطانه القائم على الإسلام والحق والعدل، وأمر الهدهد أن يلقي إليهم الرسالة، وينتظر جوابهم عليها، فوصل الكتاب إلى بلقيس- وكانت امرأة عاقلة حكيمة حازمة ذكية- فجمعت مستشاريها من كبار قومها، وأخبرتهم أنه وصلتها رسالة حسنة جاءتها من سليمان، وقد افتتحت هذه الرسالة بالبسملة، ومضمونها أمران: قبول دعوة الإسلام، والدخول تحت سلطان سليمان الذي قام على النبوة، وكان من فطنة هذه الملكة العاقلة: أنها لم تستأثر بالأمر دون أشراف قومها، بل عرضت القضية عليهم؛ إذ كان من عادتها: أن لا تقدم على أمر جلل إلا بمشورتهم، فرد عليها أشراف قومها بخيار الحرب وأنهم أهلها؛ لقوتهم وشجاعتهم، لكنهم جعلوا الأمر إليها لتختار هذا الرأي أو غيره؛ لثقتهم بحصافتها وحسن تدبيرها، فكان من جودة رأي هذه المرأة الفطنة: أن فكرت في الموضوع مليًا، فنظرت في الماضي، واستشرفت المستقبل، فاختار خيار السلم ؛ حرصًا على الخير لقومها، وإبعاد الذل عنهم؛ لكونها تعلم أن الملوك الجائرين إذا دخلوا بلدة عنوة وقهراً خربوها، وصيروا أعزة أهلها أذلاء، وقتلوا وأسروا، وهذه هي عادتهم المستمرة، لكنها -رحمها الله- رأت أن ترسل هدية نفيسة فيها أشياء عجيبة من نفائس الدنيا؛ لتختبر سليمان ومن معه؛ لتتخذ بعد ذلك القرار الأخير، فإن كان ملكًا يريد الدنيا فسيقبل الهدية ويفرح بها، وإن كان نبيًا فسيردها؛ لأن الدنيا ليست غايته، وإنما غايته دخولها وقومها في الإسلام، فكان هذا الفعل من ذكائها وحكمتها، قال تعالى: ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ * قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ * قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَ
أيها الأحبة الفضلاء، لقد انطلق هدهد سليمان من أرض الشام إلى أرض مأرب من اليمن في مهمة عظيمة، وغاية جسيمة، قطع تلك المسافة البعيدة داعيًا إلى الله عز وجل، فوجد في أرض سبأ ما يغضب الله تعالى من الشرك والمشركين؛ إذ كانوا يعبدون الشمس من دون الله، وكان عليهم امرأة قد أوتيت من زينة الدنيا في ملكها من كل شيء يؤتاه ملوك عصرها، ومن ذلك كرسي عظيم تجلس عليه في مملكتها، ثم رجع الهدهد إلى سليمان بهذا الخبر الأكيد الذي رآه عيانًا، قال تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: 22- 26].
أيها الأخوة الأكارم، في هذا المقطع الجميل الذي تحدث عن هذه المهمة الدعوية التي قام بها الهدهد الذي خلّد الله تعالى ذكره بها في القرآن الكريم بسبب هذا العمل العظيم؛ نستفيد: أن على الرسول إذا كان في مهمة أن ينجزها ويعود سريعًا بلا تأخر، وأن الإنسان مهما بلغ علمه فقد يفوته شيء كثير من العلم قد يستفيده ممن هو أقل منه شأنًا وعلمًا، وأن على ناقل الأخبار أن يتثبت فيها، فلا ينقلها إلى الناس إلا بعد يقين من صحتها، وأن الباطل يكون عند أصحابه حسنًا محبوبًا؛ بسبب تزيين الشيطان له، وأن من أدلة استحقاق الله للعبودية بلا شريك: علمه الغيب، ورزقه الخلق.
أيها المسلمون، إن نبي الله سليمان عليه السلام لما رجع إليه الهدهد بهذا الخبر العظيم-وكان قد توعد الهدهد بالعقوبة، إلا أن يكون له عذر مقبول؛ اهتم للأمر، ولكنه لم يلاقه بالقبول ابتداء حتى يتأكد من صدقه، فأرسل الهدهد برسالة إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الله تعالى وتركِ الشرك- الذي تدين به مع قومها- والدخول تحت سلطانه القائم على الإسلام والحق والعدل، وأمر الهدهد أن يلقي إليهم الرسالة، وينتظر جوابهم عليها، فوصل الكتاب إلى بلقيس- وكانت امرأة عاقلة حكيمة حازمة ذكية- فجمعت مستشاريها من كبار قومها، وأخبرتهم أنه وصلتها رسالة حسنة جاءتها من سليمان، وقد افتتحت هذه الرسالة بالبسملة، ومضمونها أمران: قبول دعوة الإسلام، والدخول تحت سلطان سليمان الذي قام على النبوة، وكان من فطنة هذه الملكة العاقلة: أنها لم تستأثر بالأمر دون أشراف قومها، بل عرضت القضية عليهم؛ إذ كان من عادتها: أن لا تقدم على أمر جلل إلا بمشورتهم، فرد عليها أشراف قومها بخيار الحرب وأنهم أهلها؛ لقوتهم وشجاعتهم، لكنهم جعلوا الأمر إليها لتختار هذا الرأي أو غيره؛ لثقتهم بحصافتها وحسن تدبيرها، فكان من جودة رأي هذه المرأة الفطنة: أن فكرت في الموضوع مليًا، فنظرت في الماضي، واستشرفت المستقبل، فاختار خيار السلم ؛ حرصًا على الخير لقومها، وإبعاد الذل عنهم؛ لكونها تعلم أن الملوك الجائرين إذا دخلوا بلدة عنوة وقهراً خربوها، وصيروا أعزة أهلها أذلاء، وقتلوا وأسروا، وهذه هي عادتهم المستمرة، لكنها -رحمها الله- رأت أن ترسل هدية نفيسة فيها أشياء عجيبة من نفائس الدنيا؛ لتختبر سليمان ومن معه؛ لتتخذ بعد ذلك القرار الأخير، فإن كان ملكًا يريد الدنيا فسيقبل الهدية ويفرح بها، وإن كان نبيًا فسيردها؛ لأن الدنيا ليست غايته، وإنما غايته دخولها وقومها في الإسلام، فكان هذا الفعل من ذكائها وحكمتها، قال تعالى: ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ * قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ * قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَ
ةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: 27 - 35].
أيها الأحباب، من هذه الآيات الكريمة يفيد المسلم: أن الأخبار التي ينقلها الناس لا تقبل بالتصديق إلا بعد تبين صحتها ومعرفة صدقها، وأن من وسائل الدعوة إلى الله تعالى: الدعوة عبر المراسلة، كما فعل رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى الملوك والزعماء، وفيها بيان رجاحة عقل هذه الملكة وحسن تدبيرها إدارة مملكتها، واستحباب اتخاذ مستشارين والعمل بمشورتهم، واستفتاح الرسائل بالبسملة؛ تبركًا بذكر الله تعالى، وأنها سنة قديمة، وجاءت الشريعة المحمدية بإقرارها، وفي الآيات: أن الملك إذا لم يكن له مانع من دين حق أو خلق كريم يكون راتعًا في الفساد وظالمًا للعباد، وأن الرجال يعرفون في بالامتحان والتمحيص.
أيها المسلمون، أرسلت بلقيس هديتها النفيسة إلى سليمان عليه السلام، فلما وصل الرسول الذي يحمل الهدية سلمها إليه فاستنكر سليمان هذا الفعل!؛ لأنه لم يراسلها طلبًا للدنيا، وإنما لتسلم لله رب العالمين، فقال للرسول ومن معه: هل تهدونني هذه الهدية لأكف عن دعوتي إياكم إلى الحق كما يحص لأرباب الملك في الدنيا؟! ليس الأمر كذلك، فإن ما أعطاني الله من النبوة والملك والجنود خير مما آتاكم، وإنما يفرح بهذا المال ونحوه من زينة الدنيا أنتم وأمثالكم من أهل المفاخرة والمكاثرة، فرد الهدية إلى بلقيس مع الرسول، وتوعدهم قائلاً للرسول: ارجع إلى قومك الذين أبوا الاستجابة للحق وترك الشرك فوالله لنغزونهم بجنود لا يقدرون على ردهم وهزيمتهم، ولنخرجنهم من أرضهم صاغرين أذلاء حتى يؤمنوا بالله وحده، ثم كأن الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام أنهم سيأتون إليه مسلمين، فأراد أن يريهم ما أعطاه الله من الملك والقوة والقدرة حتى يتركوا التكبر بما عندهم من الدنيا ومنها عرش الملكة العظيم فيكون ذلك سببًا لانقيادهم للحق.
فجمع سليمان عليه السلام أشراف أهل مملكته من الإنس والجن وقال لهم: من يأتيني بعرش هذه الملكة من بلادها إلى هنا قبل أن تصل إلينا؛ ليكون ذلك أدعى لها ولمن معها لقبول الحق؟، فقال مارد شديد من الجن: آنا آتيك به؛ فإني ذو قوة تجعلني أوصله إليك قبل أن تقوم من مجلسك الذي تجلس عليه للحكم بين الناس، وإني ذو أمانة تجعلني أوصله- كما هو- من غير أن ينقص شيء من جواهره وما فيه.
وكان في الحاضرين رجل آخر عنده معرفة وعلم بكتاب الله، فقدم هو كذلك عرضًا أقرب سرعة من عرض المارد من الجن، فقال: آنا آتيك به قبل ارتداد أجفانك إلى النظر إلى شيء ما، وهذا غاية في السرعة، فوافق سليمان عليه السلام على هذا العرض، فدعا اللهَ ذلك العالم فاستجاب الله له، فإذا بالعرش بين يدي سليمان كما هو، فلما رأى نبي الله سليمان العرش بين يديه كما هو بهذه السرعة والقدرة؛ تواضع لله تعالى وشكره واعترف لله بمنَّه عليه حيث سخر له من خلقه من يخدمه هذه الخدمة العظيمة، وجعل ذلك التسخيرَ العظيم لاختباره: هل يشكر الله تعالى على هذه النعمة أو لا، ومن يتركْ الشكر فإنه لا يضر إلا نفسه؛ لأن الله غني عن شكر الشاكرين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ * قَالَ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: 36 - 40].
عبــــاد الله :
في الآيات السابقة عظات وعبر، منها: أن على صاحب الحق أن يمضي في طريقه، ولا ترده عن وجهته إغراءات الدنيا مهما عظمت؛ لأن أصحاب الباطل إذا رأوا دعوته ذات اثر خافوا على شهواتهم ان تُطمر أمام سيله الهادر فقاموا بأساليب عدة لكبح جماح دعوته، ومنها: أن الهدايا التي يراد بها شراء المواقف لصالح الباطل، والسكوتُ عن الحق وترك نصرته ينبغي أن ترد ولا تقبل، وأن على القائد المسلم أن يردع أعداء الإسلام بإظهار قوة المسلمين؛ حتى يكفوا شرهم عن المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا ت
أيها الأحباب، من هذه الآيات الكريمة يفيد المسلم: أن الأخبار التي ينقلها الناس لا تقبل بالتصديق إلا بعد تبين صحتها ومعرفة صدقها، وأن من وسائل الدعوة إلى الله تعالى: الدعوة عبر المراسلة، كما فعل رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى الملوك والزعماء، وفيها بيان رجاحة عقل هذه الملكة وحسن تدبيرها إدارة مملكتها، واستحباب اتخاذ مستشارين والعمل بمشورتهم، واستفتاح الرسائل بالبسملة؛ تبركًا بذكر الله تعالى، وأنها سنة قديمة، وجاءت الشريعة المحمدية بإقرارها، وفي الآيات: أن الملك إذا لم يكن له مانع من دين حق أو خلق كريم يكون راتعًا في الفساد وظالمًا للعباد، وأن الرجال يعرفون في بالامتحان والتمحيص.
أيها المسلمون، أرسلت بلقيس هديتها النفيسة إلى سليمان عليه السلام، فلما وصل الرسول الذي يحمل الهدية سلمها إليه فاستنكر سليمان هذا الفعل!؛ لأنه لم يراسلها طلبًا للدنيا، وإنما لتسلم لله رب العالمين، فقال للرسول ومن معه: هل تهدونني هذه الهدية لأكف عن دعوتي إياكم إلى الحق كما يحص لأرباب الملك في الدنيا؟! ليس الأمر كذلك، فإن ما أعطاني الله من النبوة والملك والجنود خير مما آتاكم، وإنما يفرح بهذا المال ونحوه من زينة الدنيا أنتم وأمثالكم من أهل المفاخرة والمكاثرة، فرد الهدية إلى بلقيس مع الرسول، وتوعدهم قائلاً للرسول: ارجع إلى قومك الذين أبوا الاستجابة للحق وترك الشرك فوالله لنغزونهم بجنود لا يقدرون على ردهم وهزيمتهم، ولنخرجنهم من أرضهم صاغرين أذلاء حتى يؤمنوا بالله وحده، ثم كأن الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام أنهم سيأتون إليه مسلمين، فأراد أن يريهم ما أعطاه الله من الملك والقوة والقدرة حتى يتركوا التكبر بما عندهم من الدنيا ومنها عرش الملكة العظيم فيكون ذلك سببًا لانقيادهم للحق.
فجمع سليمان عليه السلام أشراف أهل مملكته من الإنس والجن وقال لهم: من يأتيني بعرش هذه الملكة من بلادها إلى هنا قبل أن تصل إلينا؛ ليكون ذلك أدعى لها ولمن معها لقبول الحق؟، فقال مارد شديد من الجن: آنا آتيك به؛ فإني ذو قوة تجعلني أوصله إليك قبل أن تقوم من مجلسك الذي تجلس عليه للحكم بين الناس، وإني ذو أمانة تجعلني أوصله- كما هو- من غير أن ينقص شيء من جواهره وما فيه.
وكان في الحاضرين رجل آخر عنده معرفة وعلم بكتاب الله، فقدم هو كذلك عرضًا أقرب سرعة من عرض المارد من الجن، فقال: آنا آتيك به قبل ارتداد أجفانك إلى النظر إلى شيء ما، وهذا غاية في السرعة، فوافق سليمان عليه السلام على هذا العرض، فدعا اللهَ ذلك العالم فاستجاب الله له، فإذا بالعرش بين يدي سليمان كما هو، فلما رأى نبي الله سليمان العرش بين يديه كما هو بهذه السرعة والقدرة؛ تواضع لله تعالى وشكره واعترف لله بمنَّه عليه حيث سخر له من خلقه من يخدمه هذه الخدمة العظيمة، وجعل ذلك التسخيرَ العظيم لاختباره: هل يشكر الله تعالى على هذه النعمة أو لا، ومن يتركْ الشكر فإنه لا يضر إلا نفسه؛ لأن الله غني عن شكر الشاكرين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ * قَالَ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: 36 - 40].
عبــــاد الله :
في الآيات السابقة عظات وعبر، منها: أن على صاحب الحق أن يمضي في طريقه، ولا ترده عن وجهته إغراءات الدنيا مهما عظمت؛ لأن أصحاب الباطل إذا رأوا دعوته ذات اثر خافوا على شهواتهم ان تُطمر أمام سيله الهادر فقاموا بأساليب عدة لكبح جماح دعوته، ومنها: أن الهدايا التي يراد بها شراء المواقف لصالح الباطل، والسكوتُ عن الحق وترك نصرته ينبغي أن ترد ولا تقبل، وأن على القائد المسلم أن يردع أعداء الإسلام بإظهار قوة المسلمين؛ حتى يكفوا شرهم عن المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا ت
َعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: 60]، وفي الآيات: بيان أهمية القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والقوة العلمية في حماية الحق ونشره، وأن على ولي أمر المسلمين أن يكون له مستشارون ذوو كفاية في عقولهم وعلومهم وقواتهم، يستشيرهم في أمور حُكمه، وفي الآيات: مشروعية مكاثرة أهل الباطل ومفاخرتهم بما عند أهل الحق من أسباب القوة التي يفخر بأمثالها أهل الباطل؛ لأن ذلك سيجعلهم يذعنون لقوة الحق، فالغرب اليوم والكفار عمومًا في رأس هرم التطور العلمي والتقني والتكنولوجي والعسكري وغيرها من مجالات الحياة المتقدمة، وهم في تلك الآفاق الدنيوية العالية ينظرون إلى المسلمين نظرة دونية مزدرية؛ ولعل ذلك صد بعض الكفار عن الإسلام، فلو اعتنى المسلمون بهذه الجوانب، ونافسوا الكفار فيها لأدى ذلك إلى تخفيف كِبرهم واحتقارهم للمسلمين، وفي الآيات الكريمة: عظم ما عند بعض الجن من القوة والقدرة، وبيان أن القوة والأمانة شرطان أساسيان من شروط العامل، وفيها أهمية العلم والعلماء في صلاح الدنيا والدين، وأن دعاء الله تعالى من وسائل تحقيق المطالب ونيل الرغائب، وأن على المسلم إذا رأى عظم نعم الله عليه أن لا يتعاظم بها ويفتخر بسببها، بل عليه أن يتواضع لله ويشكره عليها، ويستعملها فيما يرضيه بين عباد الله.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبــــة.الثانيــــة.cc
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أيها المسلمون، وصلَ عرشُ بلقيس بتلك السرعة بين يدي سليمان فأراد عليه السلام أن يختبر عقل الملكة كما اختبرت عقله، فأمر جنده بتغيير هيئات العرش وشكله؛ لتعرف: أهو عرشها أم لا؟، فلما جاءت سألوها: هل عرشك هكذا؟، فمن ذكائها أنها لم تقل: هو هو، ولم تقل: ليس إياه، وإنما قالت: كأنه هو، فلما شبهوا عليها في السؤال شبهت عليهم في الجواب، والله تعالى قد أعطى سليمان عليه السلام العلم والفطنة قبلها وجعله نبيًا من أنبيائه، وهذا غاية الفضل البشري، ثم إن هذه المرأة الصالحة لو تُركت لذكائها وعقلها الفاضل لاهتدت إلى الحق، ولكن صدها عنه البيئة الفاسدة التي عاشتها بين قومها المشركين فكانت مثلهم، ومازالت بلقيس تنظر إلى عظم ملك سليمان فتزداد قناعة بالحق، والدخول في الإسلام، حتى كان آخر مظاهر عظمة ملك سليمان: أن صحن قصره كان أملس من زجاج صافٍ والماء تحته يجري، فلما طلب منها دخول القصر ظنت ذلك ماء يجري تحت قدميها فكشفت عن ساقيها حتى لا يصيب الماء ثيابها حينما تخوضه، فأُخبرت أن ذلك ليس ماء، وإنما هو زجاج! فأدركت حينئذ كمالَ ما أعطى الله نبيه سليمان، واعترفت بظلمها لنفسها في بقائها في الشرك، فأعلنت الإسلام لله رب العالمين، رحمها الله تعالى، قال تعالى: ﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ * وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ * قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: 41 - 44].
عباد الله، في هذه الخاتمة الحسنة لهذه القصة العظيمة: يتبين أثر البيئة الفاسدة على إفساد معتقدات الإنسان وعقله وعمله، وأن على الإنسان إذا تبين له الحق أن يترك المكابرة والعناد، وأن يستجيب للحق ويستسلم له؛ فإن ذلك خير له، وعلامة من علامات الخير فيه.
هذا وصلوا وسلموا على خير الورى...
[1] البداية والنهاية، لابن كثير (2/ 158)، تفسير السراج المنير، للشربيني (3/ 243)، اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (16/ 39).
============================
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبــــة.الثانيــــة.cc
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أيها المسلمون، وصلَ عرشُ بلقيس بتلك السرعة بين يدي سليمان فأراد عليه السلام أن يختبر عقل الملكة كما اختبرت عقله، فأمر جنده بتغيير هيئات العرش وشكله؛ لتعرف: أهو عرشها أم لا؟، فلما جاءت سألوها: هل عرشك هكذا؟، فمن ذكائها أنها لم تقل: هو هو، ولم تقل: ليس إياه، وإنما قالت: كأنه هو، فلما شبهوا عليها في السؤال شبهت عليهم في الجواب، والله تعالى قد أعطى سليمان عليه السلام العلم والفطنة قبلها وجعله نبيًا من أنبيائه، وهذا غاية الفضل البشري، ثم إن هذه المرأة الصالحة لو تُركت لذكائها وعقلها الفاضل لاهتدت إلى الحق، ولكن صدها عنه البيئة الفاسدة التي عاشتها بين قومها المشركين فكانت مثلهم، ومازالت بلقيس تنظر إلى عظم ملك سليمان فتزداد قناعة بالحق، والدخول في الإسلام، حتى كان آخر مظاهر عظمة ملك سليمان: أن صحن قصره كان أملس من زجاج صافٍ والماء تحته يجري، فلما طلب منها دخول القصر ظنت ذلك ماء يجري تحت قدميها فكشفت عن ساقيها حتى لا يصيب الماء ثيابها حينما تخوضه، فأُخبرت أن ذلك ليس ماء، وإنما هو زجاج! فأدركت حينئذ كمالَ ما أعطى الله نبيه سليمان، واعترفت بظلمها لنفسها في بقائها في الشرك، فأعلنت الإسلام لله رب العالمين، رحمها الله تعالى، قال تعالى: ﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ * وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ * قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: 41 - 44].
عباد الله، في هذه الخاتمة الحسنة لهذه القصة العظيمة: يتبين أثر البيئة الفاسدة على إفساد معتقدات الإنسان وعقله وعمله، وأن على الإنسان إذا تبين له الحق أن يترك المكابرة والعناد، وأن يستجيب للحق ويستسلم له؛ فإن ذلك خير له، وعلامة من علامات الخير فيه.
هذا وصلوا وسلموا على خير الورى...
[1] البداية والنهاية، لابن كثير (2/ 158)، تفسير السراج المنير، للشربيني (3/ 243)، اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (16/ 39).
============================
🎤
محـاضــرةقيمــةبعنـــوان.tt
الطاغــوت كمــا صــوره القــــرآن
للــــدكـــتـــــــور/ عــــلــــي درويــــش
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
الطاغوت: مفردة من مفردات القرآن، وللقرآن الكريم مفرداته الخاصة التي انفرَد بها، والتي ليس لبعضها وجود في اللغة العربيَّة بهذه المعاني، ومعلوم أنَّ القرآن جاء ليُبدِّد، وجاء ليُجدِّد، جاء ليُبدِّد كلَّ التصوُّرات الجاهليَّة؛ سواء ما كان منها متَّصلاً بالدِّين، أو بالعادات، أو بالتقاليد والأعراف، والإسلام جاء؛ ليُجدِّد الحياة بما يَضمن سعادة الإنسان، وهداه في الدنيا والآخرة.
والطاغوت كما صوَّره القرآن عِلَّة العِلل، فما أفسَد دنيا الناس وآخرتهم إلاَّ الطاغوت، وهو الذي جعَل الناس يعيشون عيشة ضنْكًا، ويُحشرون يوم القيامة عُميًا؛ ولذلك كان تحذير القرآن كأشد ما يكون التحذير من هذا الطاغوت، وبوجوب إزاحته من طريق الناس؛ حتى تستقيمَ أمورهم، ويَسعدوا في دنياهم وأُخراهم.
والطاغوت من الطغيان، وهو مُجاوزة الحد، ولقد تَجاوَز الطاغوت حدَّه، وتعدَّى قدْره، فزعَم أنه فوق البشر، وزعَم أنه يُعبدُ من دون الله، وأنه يَشرع للناس ما لَم يَأْذن به الله، وأراد للبشر أن يُقدِّموا كلامه على كلام الله، وفِكره على هُدى الله، ذلك الطاغوت الذي أرادَ أن يكون حجابًا وحاجزًا بين الخلْق وبين الخالق؛ لعدم إفراد الله بالتوحيد والعبوديَّة.
ولقد سمَّاه القرآن طاغوتًا، وليس طاغية، وهو لفظ ثقيلٌ يوحي للسامع بمدى تجاوُز الطاغوت كلَّ حدٍّ، وكما هو مقرَّرٌ في اللغة، فإن زيادة المبنى تدلُّ على زيادة المعنى.
زعَم الطاغوت أنه شَريك لله، وله من الصفات ما لا ينبغي أن يكون إلاَّ لله.
التحذير من الطاغوت:
تحدَّث القرآن وندَّد بهذا الطاغوت في ثمانية مواضع: البقرة (256 - 257)، النساء (51 - 60 - 76)، والمائدة (60)، والنحل (36)، والزمر (17).
والذي يتدبَّر هذه الآيات، يتعرَّف على ملامح هذا الطاغوت بوجهه الكالح، وكلامه القبيح، وفكره المُختل، وعقله المعتل، ففي سورة البقرة يقول الحقُّ - عز وجل -:
﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].
وقد ورَدت هذه الآيات بعد آية الكرسي التي هي سَنام القرآن؛ أي: تمام القرآن وقِمَّته، وهي الآية التي تَشرح عقيدة المسلم في عشر جُملٍ مُفيدة، ولا تكاد تُوازيها آية في هذا التناوُل، إلاَّ تلك التي في سورة الشورى، وهي الآية الخامسة عشرة، وليس هناك آية أخرى في القرآن كلِّه، تتكوَّن من عشر جُملٍ مُفيدة، إلاَّ هاتين الآيتين.
فآية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255].
وآية الشورى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: 15].
آية الكرسي: تتحدَّث عن العقيدة الإسلاميَّة من وجهة النظر العلميَّة، وآية الشورى تتحدَّث عن العقيدة الإسلاميَّة من وجهة النظر العمليَّة، في الأولى تعليم، والثانية تطبيق، في الأولى تربية، والثانية تنفيذ وتخطيط، وحركة لنشْر العقيدة الإسلامية على كافَّة الأصعدة وفي كلِّ الاتجاهات.
في سورة البقرة - وبعد أن بيَّن الله العقيدة السليمة، ووضَّحها لعباده - قال: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
ومعنى هذا: أنه لا بدَّ أوَّلاً من بيان العقيدة السليمة للناس؛ حتى يتبيَّن لهم الرُّشد من الغي، ثم نقول بعد ذلك: لا إكراه في الدِّين؟ ولا يَصح مُطلقًا أن نفهمَ هذه الآية مقطوعة عمَّا قبلها وما بعدها، فهذا فَهْمٌ مُشوَّه، وفهْمٌ
محـاضــرةقيمــةبعنـــوان.tt
الطاغــوت كمــا صــوره القــــرآن
للــــدكـــتـــــــور/ عــــلــــي درويــــش
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
الطاغوت: مفردة من مفردات القرآن، وللقرآن الكريم مفرداته الخاصة التي انفرَد بها، والتي ليس لبعضها وجود في اللغة العربيَّة بهذه المعاني، ومعلوم أنَّ القرآن جاء ليُبدِّد، وجاء ليُجدِّد، جاء ليُبدِّد كلَّ التصوُّرات الجاهليَّة؛ سواء ما كان منها متَّصلاً بالدِّين، أو بالعادات، أو بالتقاليد والأعراف، والإسلام جاء؛ ليُجدِّد الحياة بما يَضمن سعادة الإنسان، وهداه في الدنيا والآخرة.
والطاغوت كما صوَّره القرآن عِلَّة العِلل، فما أفسَد دنيا الناس وآخرتهم إلاَّ الطاغوت، وهو الذي جعَل الناس يعيشون عيشة ضنْكًا، ويُحشرون يوم القيامة عُميًا؛ ولذلك كان تحذير القرآن كأشد ما يكون التحذير من هذا الطاغوت، وبوجوب إزاحته من طريق الناس؛ حتى تستقيمَ أمورهم، ويَسعدوا في دنياهم وأُخراهم.
والطاغوت من الطغيان، وهو مُجاوزة الحد، ولقد تَجاوَز الطاغوت حدَّه، وتعدَّى قدْره، فزعَم أنه فوق البشر، وزعَم أنه يُعبدُ من دون الله، وأنه يَشرع للناس ما لَم يَأْذن به الله، وأراد للبشر أن يُقدِّموا كلامه على كلام الله، وفِكره على هُدى الله، ذلك الطاغوت الذي أرادَ أن يكون حجابًا وحاجزًا بين الخلْق وبين الخالق؛ لعدم إفراد الله بالتوحيد والعبوديَّة.
ولقد سمَّاه القرآن طاغوتًا، وليس طاغية، وهو لفظ ثقيلٌ يوحي للسامع بمدى تجاوُز الطاغوت كلَّ حدٍّ، وكما هو مقرَّرٌ في اللغة، فإن زيادة المبنى تدلُّ على زيادة المعنى.
زعَم الطاغوت أنه شَريك لله، وله من الصفات ما لا ينبغي أن يكون إلاَّ لله.
التحذير من الطاغوت:
تحدَّث القرآن وندَّد بهذا الطاغوت في ثمانية مواضع: البقرة (256 - 257)، النساء (51 - 60 - 76)، والمائدة (60)، والنحل (36)، والزمر (17).
والذي يتدبَّر هذه الآيات، يتعرَّف على ملامح هذا الطاغوت بوجهه الكالح، وكلامه القبيح، وفكره المُختل، وعقله المعتل، ففي سورة البقرة يقول الحقُّ - عز وجل -:
﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].
وقد ورَدت هذه الآيات بعد آية الكرسي التي هي سَنام القرآن؛ أي: تمام القرآن وقِمَّته، وهي الآية التي تَشرح عقيدة المسلم في عشر جُملٍ مُفيدة، ولا تكاد تُوازيها آية في هذا التناوُل، إلاَّ تلك التي في سورة الشورى، وهي الآية الخامسة عشرة، وليس هناك آية أخرى في القرآن كلِّه، تتكوَّن من عشر جُملٍ مُفيدة، إلاَّ هاتين الآيتين.
فآية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255].
وآية الشورى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: 15].
آية الكرسي: تتحدَّث عن العقيدة الإسلاميَّة من وجهة النظر العلميَّة، وآية الشورى تتحدَّث عن العقيدة الإسلاميَّة من وجهة النظر العمليَّة، في الأولى تعليم، والثانية تطبيق، في الأولى تربية، والثانية تنفيذ وتخطيط، وحركة لنشْر العقيدة الإسلامية على كافَّة الأصعدة وفي كلِّ الاتجاهات.
في سورة البقرة - وبعد أن بيَّن الله العقيدة السليمة، ووضَّحها لعباده - قال: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
ومعنى هذا: أنه لا بدَّ أوَّلاً من بيان العقيدة السليمة للناس؛ حتى يتبيَّن لهم الرُّشد من الغي، ثم نقول بعد ذلك: لا إكراه في الدِّين؟ ولا يَصح مُطلقًا أن نفهمَ هذه الآية مقطوعة عمَّا قبلها وما بعدها، فهذا فَهْمٌ مُشوَّه، وفهْمٌ
مَغلوط، ولا يَصِح، فكيف يكون لا إكراه في الدين، بينما نرى الأفواه مُكمَّمة، والأيدي مغلولة، والأرجُل تَرسِف في القيود، بل والكفر يقوم بعمليَّة إكراهٍ للناس على اعتناق الكفر، أو الارتداد عن الإسلام؟!
نقول: لا إكراه في الدين بشرط ألاَّ يكون هناك إكراه للخروج من الدين، لا إكراه في الدين في حالة أنَّ الكفر يعيش في حدوده، لا يُقيم العَقبات في طريق الدعاة إلى التوحيد، افتَحوا لنا الطريق أولاً؛ ليتعرَّف الناس على دين الله، ويتبيَّن لهم الرُّشد من الغي، وبعدها قولوا: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾.
ولنتدبَّر الآن قول الله: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ... ﴾.
هذه الآية هي الإسلام كله، هي الدين كله، هي رسالة محمد والنبيين جميعًا، لَم يَنزل كتابٌ، ولَم يُبعث نبيٌّ إلاَّ بها، قامت الحروب من أجْلها، ومن أجْلها خلَق الله الخلقَ، ومن أجْلها قامَت السموات، وبُسِطت الأرض، ومن أجْلها خُلِقت الجنة، وخُلِقت النار.
معناها هو معنى لا إله إلاَّ الله - نفي وإثبات - لا إله: كفر بالطاغوت، إلاَّ الله: إيمان بالله، والكفر بالطاغوت مُقدَّم على الإيمان بالله، أمَّا أن تُؤمن بالله مع إيمانك بالطاغوت، فلا إيمان لك ولا خيرَ فيك، والكفر بالطاغوت يحتاج إلى معرفةٍ عظيمة بجهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهاد النبيِّين قبلَه في مُحاربة الطاغوت.
ملامح وصفات الطاغوت:
والطاغوت حرباوي الطبيعة، يتلوَّن باختلاف الزمان والمكان، ويَظهر في كلِّ مجتمعٍ بشكل مختلف، وبلونٍ مختلفٍ، وبلغة مختلفة، وله في كلِّ عصر فلسفة وأسلوب ومنهج، فهذه هي ملامحه، فأحيانًا يكون الطاغوت حاكمًا، وأحيانًا يكون مُدَّعيًا للمعرفة بالله، أو فيلسوفًا، أو مفكرًا، أو رجلَ قوانين، ومُشرِّع للناس مناهجَ تُخالف شرْع الله، ورُبَّما أيضًا يكون الطاغوت مُدَّعيًا للمعرفة بالله، أو مخلوعًا عليه من الصفات ما لا يكون إلاَّ لله.
والطاغوت له طبيعة الناس، وله صفات الناس، يموت كما يموت الناس، ويَمرض كما يَمرض الناس، يأكل ويشرب ويتبرَّز، كما يفعل الناس، ثم يَزعم للناس أنه يَملِك حقَّ التحليل والتحريم، وأنه صاحب حقٍّ في تشريع المناهج التي تُخالف شريعة الله، بزعْم أن ذلك للمصلحة الإنسانية، والحقيقة أن ذلك لَم يكن إلاَّ لذلِّ الإنسان وتردِّيه وهلاكه.
ولهذا يقول الله: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾، ثم يقول: ﴿ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ﴾، فقد قدَّم الله - عز وجل - الكفر بالطواغيت على الإيمان بالله.
والله - عز وجل - لَم يَتركنا فريسةً لهذا الطاغوت، ولكنَّه حدَّد لنا طريق النجاة، ومدَّ لنا حبله المتين وعُروته الوثقى؛ ليتمسَّك بها الغرقى، فمَن تمسَّك بها، نجا، ومَن فرَّط فيها، هلَك؛ ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
وهو نفس المعنى في الآية 22 من سورة لقمان: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 22].
هدف الطواغيت:
ونَنتقل إلى الآية 257 من سورة البقرة: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].
هذا هو هدف الطواغيت، محاولة مستميتة؛ لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، الله يُخرجنا من الظلمات إلى النور، وهؤلاء يريدون أن يُخرجونا من النور إلى الظلمات، وتدبَّر لفظة الظلمات، تجد أنها ما ورَدت في القرآن إلاَّ في صورة الجَمْع، ولفظة النور ما ورَدت إلاَّ بصيغة المفرد، فطريق النور واحد، والطريق المستقيم واحد، أمَّا الظلمات، فإنها كثيرة ومُتراكبة؛ ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: 40].
ظلمات في العقيدة، وظلمات في الأخلاق، وظلمات في العادات، وظلمات في السياسة، وظلمات في العلاقات الاجتماعية والدوليَّة، ظلمات، ظلمات، ظلمات متراكبة؛ كما أشار المولى - عز وجل.
مَن هم أولياء الله؟
لا بدَّ من التعريف بأولياء الله، مَن هم؟ وما الفرق بينهم وبين أولياء الشيطان؟
﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا... ﴾ [البقرة: 257]، هذه الآية تُعطينا معنًى رائعًا في فَهْم معنى الولاية، ومكانة الأولياء.
يقول الحقُّ - عز وجل - في سورة يونس: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
نقول: لا إكراه في الدين بشرط ألاَّ يكون هناك إكراه للخروج من الدين، لا إكراه في الدين في حالة أنَّ الكفر يعيش في حدوده، لا يُقيم العَقبات في طريق الدعاة إلى التوحيد، افتَحوا لنا الطريق أولاً؛ ليتعرَّف الناس على دين الله، ويتبيَّن لهم الرُّشد من الغي، وبعدها قولوا: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾.
ولنتدبَّر الآن قول الله: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ... ﴾.
هذه الآية هي الإسلام كله، هي الدين كله، هي رسالة محمد والنبيين جميعًا، لَم يَنزل كتابٌ، ولَم يُبعث نبيٌّ إلاَّ بها، قامت الحروب من أجْلها، ومن أجْلها خلَق الله الخلقَ، ومن أجْلها قامَت السموات، وبُسِطت الأرض، ومن أجْلها خُلِقت الجنة، وخُلِقت النار.
معناها هو معنى لا إله إلاَّ الله - نفي وإثبات - لا إله: كفر بالطاغوت، إلاَّ الله: إيمان بالله، والكفر بالطاغوت مُقدَّم على الإيمان بالله، أمَّا أن تُؤمن بالله مع إيمانك بالطاغوت، فلا إيمان لك ولا خيرَ فيك، والكفر بالطاغوت يحتاج إلى معرفةٍ عظيمة بجهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهاد النبيِّين قبلَه في مُحاربة الطاغوت.
ملامح وصفات الطاغوت:
والطاغوت حرباوي الطبيعة، يتلوَّن باختلاف الزمان والمكان، ويَظهر في كلِّ مجتمعٍ بشكل مختلف، وبلونٍ مختلفٍ، وبلغة مختلفة، وله في كلِّ عصر فلسفة وأسلوب ومنهج، فهذه هي ملامحه، فأحيانًا يكون الطاغوت حاكمًا، وأحيانًا يكون مُدَّعيًا للمعرفة بالله، أو فيلسوفًا، أو مفكرًا، أو رجلَ قوانين، ومُشرِّع للناس مناهجَ تُخالف شرْع الله، ورُبَّما أيضًا يكون الطاغوت مُدَّعيًا للمعرفة بالله، أو مخلوعًا عليه من الصفات ما لا يكون إلاَّ لله.
والطاغوت له طبيعة الناس، وله صفات الناس، يموت كما يموت الناس، ويَمرض كما يَمرض الناس، يأكل ويشرب ويتبرَّز، كما يفعل الناس، ثم يَزعم للناس أنه يَملِك حقَّ التحليل والتحريم، وأنه صاحب حقٍّ في تشريع المناهج التي تُخالف شريعة الله، بزعْم أن ذلك للمصلحة الإنسانية، والحقيقة أن ذلك لَم يكن إلاَّ لذلِّ الإنسان وتردِّيه وهلاكه.
ولهذا يقول الله: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾، ثم يقول: ﴿ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ﴾، فقد قدَّم الله - عز وجل - الكفر بالطواغيت على الإيمان بالله.
والله - عز وجل - لَم يَتركنا فريسةً لهذا الطاغوت، ولكنَّه حدَّد لنا طريق النجاة، ومدَّ لنا حبله المتين وعُروته الوثقى؛ ليتمسَّك بها الغرقى، فمَن تمسَّك بها، نجا، ومَن فرَّط فيها، هلَك؛ ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256].
وهو نفس المعنى في الآية 22 من سورة لقمان: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 22].
هدف الطواغيت:
ونَنتقل إلى الآية 257 من سورة البقرة: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].
هذا هو هدف الطواغيت، محاولة مستميتة؛ لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، الله يُخرجنا من الظلمات إلى النور، وهؤلاء يريدون أن يُخرجونا من النور إلى الظلمات، وتدبَّر لفظة الظلمات، تجد أنها ما ورَدت في القرآن إلاَّ في صورة الجَمْع، ولفظة النور ما ورَدت إلاَّ بصيغة المفرد، فطريق النور واحد، والطريق المستقيم واحد، أمَّا الظلمات، فإنها كثيرة ومُتراكبة؛ ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: 40].
ظلمات في العقيدة، وظلمات في الأخلاق، وظلمات في العادات، وظلمات في السياسة، وظلمات في العلاقات الاجتماعية والدوليَّة، ظلمات، ظلمات، ظلمات متراكبة؛ كما أشار المولى - عز وجل.
مَن هم أولياء الله؟
لا بدَّ من التعريف بأولياء الله، مَن هم؟ وما الفرق بينهم وبين أولياء الشيطان؟
﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا... ﴾ [البقرة: 257]، هذه الآية تُعطينا معنًى رائعًا في فَهْم معنى الولاية، ومكانة الأولياء.
يقول الحقُّ - عز وجل - في سورة يونس: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس: 62 - 64].
هذه الآية تُحدِّد مَن هو الوَلي، والولي: هو المؤمن التَّقي، والإيمان لا يَعلمه إلاَّ الله، وكذلك التقوى، التقوى ها هنا، وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صدره.
والتقوى: عملٌ من أعمال القلوب، لا يطَّلِع عليها أحدٌ، ولا يَعلمها أحدٌ؛ ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: 32].
وقد مرَّت آية سورة البقرة: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا.... ﴾، لتُعلنَ أنَّ كلَّ البشر أولياء؛ إمَّا لله، أو للشيطان، ولا ثالث، فليس للولي شعار يُعرَف به أو علامة تُميِّزه، الولي: هو مَن تولاَّه الله بمحبَّته، وهذا لا يَعلمه إلاَّ الله وحده، لا أحدَ على وجْه الأرض يَستطيع أن يَحكمَ على الآخرين أو على نفسه بالولاية من عدمها؛ لأنها غيبٌ من غيب الله.
وقد يقول قائل: فما بال أسماءٍ معيَّنة نعرف أنهم أولياء لله؛ كأبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم.
فنقول له: عرَفنا ذلك من النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يَنطق عن الهوى، وقد أخبَره ربُّه بأوليائه.
بشَّرهم الله بأنهم: ﴿ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ... ﴾، عليهم هم، وليس على زُوَّارهم، ولا مُلتمسي البركة منهم، ولا على المُعتكفين، ولا على مَن يَطوف بهم، أو يَذبح لهم، أو يدعوهم من دون الله.
وبشَّرهم أيضًا بأن ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى.. ﴾، لهم هم، وليس للمفتونين بهم.
ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مرض الموت، يُحذِّر من الفتنة بالصالحين، وكان يقول وهو على فراش الموت - وقد طرَح خَميصة على وجْهه، حتى إذا اغتَمَّ بها رفَعها -: ((لعَن الله اليهود والنصارى؛ اتَّخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ...)).
كان يُحذِّر مما صنَعوا.
وقال - عليه الصلاة والسلام - لَمَّا أخبَرته أُمُّ حبيبة وأُمُّ سلَمة أنَّ في أرض الحبشة عدة كنائسَ فيها تصاويرُ، قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بَنَوْا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصور))، ثم قال: ((أولئك شِرار الخَلْق عند الله))؛ متَّفق على صحَّته.
المدح الكاذب وصناعة الطواغيت:
نقرأ في سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: 49].
وقد حكى القرآن تفاصيلَ حياة اليهود بدقَّة ليس لها نظيرٌ؛ تحذيرًا لنا من هذا الوباء القاتل، فمن صفاتهم أنهم زعماء المدح الكاذب، وتَزْكِيَة النفس بما ليس فيها، والمجاملة بغير حقٍّ، والمُداهنة وخِداع الناس.
لذلك يَنهى الإسلام عن المدح الكاذب؛ فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احْثُوا التراب في وجوه المدَّاحين))، فإذا أردتَ الثناء على أحدٍ، فقل: "الله حسيبه، ولا أُزكِّيه على الله".
وقد كَرِه النبي - صلى الله عليه وسلم - الإطراء ونَهى عن ذلك، فقال: ((لا تُطروني كما أطْرَت النصارى المسيح ابن مريم))؛ لأنَّ الإطراء - وهو المبالغة في المدح - يؤدِّي إلى التقديس، ويكون مدخلاً للكفر، مدَحوا عيسى، وبالَغوا في مدْحه؛ حتى عبَدوه.
ولقد نُهِينا أن يكون لنا في هؤلاء أسوة، فهل استجَبنا إلى هذه النصائح؟ أبدًا، فما زِلنا نَسمع من يقول: السلام عليك يا نور عرش الله، فهل كان عرش الله مُظلمًا؟! وهناك أيضًا مَن يُردِّد أنَّ محمدًا هو أوَّل خَلْق الله، مُستشهدًا بحديث مكذوبٍ ومنسوب لجابر بن عبدالله، وفيه أنَّ ساق العرش مكتوبٌ عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأنَّ آدمَ حينئذ دعا الله بمحمدٍ، فقال الله له: "يا آدمُ، أما وقد دعَوتني بمحمدٍ، فقد غفَرتُ لك"، وهذا كذبٌ وافتراء على الله ورسوله، وتضليل لهذه الأُمة.
والمدح مُفسد للدنيا، ومُفسد للدين، وكان أبو بكر إذا سَمِع مَن يَمدحه، قال: "اللهمَّ لا تُؤاخذني بما يقولون، واغفِر لي ما لا يعلمون، واجْعَلني أحسنَ مما يظنون".
ماذا يفعل المدح في حياة الناس؟
كان الشاعر في أيام الدولة الفاطميَّة يقف أمام الحاكم ويقول:
مَا شِئْتَ لاَ مَا شَاءَتِ الأَقْدَارُ
فَاحْكُمْ فَأَنْتَ الْوَاحِدُ القَهَّارُ
وجاء شاعر العصر الحديث ليقول راثيًا عبدالناصر:
قَتَلْنَاكَ يَا آخِرَ الأَنْبِيَاءِ
فإذا كان عبدالناصر آخرَ الأنبياء، فماذا يكون محمد - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان الشعراء قالوا هذا قديمًا، فالإعلام يقول هذا حديثًا بأقلامٍ قادرةٍ على التلوُّن والنفاق، هذه الأقلام لا بدَّ أن تتطهَّر، ولا بدَّ أن تَعرف أن الكلمة أمانة.
ولأن الآلة الإعلامية واقعة تحت سيطرة اليهود والصِّهْيونية العالميَّة، فنجد أن الإعلام يسير على هُداهم في تضليل الناس، وتبديل الحقائق، وإفساد الفطرة، فلقد كان كفَّار مكَّةَ أرقَّ قلوبًا من اليهود، وأقربَ إلى الهدى والحقِّ منهم، بدليل أنهم دخلوا جميعًا في دين الله، وكان كفار مكةَ قد سألوا اليهود قائلين: "يا معشر يهود، أنتم أصحاب كتابٍ، أنحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: أنتم"؛ ﴿ أَلَمْ تَرَ
هذه الآية تُحدِّد مَن هو الوَلي، والولي: هو المؤمن التَّقي، والإيمان لا يَعلمه إلاَّ الله، وكذلك التقوى، التقوى ها هنا، وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صدره.
والتقوى: عملٌ من أعمال القلوب، لا يطَّلِع عليها أحدٌ، ولا يَعلمها أحدٌ؛ ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: 32].
وقد مرَّت آية سورة البقرة: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا.... ﴾، لتُعلنَ أنَّ كلَّ البشر أولياء؛ إمَّا لله، أو للشيطان، ولا ثالث، فليس للولي شعار يُعرَف به أو علامة تُميِّزه، الولي: هو مَن تولاَّه الله بمحبَّته، وهذا لا يَعلمه إلاَّ الله وحده، لا أحدَ على وجْه الأرض يَستطيع أن يَحكمَ على الآخرين أو على نفسه بالولاية من عدمها؛ لأنها غيبٌ من غيب الله.
وقد يقول قائل: فما بال أسماءٍ معيَّنة نعرف أنهم أولياء لله؛ كأبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم.
فنقول له: عرَفنا ذلك من النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يَنطق عن الهوى، وقد أخبَره ربُّه بأوليائه.
بشَّرهم الله بأنهم: ﴿ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ... ﴾، عليهم هم، وليس على زُوَّارهم، ولا مُلتمسي البركة منهم، ولا على المُعتكفين، ولا على مَن يَطوف بهم، أو يَذبح لهم، أو يدعوهم من دون الله.
وبشَّرهم أيضًا بأن ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى.. ﴾، لهم هم، وليس للمفتونين بهم.
ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مرض الموت، يُحذِّر من الفتنة بالصالحين، وكان يقول وهو على فراش الموت - وقد طرَح خَميصة على وجْهه، حتى إذا اغتَمَّ بها رفَعها -: ((لعَن الله اليهود والنصارى؛ اتَّخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ...)).
كان يُحذِّر مما صنَعوا.
وقال - عليه الصلاة والسلام - لَمَّا أخبَرته أُمُّ حبيبة وأُمُّ سلَمة أنَّ في أرض الحبشة عدة كنائسَ فيها تصاويرُ، قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بَنَوْا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصور))، ثم قال: ((أولئك شِرار الخَلْق عند الله))؛ متَّفق على صحَّته.
المدح الكاذب وصناعة الطواغيت:
نقرأ في سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: 49].
وقد حكى القرآن تفاصيلَ حياة اليهود بدقَّة ليس لها نظيرٌ؛ تحذيرًا لنا من هذا الوباء القاتل، فمن صفاتهم أنهم زعماء المدح الكاذب، وتَزْكِيَة النفس بما ليس فيها، والمجاملة بغير حقٍّ، والمُداهنة وخِداع الناس.
لذلك يَنهى الإسلام عن المدح الكاذب؛ فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احْثُوا التراب في وجوه المدَّاحين))، فإذا أردتَ الثناء على أحدٍ، فقل: "الله حسيبه، ولا أُزكِّيه على الله".
وقد كَرِه النبي - صلى الله عليه وسلم - الإطراء ونَهى عن ذلك، فقال: ((لا تُطروني كما أطْرَت النصارى المسيح ابن مريم))؛ لأنَّ الإطراء - وهو المبالغة في المدح - يؤدِّي إلى التقديس، ويكون مدخلاً للكفر، مدَحوا عيسى، وبالَغوا في مدْحه؛ حتى عبَدوه.
ولقد نُهِينا أن يكون لنا في هؤلاء أسوة، فهل استجَبنا إلى هذه النصائح؟ أبدًا، فما زِلنا نَسمع من يقول: السلام عليك يا نور عرش الله، فهل كان عرش الله مُظلمًا؟! وهناك أيضًا مَن يُردِّد أنَّ محمدًا هو أوَّل خَلْق الله، مُستشهدًا بحديث مكذوبٍ ومنسوب لجابر بن عبدالله، وفيه أنَّ ساق العرش مكتوبٌ عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأنَّ آدمَ حينئذ دعا الله بمحمدٍ، فقال الله له: "يا آدمُ، أما وقد دعَوتني بمحمدٍ، فقد غفَرتُ لك"، وهذا كذبٌ وافتراء على الله ورسوله، وتضليل لهذه الأُمة.
والمدح مُفسد للدنيا، ومُفسد للدين، وكان أبو بكر إذا سَمِع مَن يَمدحه، قال: "اللهمَّ لا تُؤاخذني بما يقولون، واغفِر لي ما لا يعلمون، واجْعَلني أحسنَ مما يظنون".
ماذا يفعل المدح في حياة الناس؟
كان الشاعر في أيام الدولة الفاطميَّة يقف أمام الحاكم ويقول:
مَا شِئْتَ لاَ مَا شَاءَتِ الأَقْدَارُ
فَاحْكُمْ فَأَنْتَ الْوَاحِدُ القَهَّارُ
وجاء شاعر العصر الحديث ليقول راثيًا عبدالناصر:
قَتَلْنَاكَ يَا آخِرَ الأَنْبِيَاءِ
فإذا كان عبدالناصر آخرَ الأنبياء، فماذا يكون محمد - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان الشعراء قالوا هذا قديمًا، فالإعلام يقول هذا حديثًا بأقلامٍ قادرةٍ على التلوُّن والنفاق، هذه الأقلام لا بدَّ أن تتطهَّر، ولا بدَّ أن تَعرف أن الكلمة أمانة.
ولأن الآلة الإعلامية واقعة تحت سيطرة اليهود والصِّهْيونية العالميَّة، فنجد أن الإعلام يسير على هُداهم في تضليل الناس، وتبديل الحقائق، وإفساد الفطرة، فلقد كان كفَّار مكَّةَ أرقَّ قلوبًا من اليهود، وأقربَ إلى الهدى والحقِّ منهم، بدليل أنهم دخلوا جميعًا في دين الله، وكان كفار مكةَ قد سألوا اليهود قائلين: "يا معشر يهود، أنتم أصحاب كتابٍ، أنحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: أنتم"؛ ﴿ أَلَمْ تَرَ
إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ [النساء: 51].
ونَستكمل الآيات التي تتحدَّث عن الطاغوت:
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60].
هذه الآيات نزَلت؛ لتتحدَّث عن الطاغوت في مجال الحكم والتشريع، ولا يكون المسلم مسلمًا ولا المؤمن مؤمنًا، إذا أقرَّ بشرعٍ غير شرْع الله، ولَمَّا نزَلت آية التوبة ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.. ﴾ [التوبة: 31]، قال عَدي بن حاتم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كنَّا نَعبدهم، فقال له: ((ألَم يُحلُّوا لكم الحرامَ، ويُحرِّموا عليكم الحلال؟))، قال: نعم، قال: ((تلك عبادتكم إيَّاهم)).
جاء في إنجيل متَّى؛ لبطرس: "وأنت صخرتي، وعليك أبني كنيستي، ما حلَّلته في الأرض، أنا أُحله في السماء..".
أمَّا في الإسلام، فالتشريع لا يكون إلا لله، التحليل والتحريم حقٌّ لله، المنع والإباحة حقٌّ لله، ولا يكون ذلك حتى إلى رسول الله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التحريم: 1].
وكلُّ حلالٍ أو حرامٍ على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو بتشريعٍ من الله.
ثم نأتي إلى قول الله: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾، والفعل "زعَم" مطيَّة الكذب، ولا يأتي في القرآن إلاَّ بمعنى الكذب؛ ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾ [التغابن: 7].
وهؤلاء زعَموا أنهم آمنوا بالقرآن، بكلام الله، بشرْع الله، فلماذا تُفرطون في هدْي الله وشريعته؟! مَن يدَّعي الإيمان بالله، فعليه أن يَلتزم بكلام الله، ويُقِرَّ بأن القرآن شريعةٌ وعقيدة، وأخلاق وعبادات، ليس القرآن كتابُ جنائز، ولَم يَنزل القرآن؛ ليُقرأ على الموتى، وليس حجابًا، وليس شيئًا من هذا، بل هو كتاب حكيم أنزَله الله؛ ليَحكم البشرية؛ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105].
الكتاب يَحكم والرسول يَحكم، السلطة لا يَمنحها إلاَّ الله، السلطة والسلطان لله وللقرآن.
ثم انظر إلى كلمة ﴿ يُرِيدُونَ ﴾، فهم ما زالوا يُفكِّرون، وهم قوم أقلُّ منَّا شرًّا، نزَلت هذه الآية في المنافقين وهم أشدُّ الناس عذابًا؛ لأنهم في الدَّرك الأسفل من النار، ومع ذلك كانوا أقلَّ منَّا شرًّا؛ لأنهم كانوا يُريدون؛ أي: في منطقة الإرادة، أمَّا نحن، فقد تحاكَمنا إليه ورَضِينا به، جِئنا بطواغيتَ من جميع الأجناس؛ إنجليزية، وفرنسية، وهنديَّة، حتى من عُبَّاد البقر؛ ليَصنعوا لنا تشريعات ومناهجَ نَسير عليها.
هؤلاء أرادوا التحاكُم إلى الطاغوت، وقد أُمِروا أن يَكفروا به، ويريد الشيطان أن يُضلَّهم ضلالاً بعيدًا - أي: بعيدًا عن الصراط المستقيم - والضلال البعيد معناه الضلال الذي لا رجوعَ منه؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: 61].
والعجيب أن أحدًا من هؤلاء لَم يسأل نفسه: إلامَ ندعو الناس؟ هل ندعوهم إلى كلامنا أم إلى كلام الله؟ هل نريد أن يَنقاد هؤلاء لنا أم لله؟ نحن ندعو الناس - كلَّ الناس - إلى تحكيم كتاب الله، والتسليم والانقياد لله ولرسوله؛ ليكونوا عبادًا لله دون غيره.
نحن نُقيم الحُجة على هؤلاء، ونقول: أيُّ الكلام أعدلُ وأقومُ وأحكمُ؟ كلام الله ورسوله أم هذه النُّظم التي ما أنزَل الله بها من سلطان؟! مَن أعزُّ عليكم: محمد أم ماركس؟! محمد أم جان جاك روسو؟! محمد أم نهرو؟!
لماذا يَرفض هؤلاء محمدًا؟! لماذا هو محذور أن يدخل بيوتنا وبلادنا في الوقت الذي يدخل فيه كلُّ صاحب مِلَّة مزوَّرة، وفكرٍ مُنحرف؛ ليعيش بيننا بالفساد، ويَرتع هنا وهناك؟!
ماذا يقول المنافقون ردًّا على دعوتهم إلى الله ورسوله؟! وما هو منطقهم المُعْوَج؟!
إنهم يقولون: هذه الدعوات إنما هي رجعيَّة وتخلُّف، وجَرٌّ لعقارب الساعة إلى الوراء، وجمودٌ وانحطاطٌ، وألفاظ غاية في السفالة والانحطاط، وقلَّة الأدب!
والذي يردِّد هذا الكلام هم أصحاب المَنفعة، الخائفون من المَضرة؛ لأن محمدًا إذا ظهَرت كلماته في الأرض، ستَسقط قِممٌ وتتهاوى أصنامٌ، وتُقطَّع أَيَادٍ، ويُرجم زُناة؛ لأنَّ محمدًا لا يُفرِّق بين شريف وضعيف، كلُّهم أمام الشرع سواءٌ؛ فالزناة يرفضون واللصوص يرفضون، والمُرتدون يرفضون، كلُّهم مَرعوبون من الاحتكام إلى شرْع الله.
إذًا؛ فليَسكت محمد
ونَستكمل الآيات التي تتحدَّث عن الطاغوت:
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60].
هذه الآيات نزَلت؛ لتتحدَّث عن الطاغوت في مجال الحكم والتشريع، ولا يكون المسلم مسلمًا ولا المؤمن مؤمنًا، إذا أقرَّ بشرعٍ غير شرْع الله، ولَمَّا نزَلت آية التوبة ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.. ﴾ [التوبة: 31]، قال عَدي بن حاتم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كنَّا نَعبدهم، فقال له: ((ألَم يُحلُّوا لكم الحرامَ، ويُحرِّموا عليكم الحلال؟))، قال: نعم، قال: ((تلك عبادتكم إيَّاهم)).
جاء في إنجيل متَّى؛ لبطرس: "وأنت صخرتي، وعليك أبني كنيستي، ما حلَّلته في الأرض، أنا أُحله في السماء..".
أمَّا في الإسلام، فالتشريع لا يكون إلا لله، التحليل والتحريم حقٌّ لله، المنع والإباحة حقٌّ لله، ولا يكون ذلك حتى إلى رسول الله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التحريم: 1].
وكلُّ حلالٍ أو حرامٍ على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو بتشريعٍ من الله.
ثم نأتي إلى قول الله: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾، والفعل "زعَم" مطيَّة الكذب، ولا يأتي في القرآن إلاَّ بمعنى الكذب؛ ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾ [التغابن: 7].
وهؤلاء زعَموا أنهم آمنوا بالقرآن، بكلام الله، بشرْع الله، فلماذا تُفرطون في هدْي الله وشريعته؟! مَن يدَّعي الإيمان بالله، فعليه أن يَلتزم بكلام الله، ويُقِرَّ بأن القرآن شريعةٌ وعقيدة، وأخلاق وعبادات، ليس القرآن كتابُ جنائز، ولَم يَنزل القرآن؛ ليُقرأ على الموتى، وليس حجابًا، وليس شيئًا من هذا، بل هو كتاب حكيم أنزَله الله؛ ليَحكم البشرية؛ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105].
الكتاب يَحكم والرسول يَحكم، السلطة لا يَمنحها إلاَّ الله، السلطة والسلطان لله وللقرآن.
ثم انظر إلى كلمة ﴿ يُرِيدُونَ ﴾، فهم ما زالوا يُفكِّرون، وهم قوم أقلُّ منَّا شرًّا، نزَلت هذه الآية في المنافقين وهم أشدُّ الناس عذابًا؛ لأنهم في الدَّرك الأسفل من النار، ومع ذلك كانوا أقلَّ منَّا شرًّا؛ لأنهم كانوا يُريدون؛ أي: في منطقة الإرادة، أمَّا نحن، فقد تحاكَمنا إليه ورَضِينا به، جِئنا بطواغيتَ من جميع الأجناس؛ إنجليزية، وفرنسية، وهنديَّة، حتى من عُبَّاد البقر؛ ليَصنعوا لنا تشريعات ومناهجَ نَسير عليها.
هؤلاء أرادوا التحاكُم إلى الطاغوت، وقد أُمِروا أن يَكفروا به، ويريد الشيطان أن يُضلَّهم ضلالاً بعيدًا - أي: بعيدًا عن الصراط المستقيم - والضلال البعيد معناه الضلال الذي لا رجوعَ منه؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: 61].
والعجيب أن أحدًا من هؤلاء لَم يسأل نفسه: إلامَ ندعو الناس؟ هل ندعوهم إلى كلامنا أم إلى كلام الله؟ هل نريد أن يَنقاد هؤلاء لنا أم لله؟ نحن ندعو الناس - كلَّ الناس - إلى تحكيم كتاب الله، والتسليم والانقياد لله ولرسوله؛ ليكونوا عبادًا لله دون غيره.
نحن نُقيم الحُجة على هؤلاء، ونقول: أيُّ الكلام أعدلُ وأقومُ وأحكمُ؟ كلام الله ورسوله أم هذه النُّظم التي ما أنزَل الله بها من سلطان؟! مَن أعزُّ عليكم: محمد أم ماركس؟! محمد أم جان جاك روسو؟! محمد أم نهرو؟!
لماذا يَرفض هؤلاء محمدًا؟! لماذا هو محذور أن يدخل بيوتنا وبلادنا في الوقت الذي يدخل فيه كلُّ صاحب مِلَّة مزوَّرة، وفكرٍ مُنحرف؛ ليعيش بيننا بالفساد، ويَرتع هنا وهناك؟!
ماذا يقول المنافقون ردًّا على دعوتهم إلى الله ورسوله؟! وما هو منطقهم المُعْوَج؟!
إنهم يقولون: هذه الدعوات إنما هي رجعيَّة وتخلُّف، وجَرٌّ لعقارب الساعة إلى الوراء، وجمودٌ وانحطاطٌ، وألفاظ غاية في السفالة والانحطاط، وقلَّة الأدب!
والذي يردِّد هذا الكلام هم أصحاب المَنفعة، الخائفون من المَضرة؛ لأن محمدًا إذا ظهَرت كلماته في الأرض، ستَسقط قِممٌ وتتهاوى أصنامٌ، وتُقطَّع أَيَادٍ، ويُرجم زُناة؛ لأنَّ محمدًا لا يُفرِّق بين شريف وضعيف، كلُّهم أمام الشرع سواءٌ؛ فالزناة يرفضون واللصوص يرفضون، والمُرتدون يرفضون، كلُّهم مَرعوبون من الاحتكام إلى شرْع الله.
إذًا؛ فليَسكت محمد
، ولتتكلَّم الشياطين، المنافقون في عصرنا لهم صَوْلة، ولهم جولة، ولديهم أبواقٌ يُصوِّرون فيها المعروف منكرًا، فتجد نفسَك معاديًا لأصحاب المعروف، وتَراهم يُقدِّمون الخيانة في صورة جذَّابة وبرَّاقة، تَحملك على التعاطف مع أصحابها، وعقاب هؤلاء في الدنيا أنهم يتساقَطون في الفِتن وتتوالَى عليهم المصائب؛ ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ... ﴾ [التوبة: 126]، وليس لديهم مانعٌ في كلِّ مرَّة يكتشفون فيها كارثة أفكارهم وأنْظِمتهم أن يُغيِّروها إلى غيرها، ولكنَّهم أبدًا لا يُفكِّرون في العودة إلى كتاب الله.
فهم يُغيِّرون بحُجة أن هذا توفيقٌ للأوضاع ودَمْجٌ للأنظمة وللقوانين من أجْل مصلحة الناس، وبالتالي يأتي هذا التوفيق على حساب شريعة الله؛ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: 30]، وكيف إذا أصابَهم الخِزي والعار؟
والحل مع هؤلاء: الإعراض عنهم - ومن المصلحة أن نُعرض عنهم - مع وعْظهم وإقامة الحُجَّة عليهم؛ ﴿ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: 63].
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 64].
لماذا نُطيع الرسول ولماذا نحبُّه؟ هل بيننا وبينه قرابة؟ هل رأيناه؟ هل هو من بلدنا؟
الإجابة: نحبُّه؛ لأنَّ معه إذنًا من الله، وما دام معه إذن من الله، أحبَبناه، ولأنَّ أبا لهبٍ معه مَقْتٌ من الله، مَقَتناه وأبغضناه.
ما هي علاقتنا الآن برسول الله؟ إنها مجرَّد مديحٍ أجوفَ، ومحبَّة مُدَّعاة، وفديناك بأرواحنا نقولها باللسان، ونُردِّدها أشعارًا في المناسبات، ونَقتصر في احتفائنا به على أكْل الحلوى في ذكرى مولِده.
لَم نسأل عن صلاته، وكيف صلَّى؟ ولا عن زكاته، وكيف زكَّى؟ لَم نَسأل عن أخلاقه، وكيف كانت؟ ولا عن جهاده، وكيف كان؟ لنُجاهد مثله، لَم نجعل منه إمامًا لنا نحبُّه ونُطيعه، ونَحتكم إليه ونَقتدي به!
السبيل إلى التوبة وشروط الإيمان:
ما هو السبيل إلى توبة هؤلاء الذين رفَضوا حُكم الله ورسوله؟ لا شيء سوى الاستغفار والتوبة، والانقياد لله ولرسوله، غير أنَّ كِبْر هؤلاء منَعهم من ذلك؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون: 5]. ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 64].
ويُقسم الله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.. ﴾ [النساء: 65]، لا يُؤمنون إلا بثلاثة شروط:
1- ﴿ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65].
2- ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [النساء: 65]؛ أي: تكون مُستبشرًا بحُكم الله ورسوله.
3- ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]؛ أي: تسليمًا ظاهريًّا بعد التسليم الباطني.
ثم نأتي إلى آية سورة النساء: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76]:
وفيها: لماذا يُقاتل المسلم؟ ولماذا يُقاتل الكافر؟
المؤمن يُقاتل في سبيل الله، والكافر يقاتل في سبيل الطاغوت.
جاء في تفسير الطبري: الذين صدَّقوا الله ورسوله، وأيْقَنوا بموعود الله لأهل الإيمان به؛ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، يقول: في طاعة الله، ومنهاج دينه وشريعته التي شرَعها لعباده، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾، يقول: والذين جحَدوا وحدانيَّة الله، وكذَّبوا رسوله وما جاءَهم به من عند ربِّهم؛ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾؛ يعني: في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرَعه لأوليائه من أهل الكفر بالله.
ويُحذِّرنا الله من مُوالاتهم؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: 144].
لماذا نُواليهم من دون المؤمنين؟ ولماذا نَخشاهم من دون الله؟ إنه ضَعف الإيمان ومرَض القلوب؛ ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ [المائدة: 52].
شرار الخلق عَبَدَة الطاغوت:
في الآية 60 من سورة النساء يقول المولى - عز وجل -: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: 60].
هذا وصْف القرآن لليهود، وقد يقول قائل: وهل مدَحهم الت
فهم يُغيِّرون بحُجة أن هذا توفيقٌ للأوضاع ودَمْجٌ للأنظمة وللقوانين من أجْل مصلحة الناس، وبالتالي يأتي هذا التوفيق على حساب شريعة الله؛ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: 30]، وكيف إذا أصابَهم الخِزي والعار؟
والحل مع هؤلاء: الإعراض عنهم - ومن المصلحة أن نُعرض عنهم - مع وعْظهم وإقامة الحُجَّة عليهم؛ ﴿ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: 63].
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 64].
لماذا نُطيع الرسول ولماذا نحبُّه؟ هل بيننا وبينه قرابة؟ هل رأيناه؟ هل هو من بلدنا؟
الإجابة: نحبُّه؛ لأنَّ معه إذنًا من الله، وما دام معه إذن من الله، أحبَبناه، ولأنَّ أبا لهبٍ معه مَقْتٌ من الله، مَقَتناه وأبغضناه.
ما هي علاقتنا الآن برسول الله؟ إنها مجرَّد مديحٍ أجوفَ، ومحبَّة مُدَّعاة، وفديناك بأرواحنا نقولها باللسان، ونُردِّدها أشعارًا في المناسبات، ونَقتصر في احتفائنا به على أكْل الحلوى في ذكرى مولِده.
لَم نسأل عن صلاته، وكيف صلَّى؟ ولا عن زكاته، وكيف زكَّى؟ لَم نَسأل عن أخلاقه، وكيف كانت؟ ولا عن جهاده، وكيف كان؟ لنُجاهد مثله، لَم نجعل منه إمامًا لنا نحبُّه ونُطيعه، ونَحتكم إليه ونَقتدي به!
السبيل إلى التوبة وشروط الإيمان:
ما هو السبيل إلى توبة هؤلاء الذين رفَضوا حُكم الله ورسوله؟ لا شيء سوى الاستغفار والتوبة، والانقياد لله ولرسوله، غير أنَّ كِبْر هؤلاء منَعهم من ذلك؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون: 5]. ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 64].
ويُقسم الله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.. ﴾ [النساء: 65]، لا يُؤمنون إلا بثلاثة شروط:
1- ﴿ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65].
2- ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [النساء: 65]؛ أي: تكون مُستبشرًا بحُكم الله ورسوله.
3- ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]؛ أي: تسليمًا ظاهريًّا بعد التسليم الباطني.
ثم نأتي إلى آية سورة النساء: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76]:
وفيها: لماذا يُقاتل المسلم؟ ولماذا يُقاتل الكافر؟
المؤمن يُقاتل في سبيل الله، والكافر يقاتل في سبيل الطاغوت.
جاء في تفسير الطبري: الذين صدَّقوا الله ورسوله، وأيْقَنوا بموعود الله لأهل الإيمان به؛ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، يقول: في طاعة الله، ومنهاج دينه وشريعته التي شرَعها لعباده، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾، يقول: والذين جحَدوا وحدانيَّة الله، وكذَّبوا رسوله وما جاءَهم به من عند ربِّهم؛ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾؛ يعني: في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرَعه لأوليائه من أهل الكفر بالله.
ويُحذِّرنا الله من مُوالاتهم؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: 144].
لماذا نُواليهم من دون المؤمنين؟ ولماذا نَخشاهم من دون الله؟ إنه ضَعف الإيمان ومرَض القلوب؛ ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ [المائدة: 52].
شرار الخلق عَبَدَة الطاغوت:
في الآية 60 من سورة النساء يقول المولى - عز وجل -: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: 60].
هذا وصْف القرآن لليهود، وقد يقول قائل: وهل مدَحهم الت
وراة أو الإنجيل؟
أبدًا؛ فهذا وصْفُهم في إنجيل متَّى، إصحاح (2).
"يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتِلة الأنبياء وراجِمة المرسلين، إليها كم مرَّة أردتُ أن أجمعَ أولادك كما تَجمع الدجاجة فراخَها تحت جناحَيْها، ولَم تُريدوا، هو ذا بيتكم يُترَك لكم خرابًا".
ووصَفهم أيضًا بالحيَّات أولاد الأفاعي:
وفى سفر العدد: "حتى متى أغفر لهذه العصابة الشِّرِّيرة المُتذمرة علي".
وفى سفر العدد أيضًا: "في هذا القفر تَسقط جُثثكم جميعًا، المعدودون منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدًا، الذين تذمَّروا علي، وبنوكم يكونون رُعاة في القفر أربعين سنة، ويَحملون فجوركم".
فهذا هو حال عبَدة الطاغوت الذي يُحذِّرنا منه الله - عز وجل.
وننتقل إلى سورة النحل وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36].
كل الأمم وكلُّ الأنبياء حذَّرهم الله من عبادة الطاغوت - وذلك كما ذكَرنا - لشرِّه، ولسوء عاقبة أتْباعه في الدنيا والآخرة.
وأخيرًا وفي سورة الزمر 17، تكون البشرى لِمَن تبرَّأ من الطاغوت، من عبادته، ومن ولايته، ومن طاعته؛ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 17- 18].
فهؤلاء هم أولياء الله، والمُستحقون لبُشراه.
سبحان ربِّك ربِّ العزة عمَّا يَصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين .
=======================
أبدًا؛ فهذا وصْفُهم في إنجيل متَّى، إصحاح (2).
"يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتِلة الأنبياء وراجِمة المرسلين، إليها كم مرَّة أردتُ أن أجمعَ أولادك كما تَجمع الدجاجة فراخَها تحت جناحَيْها، ولَم تُريدوا، هو ذا بيتكم يُترَك لكم خرابًا".
ووصَفهم أيضًا بالحيَّات أولاد الأفاعي:
وفى سفر العدد: "حتى متى أغفر لهذه العصابة الشِّرِّيرة المُتذمرة علي".
وفى سفر العدد أيضًا: "في هذا القفر تَسقط جُثثكم جميعًا، المعدودون منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدًا، الذين تذمَّروا علي، وبنوكم يكونون رُعاة في القفر أربعين سنة، ويَحملون فجوركم".
فهذا هو حال عبَدة الطاغوت الذي يُحذِّرنا منه الله - عز وجل.
وننتقل إلى سورة النحل وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36].
كل الأمم وكلُّ الأنبياء حذَّرهم الله من عبادة الطاغوت - وذلك كما ذكَرنا - لشرِّه، ولسوء عاقبة أتْباعه في الدنيا والآخرة.
وأخيرًا وفي سورة الزمر 17، تكون البشرى لِمَن تبرَّأ من الطاغوت، من عبادته، ومن ولايته، ومن طاعته؛ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 17- 18].
فهؤلاء هم أولياء الله، والمُستحقون لبُشراه.
سبحان ربِّك ربِّ العزة عمَّا يَصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين .
=======================
🎤
خطبـــةجمعــةبعنـــوان.tt
اســـــــــم الـــلـــــــــه ( الــــــرَّزَّاقُ )
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
الخطبـــة.الأولـــى.c
الحمد لله رب العالمين ..
اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين :
(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) الأعراف 180،
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
« إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ »
إخوة الإسلام
إن معرفة أسماء الله جل جلاله الواردة في الكتاب والسنة ،وما تتضمنه من معاني جليلة ،وأسرار بديعة ،لمن أعظم الأسباب التي تعين على زيادة إيمان العبد ، وتقوية يقينه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:”ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه”.
ومن الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله العظيم: اسمه سبحانه (الرَّزَّاقُ ) ، قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (58) الذاريات
وفي قوله تعالى:{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (سبأ: 39)،
وفى قوله سبحانه: { وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (المائدة:114)،
وفي آية أخرى: { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (المؤمنون:72).
وفي السنة المطهرة جاء ذكر هذا الاسم الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره
(عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا.
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
والرزاق: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يخص بذلك مؤمنًا دون كافر، ولا وليًا دون عدو، وما من موجود في العالم العلوي أو السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه، يوصل الرزق إلى محتاجه بسبب وبغير سبب ، وبطلب وبغير طلب.
وقال الإمام البيهقي (الرزاق) هو: المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به, والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا ينغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم, ولا يفقدوها أصلا لفقدهم إياه .
وقال ابن جرير: هو المتكفل بأقواتهم ، قال تعالى : {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء:79-80]
و قال الخطابي: هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمُها من قوتها فليس يختص بذلك مؤمنًا دون كافر ولا ولياً دون عدو.
أيها المسلمون
ورزق الخالق سبحانه وتعالى للخلق ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوّل: الرزق العام، وهو الذي يشمل البرّ والفاجر، والمؤمن والكافر، والكبير والصغير، والعاقل وغير العاقل، بل يشمل جميع ما تدبّ فيه الحياة من مخلوقاته، فيرزق الحيتان في البحار، والسباع في القفار، والأجنّة في بطون الأمهات، والنمل في باطن الأرض، فما من شيءٍ إلا وله قسمه وحظّه من الرزق: قوته وغذاؤه وما به عيشه، قال الله تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } (هود:6) ، فتكفّل سبحانه بأرزاق خلائقه ،وضمنها ،تفضّلاً منه وتكرّماً.وهذا النوع من الرزق قد يكون من الحرام وقد يكون من الحلال، والمرجع في ذلك إلى الشرع؛ فإن أذن في هذا الرزق أن يتناوله العبد أو يتحصّله فهو المباح، وإن كان غير مأذون للعبد فيه فهو الحرام الذي يأثم صاحبه به، وهو في كلا الحالين رزقٌ، وعمومه جاء من ناحيتين: عمومه كمّاً ليشمل الخلائق على اختلاف أنواعها، وعمومه كيفاً ليشمل ما أحلّه الله وما حرّمه.
القسم الثاني: الرزق الخاص، ويعنون به الرزق النافع للعباد، والذي يستمرّ نفعه في الدنيا والآخرة، ويشمل رزق القلوب وعطاءها بالعلم النافع، والهداية والرشاد، والتوفيق إلى سلوك الخير، والتحلّي بجميل الأخلاق، والتنزّه عن ردي
خطبـــةجمعــةبعنـــوان.tt
اســـــــــم الـــلـــــــــه ( الــــــرَّزَّاقُ )
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
الخطبـــة.الأولـــى.c
الحمد لله رب العالمين ..
اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد أيها المسلمون
يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين :
(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) الأعراف 180،
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
« إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ »
إخوة الإسلام
إن معرفة أسماء الله جل جلاله الواردة في الكتاب والسنة ،وما تتضمنه من معاني جليلة ،وأسرار بديعة ،لمن أعظم الأسباب التي تعين على زيادة إيمان العبد ، وتقوية يقينه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:”ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه”.
ومن الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله العظيم: اسمه سبحانه (الرَّزَّاقُ ) ، قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (58) الذاريات
وفي قوله تعالى:{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (سبأ: 39)،
وفى قوله سبحانه: { وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (المائدة:114)،
وفي آية أخرى: { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (المؤمنون:72).
وفي السنة المطهرة جاء ذكر هذا الاسم الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره
(عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا.
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
والرزاق: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يخص بذلك مؤمنًا دون كافر، ولا وليًا دون عدو، وما من موجود في العالم العلوي أو السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه، يوصل الرزق إلى محتاجه بسبب وبغير سبب ، وبطلب وبغير طلب.
وقال الإمام البيهقي (الرزاق) هو: المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به, والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا ينغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم, ولا يفقدوها أصلا لفقدهم إياه .
وقال ابن جرير: هو المتكفل بأقواتهم ، قال تعالى : {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء:79-80]
و قال الخطابي: هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمُها من قوتها فليس يختص بذلك مؤمنًا دون كافر ولا ولياً دون عدو.
أيها المسلمون
ورزق الخالق سبحانه وتعالى للخلق ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوّل: الرزق العام، وهو الذي يشمل البرّ والفاجر، والمؤمن والكافر، والكبير والصغير، والعاقل وغير العاقل، بل يشمل جميع ما تدبّ فيه الحياة من مخلوقاته، فيرزق الحيتان في البحار، والسباع في القفار، والأجنّة في بطون الأمهات، والنمل في باطن الأرض، فما من شيءٍ إلا وله قسمه وحظّه من الرزق: قوته وغذاؤه وما به عيشه، قال الله تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } (هود:6) ، فتكفّل سبحانه بأرزاق خلائقه ،وضمنها ،تفضّلاً منه وتكرّماً.وهذا النوع من الرزق قد يكون من الحرام وقد يكون من الحلال، والمرجع في ذلك إلى الشرع؛ فإن أذن في هذا الرزق أن يتناوله العبد أو يتحصّله فهو المباح، وإن كان غير مأذون للعبد فيه فهو الحرام الذي يأثم صاحبه به، وهو في كلا الحالين رزقٌ، وعمومه جاء من ناحيتين: عمومه كمّاً ليشمل الخلائق على اختلاف أنواعها، وعمومه كيفاً ليشمل ما أحلّه الله وما حرّمه.
القسم الثاني: الرزق الخاص، ويعنون به الرزق النافع للعباد، والذي يستمرّ نفعه في الدنيا والآخرة، ويشمل رزق القلوب وعطاءها بالعلم النافع، والهداية والرشاد، والتوفيق إلى سلوك الخير، والتحلّي بجميل الأخلاق، والتنزّه عن ردي
ئها، وهذا هو الرزق الحقيقي الذي يفيد العبد في معاشه ومعاده، ففي مسند أحمد وصححه الألباني (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِى الدِّينَ إِلاَّ لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ …)
ويقول الله تعالى: { وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا } (الطلاق:11)،
كما يشمل هذا القسم رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه يوم القيامة، بأن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وهذا الرزق مما اختصّ الله به المؤمنين قال تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (الأعراف:32).
ويلخّص الإمام ابن القيم هذين النوعين بقوله في النونية:
وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان
رزق القلوب العلم والايمان والـرزق المعد لهذه الأبدان
وإدراك الفرق بين هذين القسمين والتفريق بين الرزق الخاص والعام يجيب على مسألة مشهورة، وهي مسألة: هل يُسمّى الحرام رزقاً أم لا؟، فإن قُصد به الرزق على الإطلاق العام فهو يدخل فيه، وإن قُصد به الإطلاق الخاص فلا يدخل.
أيها المسلمون
ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق في حياة المؤمن وعقيدته وسلوكه :
اليقين بأن مقاليد الرزق بيد الله تعالى وحده، وإدراك ارتباطها بمشيئته سبحانه، فيُعطي هذا ويمنع ذاك، ويُغني هذا ويُفقر ذاك، لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو، وهذه اللطيفة الإيمانية نستقيها من قوله تعالى:{ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } (البقرة:212)، فقيّد سبحانه الرزق بالمشيئة؛ لأن من العباد من يكون الغنى خيراً له، ومنهم من لا ينفعه الغنى لأنه يُفسده ويُطغيه فيكون الأنسب له أن يُقْدر عليه رزقه، وفي كلا الحالين نؤمن بأن الله تعالى قد اختار الأكمل لعباده والأنفع لهم.
والمؤمن الذي عرف معنى (الرزاق)، وآمن بهذا الاسم من الأسماء الحسنى، وأن الله هو (الرازق)، وأن الرزق مكتوب قبل خلق السموات والأرض، وأن (الرزاق) يوصل الرزق بحكمته -سبحانه- لجميع خلقه، وأنه لا يملك الرزق إلا الله، كما قال تعالى: { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ } (يونس: 31)،
وكما قال تعالى: {أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (النمل: 64)،
فإذا آمن المسلم بذلك ، وأنه سينال رزقه مهما كان، ولن ينال إلا رزقه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية، والتي تبين أن الرزق لا يقتصر على المال فحسب، وإنما القناعة والصبر والحلم والعافية وغيرها، كلها تدخل في باب الرزق.
ففي صحيح مسلم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ ».
وفي البخاري (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا » ،
وفي سنن البزار (عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ : هَلُمُّوا إِلَيَّ ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ فَجَلَسُوا ، فَقَالَ : هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جِبْرِيلُ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لاَ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ، وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ )
وفي سنن البيهقي (عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ : « مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَ
ويقول الله تعالى: { وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا } (الطلاق:11)،
كما يشمل هذا القسم رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه يوم القيامة، بأن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وهذا الرزق مما اختصّ الله به المؤمنين قال تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (الأعراف:32).
ويلخّص الإمام ابن القيم هذين النوعين بقوله في النونية:
وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان
رزق القلوب العلم والايمان والـرزق المعد لهذه الأبدان
وإدراك الفرق بين هذين القسمين والتفريق بين الرزق الخاص والعام يجيب على مسألة مشهورة، وهي مسألة: هل يُسمّى الحرام رزقاً أم لا؟، فإن قُصد به الرزق على الإطلاق العام فهو يدخل فيه، وإن قُصد به الإطلاق الخاص فلا يدخل.
أيها المسلمون
ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق في حياة المؤمن وعقيدته وسلوكه :
اليقين بأن مقاليد الرزق بيد الله تعالى وحده، وإدراك ارتباطها بمشيئته سبحانه، فيُعطي هذا ويمنع ذاك، ويُغني هذا ويُفقر ذاك، لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو، وهذه اللطيفة الإيمانية نستقيها من قوله تعالى:{ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } (البقرة:212)، فقيّد سبحانه الرزق بالمشيئة؛ لأن من العباد من يكون الغنى خيراً له، ومنهم من لا ينفعه الغنى لأنه يُفسده ويُطغيه فيكون الأنسب له أن يُقْدر عليه رزقه، وفي كلا الحالين نؤمن بأن الله تعالى قد اختار الأكمل لعباده والأنفع لهم.
والمؤمن الذي عرف معنى (الرزاق)، وآمن بهذا الاسم من الأسماء الحسنى، وأن الله هو (الرازق)، وأن الرزق مكتوب قبل خلق السموات والأرض، وأن (الرزاق) يوصل الرزق بحكمته -سبحانه- لجميع خلقه، وأنه لا يملك الرزق إلا الله، كما قال تعالى: { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ } (يونس: 31)،
وكما قال تعالى: {أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (النمل: 64)،
فإذا آمن المسلم بذلك ، وأنه سينال رزقه مهما كان، ولن ينال إلا رزقه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية، والتي تبين أن الرزق لا يقتصر على المال فحسب، وإنما القناعة والصبر والحلم والعافية وغيرها، كلها تدخل في باب الرزق.
ففي صحيح مسلم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ ».
وفي البخاري (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا » ،
وفي سنن البزار (عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ : هَلُمُّوا إِلَيَّ ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ فَجَلَسُوا ، فَقَالَ : هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جِبْرِيلُ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لاَ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ، وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ )
وفي سنن البيهقي (عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ : « مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَ
عْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَلاَ أَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ».
وفي مسند أحمد وغيره (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ »
وفي مسند أحمد وصححه الألباني(عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ ».
ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق : أن الإيمان باسم الله (الرزاق) يثمر صدق التوكّل على الله عز وجل، وذلك من خلال الإدراك أن العبد مكتوبٌ له رزقه منذ اللحظة التي تُنفخ فيه الروح وهو في بطن أمّه كما صحّ بذلك الحديث: (ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ) رواه البخاري، وذلك أدعى أن يُعلق المرء قلبه بالله وحده وألا يلتفت إلى أيدي المخلوقين، قال تعالى: { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ } (العنكبوت:17)، فأمر بالتماس الرزق من عند الله وحده.
فالعبد المؤمن بأن الله هو الرزاق يزداد ثقةً ويقينًا في ربه فلا يتوكل إلا عليه.
فمشكلتنا أننا في مجتمع مادي تحكمه فلسفة مادية الكل متعلق فيه بالأسباب والنتائج، وتناسينا دور المعاني الإيمانية وتقوى الله في زيادة الرزق وفي التوفيق للمعالي. وتناسينا أن الأسباب ما هي إلا وسائل وأن أرزاقنا في السماء قد قدرت من قبل إقدامنا على هذا السبب أو غيره وتناسينا أن هذه الأسباب نفسها ما هي إلا رزق يساق إلينا ليسوق غيره وركنّا إليها وتعلقت بها قلوبنا.
فأنفق أخي ولا تخش من ذي العرش إقلالاً ، واترك أهل الحرص وحرصهم ، ألا ترى الطير لا تملك خزائن لقُوتها ولكن تغدو خماصًا وتعود بطانًا ، ففي سنن الترمذي ومسند أحمد وغيره (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ،قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا »
وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء أحدهما يدعو لكل منفق والأخر يدعو على كل ممسك
ففي الصحيحين (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا »…. ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق : توحيد الله باسمه الرزاق. فصفة الرزق من صفات الربوبية التي لا يتصف بها سوى الرب
الخالق وهذا معناه أن تعلقك بالأسباب يوقعك في شرك وقدح في توحيدك..
يقول الله تعالى {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ..} الروم 40،
فكما أن الله هو الخالق المحي المميت فكذلك هو وحده الرزاق، فلا أحد يستطيع أن ينسب الخلق إلا لله، وكذلك الإحياء والإماتة، فكذلك عليك ألا تنسب الرزق لغيره..
فإن تتودد إلى مديرك وتتقرب إليه لأنه هو الذي يرزقك لا شك أن في هذا مخالفة، ومن تتنازل عن دينها مقابل بقائها في عمل تحتاج رزقها منه لا شك أن في هذا مخالفة.. وهي ليست بالمخالفة الصغيرة بل الأمر متعلق بالتوحيد. .فلا شك أنه يحتاج منّا لوقفات واستدراك.
ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق العلم بأن من أسباب دوام النعم واستجلاب الأرزاق شكر الله تعالى على نعمه، وحق على الله أن يعطي مَن سأله، ويزيد مَن شكره، والله منعم يحب الشاكرين، وقد وعد الشاكرين بالزيادة: { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ } (إبراهيم :7).
وشكر الخالق سبحانه يكون بالقول وبالفعل، أما القول فقد علّمنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِى فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ ».رواه أبو داود، وأما الشكر بالعمل فيكون بالحرص على الإنفاق وبذل المعروف للناس، وهذا الإنفاق ليس منقصةً للرزق بل هو من أسباب تحصيله، قال تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (سبأ:39)،
ومن أعظم صور الشكر : أن يستعمل النعمة
وفي مسند أحمد وغيره (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ »
وفي مسند أحمد وصححه الألباني(عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ ».
ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق : أن الإيمان باسم الله (الرزاق) يثمر صدق التوكّل على الله عز وجل، وذلك من خلال الإدراك أن العبد مكتوبٌ له رزقه منذ اللحظة التي تُنفخ فيه الروح وهو في بطن أمّه كما صحّ بذلك الحديث: (ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ) رواه البخاري، وذلك أدعى أن يُعلق المرء قلبه بالله وحده وألا يلتفت إلى أيدي المخلوقين، قال تعالى: { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ } (العنكبوت:17)، فأمر بالتماس الرزق من عند الله وحده.
فالعبد المؤمن بأن الله هو الرزاق يزداد ثقةً ويقينًا في ربه فلا يتوكل إلا عليه.
فمشكلتنا أننا في مجتمع مادي تحكمه فلسفة مادية الكل متعلق فيه بالأسباب والنتائج، وتناسينا دور المعاني الإيمانية وتقوى الله في زيادة الرزق وفي التوفيق للمعالي. وتناسينا أن الأسباب ما هي إلا وسائل وأن أرزاقنا في السماء قد قدرت من قبل إقدامنا على هذا السبب أو غيره وتناسينا أن هذه الأسباب نفسها ما هي إلا رزق يساق إلينا ليسوق غيره وركنّا إليها وتعلقت بها قلوبنا.
فأنفق أخي ولا تخش من ذي العرش إقلالاً ، واترك أهل الحرص وحرصهم ، ألا ترى الطير لا تملك خزائن لقُوتها ولكن تغدو خماصًا وتعود بطانًا ، ففي سنن الترمذي ومسند أحمد وغيره (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ،قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا »
وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء أحدهما يدعو لكل منفق والأخر يدعو على كل ممسك
ففي الصحيحين (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا »…. ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق : توحيد الله باسمه الرزاق. فصفة الرزق من صفات الربوبية التي لا يتصف بها سوى الرب
الخالق وهذا معناه أن تعلقك بالأسباب يوقعك في شرك وقدح في توحيدك..
يقول الله تعالى {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ..} الروم 40،
فكما أن الله هو الخالق المحي المميت فكذلك هو وحده الرزاق، فلا أحد يستطيع أن ينسب الخلق إلا لله، وكذلك الإحياء والإماتة، فكذلك عليك ألا تنسب الرزق لغيره..
فإن تتودد إلى مديرك وتتقرب إليه لأنه هو الذي يرزقك لا شك أن في هذا مخالفة، ومن تتنازل عن دينها مقابل بقائها في عمل تحتاج رزقها منه لا شك أن في هذا مخالفة.. وهي ليست بالمخالفة الصغيرة بل الأمر متعلق بالتوحيد. .فلا شك أنه يحتاج منّا لوقفات واستدراك.
ومن آثار الإيمان باسم الله الرزاق العلم بأن من أسباب دوام النعم واستجلاب الأرزاق شكر الله تعالى على نعمه، وحق على الله أن يعطي مَن سأله، ويزيد مَن شكره، والله منعم يحب الشاكرين، وقد وعد الشاكرين بالزيادة: { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ } (إبراهيم :7).
وشكر الخالق سبحانه يكون بالقول وبالفعل، أما القول فقد علّمنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِى فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ ».رواه أبو داود، وأما الشكر بالعمل فيكون بالحرص على الإنفاق وبذل المعروف للناس، وهذا الإنفاق ليس منقصةً للرزق بل هو من أسباب تحصيله، قال تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (سبأ:39)،
ومن أعظم صور الشكر : أن يستعمل النعمة